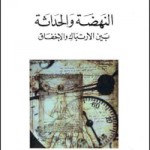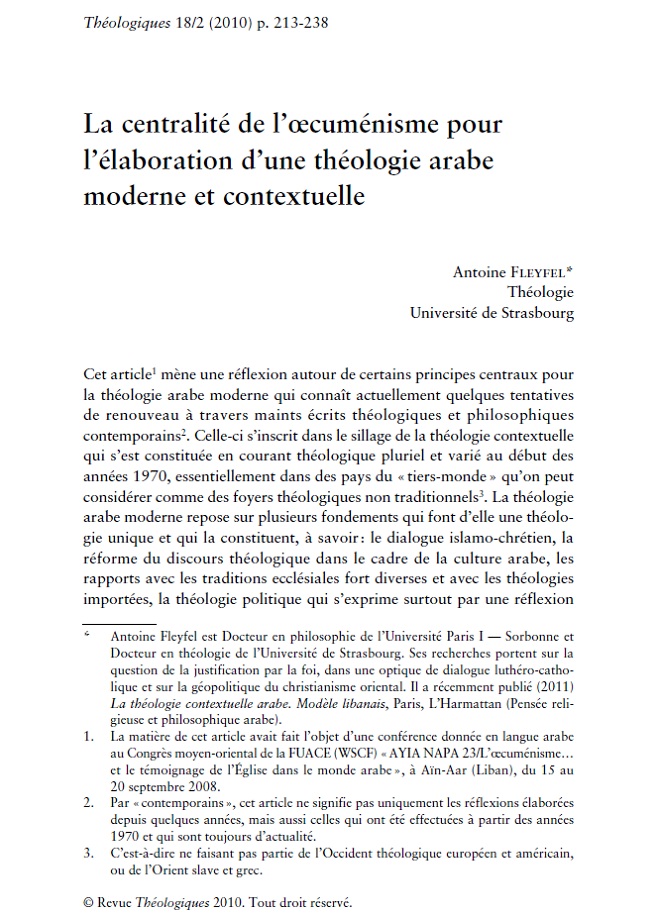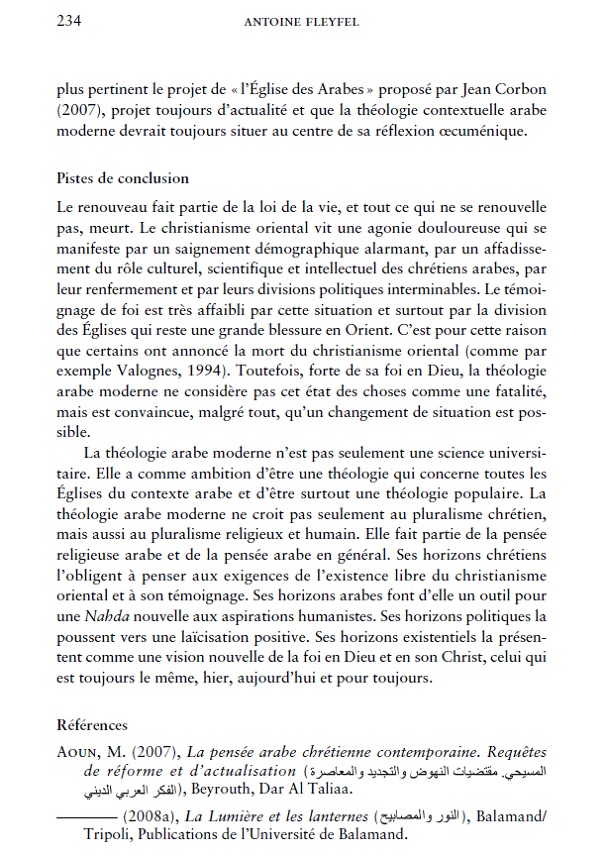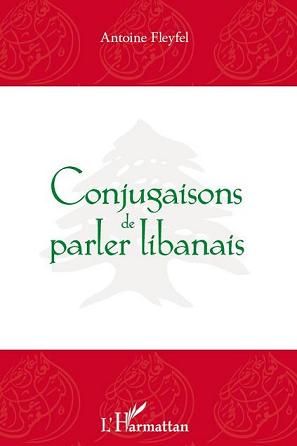|
|
Georges Corm (b. 1940) is a Lebanese economist and financial expert who specializes in the Middle East and Mediterranean countries. He studied constitutional law and economics at the University of Paris and graduated from the Political Science Institute in Paris (Sciences Po).
Corm served as finance minister in the 1998-2000 Salim Hoss cabinet. He is a professor at St. Joseph University in Beirut and taught previously at the Lebanese University and the American University of Beirut.
His publications include many studies and a number of books and articles in Arabic, English, and French including East-West: An Imaginary Divide, Contemporary Lebanon: History and Society, The Question of Religion in the 21st Century for which he won the Phénix Award andHistory of the Middle East From Antiquity to the Present Day.
-Antoine Fleyfel (AF): Geopolitics is present in most of your work, can you define it for us?
-Georges Corm (GC): Geopolitics is a compound word meaning: an approach to situations that are often conflictual in nature having to do with the geographical location of a nation-state and with the essence of its body politic. It combines, therefore, a geographical approach with a political approach.
-AF: What can this approach add to an understanding of the Arab world and its problems?
-GC: I see developments in the Arab world as connected to the geographical conditions of the Arab region, in addition to Iran and Turkey – if we adopt the idea of a “Middle East.”
The region has three features that elicit foreign intervention. One, it is the birthplace of the three monotheistic religions that have spread globally. Two, it has a strategic location. And three, it has a lot of oil which is coveted by the big and rich colonial powers.
There is another problem. Unlike the Turks and the Ottomans, the Arabs, after the decline of the Abbasid Dynasty (750-1258), no longer played a role in the political history of the world. The Persians and the Turks became masters of the region.
When the Ottoman Empire collapsed, Arab societies felt orphaned after they had been used to living in the shadow of the Muslim caliphate. These societies lacked any experience in self-rule.
In addition, Arabs were divided between British and French colonial rule and the Zionist entity was planted in the heart of the Arab world dividing the Arab east from the Arab west.
The Arabs became dispersed and fragmented after the end of the Nasserist era which had united Arabs at one point. Each Arab country allied itself with an external power instead of forming an alliance among Arab regimes.
As such, the Arab region witnessed a power vacuum which attracted at the time the Soviet Union and the United States. After the collapse of the USSR, Iran emerged as a significant regional power hostile to the US, while divisions among Arab regimes persisted.
Now we are witnessing the rise of Turkish power. It is not clear whether this rise is part of an agreement with the US whereby Turkey acts as as a proxy for US interests, or whether it is a self-propelled movement of Turkish society.
-AF: Is there a link between philosophy or philosophical methodology and geopolitics?
-GC: The link is direct and fundamental but unfortunately, most specialists in International Politics and International Relations seldom give adequate attention to the role that the philosophical understanding of the world plays in shaping policies of world powers.
Often, colonialism and settlements hide behind noble goals that are philosophical in nature. When Europeans invaded the world, it was in the name of people’s religious enlightenment, so they would be exposed to Christianity.
In the 19th century, conquest was carried out in the name of civilization, to help people whose civilizations were not advanced. Marxist thought also contributed to supporting this kind of philosophical rationale. Karl Marx believed that “backward” countries needed to open up to modern capitalism in order to hasten the process of transformation from a bourgeois capitalist system to a proletariat socialist system.
We have two philosophical sources, Hegel and Marx, and together they rationalized colonial campaigns. Lately, we’ve had the neoconservatives in the US like Ronald Reagan and George W. Bush who invaded Iraq in the name of democracy.
Philosophical rationales deployed by countries that wage wars of conquest need to be deconstructed because such endeavors always require some kind of philosophical or religious justification.
-AF: What are the major components of your thought?
-GC: I wanted to address two complementary issues. First, my studies in Paris made me keenly aware of the European claim that, unlike other people, they possess wisdom, philosophy, and humanism. I was shocked by this kind of narcissism among European nations. That long road led me to write my book Europe and the Myth of the West: The Construction of a History.
Second, as I dove deeper into contemporary Arab culture, it became clear to me the extent to which it is dependent on Western thought. Also, we, as Arabs, lack knowledge of Chinese thought or Indian thought or the philosophies of non-Western civilizations.
We are sort of locked in a face-to-face encounter with the West – Europe and the US – that puts us in a kind of prison, an intellectual Guantanamo of sorts. Because the idea of philosophical independence, advocated by our friend Nassif Nassar, for example, has no momentum in the Arab world.
Even Islamist movements which are supposed to represent the most hard-line positions are in the end a product of a pathological relationship with Western philosophy and a Western world-view.
What do we see among the Arab intellectual elite? Either complete prostration before the Western cognitive view of the world or a kind of hysterical rejection of it. There is indeed a state of subordination to the Western system of thought in the Arab world.
I have been calling for an end to this state of dependence and subordination in order to establish an Arab cognitive system of knowledge that takes into consideration our history and builds an epistemological system on it.
For example, the most important question that no one has explored is, why did the rule of the Arabs or Arab power end? As long as we do not have an answer to this question, we cannot build a better future. How did Arab conquests that built Muslim civilization end up with the Arabs locked out of history?
Since the destabilization of the Ottoman Empire in the last century, Arabs have faced an identity crisis between adherence to a religious legacy and entering secular history.
The battle still rages at the heart of the Arab revolutions which we are witnessing today. They can be summed up as a competition between the concept of a civil secular state and a state governed by religious authority.
-AF: Since we brought up this issue, how do you read the problem of secularism and sectarianism in Lebanon?
-GC: I believe that Lebanon played a pioneering role in the 19th century especially after the sectarian massacres that awakened the Lebanese mind. But the Mutasarrifiyya system which governed Mount Lebanon after the sectarian massacres established political sectarianism for the first time in Lebanon’s history.
Then the French mandate established sects as intermediary entities between citizens and the state in public law. After that, the national reconciliation document in the Taif Agreement tried to refine sectarianism by reformulating it in a more balanced way among the sects.
We are still prisoners of a sectarian culture and it is a devastating culture because it makes the Arab individual look at the world through a religious, sectarian prism instead of a secular one.
When the Lebanese Civil War began in 1975, the Palestinian cause was the central issue. The war therefore should not have turned into a Muslim-Christian conflict. If it were presented in the right way, it would not have fed sectarian sensibilities, because what was being contested was the armed Palestinian presence in Lebanon.
It is sad to say that the side which had declared war on the armed Palestinian groups back then is ready today for a permanent settlement of Palestinian refugees in Lebanon. They are also ready for the entire Western-Saudi or “moderate Arab” approach to the Palestinian cause.
I have always argued that we often lose what we gain through resistance, when this resistance takes on a religious character.
The Palestinian cause is not about religion, it is about occupation and colonization. If Buddhists happened to colonize Palestine, they would have faced fierce resistance. Even if Turkish or Iranian Muslims occupied Palestine, I think the Palestinians would have risen up.
Reducing the Palestinian cause to a religious struggle undermines the achievements made through resistance.
-AF: What are the prospects of the Arab Spring in your opinion?
-GC: There is no doubt that major historical events took place that are self-generated. The Arab people did not revolt because of a foreign conspiracy as some would like to argue.
Nevertheless, Western superpowers were quickly struck by a new colonial fever. They were aided by the conservative forces hostile to political modernity and human freedom, which we used to call the Arab reactionary forces in the past.
The Turks also entered the scene presenting an Islamist model as a guide to the Arab revolutions. This of course will alienate these revolutions and we have seen painful results in Libya, Syria, and Yemen. It remains to be seen how far the revolutions in Egypt and Tunisia will go.
In any case, revolutions come in circles and a revolutionary circle opened up in the Arab world. But it is hard to predict where it will end up.
I always say the French Revolution broke out in 1789 and bore its final fruit a century later, when the third republic was established, monarchical rule ended, and republican principles were secured.
The revolutionary cycle takes a long time and it is not a magical wand that changes everything all at once. I think we are at the beginning of the road.
Falling into religious and sectarian discussions is bad publicity for the revolutions. Viewing what happened in Bahrain, Syria, and Yemen from a sectarian prism is wrong.
Analyzing in the absence of an independent and philosophical thought system is a pathology. We analyze according to the tools and style of Western propaganda, the Western academy, and Western media, and we do so from a sectarian point of view.
A few months before invading Iraq, the US started to spread the view that the issue in Iraq is that a Sunni minority persecuted a Shia majority. The similarly simplistic way in which the situation in Syria is being depicted today is highly regrettable and will lead to doom and disaster.
We should abandon analysis based strictly on viewing Arab people as religious and sectarian beings. Let’s examine the real factors on the ground, such as issues of corruption, social justice, and the rentier economy that perpetuates tyrannical regimes.
The path of democracy indicates that democracy relies on destroying the rentier economy. And unfortunately, most Arab economies are rentier economies.
Antoine Fleyfel
Al-Akhbar, 24.01.2012
Lire l’article en anglais
جورج قرم: الربيع العربي ليس مؤامرة

■ الجيوسياسة حاضرة في أغلبية دراساتك، هل يمكنك تحديدها لنا؟
الجيوسياسة كلمة مركبة تعني مقاربة لأوضاع نزاعية الطابع في غالب الأحيان، لها علاقة بالموقع الجغرافي لدولة ما وبجوهر كيانها السياسي، فنجمع هنا بين مقاربة جغرافية نزاعية وبين مقاربة سياسية.
■ ماذا يمكن أن تضيف هذه المقاربة إلى فهم العالم العربي وإشكالياته؟
أنا رأيت أنّ مصير المجتمعات العربية هو في نهاية الأمر مرتبط بالوضع الجغرافي للمنطقة العربية، بالإضافة إلى كل من إيران وتركيا، إذا اعتمدنا مفهوم الشرق الأوسط. فللمنطقة ثلاث ميزات تستجلب التدخل الخارجي. فهي منبع الديانات التوحيدية الثلاث التي انتشرت عالمياً، وهي موقع جغرافي استراتيجي. وأخيراً هناك وجود النفط الذي جلب أطماع الدول الاستعمارية الكبرى والغنية. هذه الميزات الثلاث لا تزال موجودة، وتضاف إليها مشكلة أخرى عند العرب: فهم على خلاف الأتراك والإيرانيين، بعد أفول الخلافة العباسية، خرجوا من التاريخ السياسي للعالم، وأصبح الفرس والأتراك هم أسياد المنطقة. فعندما انهارت السلطنة العثمانية، وجدت المجتمعات العربية نفسها يتيمة، هي التي تعودت العيش في ظل الخلافة الإسلامية. وكانت تنقص هذه المجتمعات أيّة خبرة لإدارة نفسها بنفسها. هذا بالإضافة إلى تمزّق المجتمعات العربية بين الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي، وزرع الكيان الصهيوني في وسط المنطقة العربية فصلاً بين المشرق والمغرب العربي. وبعد المرحلة الناصرية التي جمعت العرب في مرحلة ما، تشتت العرب وتشرذموا، وأصبحت كل دولة عربية تتحالف مع جهة خارجية بدلاً من أن تتحالف الأنظمة العربية في ما بينها. لذلك سميت المنطقة العربية في شكل خاص منطقة فراغ القوة الذي جذب حينها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، ثم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، برزت إيران كقوة إقليمية مهمة ومعادية للولايات المتحدة، فاستمر الانقسام بين الأنظمة العربية. والآن نشهد صعود القوى التركية، ومن غير الواضح إن كان هذا الصعود بالاتفاق مع الولايات المتحدة لتتصرف تركيا كوكيل للمصالح الأميركية، أو إذا كانت هي حركة ذاتية للمجتمع التركي.
■ هل من رابط ما للفلسفة أو للمنهجية الفلسفية بالجيوسياسة؟
الرابط مباشر وأساسي، إنما لسوء الحظ، معظم الاختصاصيين بأمور السياسة الدولية والعلاقات الدولية قليلاً ما يعطون لعامل الإدراك الفلسفي للعالم، في صياغة سياسات الدول الكبرى، الأهمية التي يستحقها. ففي معظم الأحيان، تأتي عمليات الاستيطان والاستعمار لتختبئ وراء أهداف نبيلة فلسفية الطابع. فعندما غزا الأوروبيون العالم كان باسم تنوير الشعوب دينياً لكي تتعرف إلى المسيحية. وفي القرن التاسع عشر، كان الغزو باسم الحضارة ليساعدوا شعوباً متأخرة حضارياً. وساهم أيضاً الفكر الفلسفي الماركسي في تأييد هذا النوع من الحجج الفلسفية الطابع، لأنّ كارل ماركس كان يرى ضرورة أن تنفتح الدول «المتخلفة» للرأسمالية الحديثة، لكي تتسرع عملية التحوّل من النظام الرأسمالي البورجوازي إلى نظام اشتراكي بروليتاري. لدينا منبعان فلسفيان: فلسفة هيغل وفلسفة كارل ماركس. فقد تشابكا ليبررا كل الحملات الاستعمارية، ومن ثمّ لدينا في الفترة الأخيرة، المحافظون الجدد الأميركيون، مثل ريغان وبوش، الذي باسم الديموقراطية، غزا العراق. يجب تفكيك الحجج الفلسفية التي يحملها أي غاز أو أية دولة تقوم بشن الحروب، فذلك يتطلب باستمرار نوعاً من الشرعية الفلسفية أو الدينية.
■ ما هي المكوّنات الأساسية لفكرك؟
أنا أردت أن أعالج شيئين متكاملين. أولاً شعرت منذ دراستي في باريس بالادعاء الأوروبي في امتلاكهم الحكمة والفلسفة والانسانوية، على خلاف الشعوب الأخرى. فصدمت بنوع من النرجسية عند الدول الأوروبية، وهذا مسار طويل أدى في نهاية الأمر إلى وضعي كتاب «تاريخ أوروبا وأسطورة الغرب». ثانياً، كلما تعمقت بالثقافة العربية المعاصرة تبيّن لي مدى ارتباطها بشكل تابع إلى الفكر الغربي، وعدم اطلاعنا على الفكر الصيني والفكر الهندي وفكر الحضارات والمدنيات الأخرى. نحن أصبحنا في نوع من اللقاء وجهاً لوجه مع الغرب الأوروبي والأميركي. لقاء يضعنا في نوع من السجن، غوانتنامو فكري، لأنّ فكرة الاستقلال الفلسفي ضعيفة للغاية عندنا، وقد دعا إليها صديقنا ناصيف نصار. فشعرت بأنّ حتى الحركات الاسلامية الأكثر تشدداً هي في نهاية الأمر نتاج علاقة مرضية مع الفلسفة الغربية والنظرة الغربية إلى العالم. وبالفعل، ماذا نرى عند النخبة العربية المثقفة؟ إما انبطاحاً شاملاً أمام النظام الإدراكي الغربي للعالم، أو نوعاً من الرفض الهستيري له. وذلك في طبيعة الحال تبعية للمنظومة الفكرية الغربية. فأصبحت أدعو إلى الخروج من هذه التبعية، لتأسيس نظام إدراكي معرفي عربي، أي نظام يأخذ بالحساب حقيقة تاريخنا، ويبني هذه المنظومة المعرفية على ذلك. مثلاً، أهم سؤال لم يبحث به أحد هو: لماذا خرج العرب من الحكم؟ما دمنا لا توجد عندنا إجابة عن هذا السؤال، لا يمكننا بناء مستقبل أفضل. كيف انتهت الفتوحات العربية التي أسست للحضارة الإسلامية إلى العرب بالخروج من التاريخ. بالإضافة إلى ذلك طبعاً هناك التخبط بمسائل الهوية عند العرب، منذ زعزعة كيان السلطنة العثمانية في القرن الماضي، والتخبط بشكل خاص بين التمسك برابط ديني أو الدخول إلى التاريخ الوضعي. وإلى الآن المعركة دائرة بشكل كبير في الثورات العربية الأخيرة التي تتلخص في التنافس بين مفهوم الدولة المدنية العلمانية، ومفهوم دولة مرجعيتها أساساً الدين.
■ بما أنّنا تطرقنا إلى ذلك، كيف تقرأ إشكالية العلمانية والطائفية في لبنان؟
أعتقد أنّ لبنان كان له دور طليعي في القرن التاسع عشر، خاصة بعد المجازر الطائفية التي أيقظت العقل اللبناني. لكن نظام المتصرفية أسس لأول مرة في تاريخ لبنان لطائفية سياسية، ثم كرس عهد الانتداب في القانون العام وجود الطوائف كهيئة وسيطة بين المواطن وبين الدولة. وبعدها سعت وثيقة الوفاق الوطني إلى تهذيب الطائفية، وإعادة تكريسها بنحو أكثر توازناً بين الطوائف. نحن لا نزال أسرى الثقافة الطائفية، وهي ثقافة كارثية لأنّها تجعل من الإنسان العربي ينظر إلى أمور الدنيا من خلال المنظار الديني والمذهبي والطائفي، فلا يترقى إلى النظرة الوضعية. عندما بدأت الحرب الأهلية اللبنانية في 1975، كان المحور الأساسي القضية الفلسطينية، وما كان يجب أن تتحول إلى صدام بين المسلمين والمسيحيين. فلو طرحت بالشكل الصحيح، لما استدعت استنفار الشعور المذهبي، لأنّ القضية في لبنان كانت حول الوجود الفلسطيني المسلح. ويؤسفني أيضاً أنّ الجهات التي أعلنت الحرب على المنظمات الفلسطينية المسلحة هي اليوم مستعدة للتوطين، ولكل المقاربة الغربية السعودية، أو «العربية المعتدلة» للقضية الفلسطينية. وأنا اقول دائماً إنّنا في كثير من الأحيان نخسر ما نكسبه في المقاومات عندما تصبح المقاومة لها طابع ديني. فالقضية الفلسطينية ليست قضية دين، بل قضية احتلال شعب واستيطان. لو كان البوذيون أتوا واستوطنوا فلسطين، لجوبهوا بمقاومة شرسة. حتى لو أتى مسلمون أتراك أو إيرانيون واحتلوا فلسطين، أعتقد أنّ الفلسطينيين كانوا انتفضوا. جعل قضية فلسطين مجرد صراع أديان يقلل في نهاية الأمر من الإنجازات التي حققناها أخيراً في المقاومة.
■ ما هي آفاق الربيع العربي برأيك؟
لا شك في أنّ أحداثاً تاريخية حصلت، فيها ذاتية كبيرة. لم تثر الشعوب العربية نتيجة مؤامرة خارجية كما يحلو للبعض اعتقاده. لكن بطبيعة الحال، بسرعة كبيرة جداً دخلت الدول الغربية الكبرى في حمّى استعمارية جديدة، ولازمتها القوى المحافظة المعادية للحداثة السياسية ولحرية الإنسان التي كانت تسمى بالرجعية العربية في الماضي. كذلك دخل العنصر التركي على الخط وابرز نموذجاً إسلامياً كوجهة سير للثورات العربية. هذا طبعاً سيغرّب الثورات العربية ونرى نتائج مؤلمة سواء في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن. ويبقى أن نرى إلى أي مدى ستذهب الثورات في مصر وفي تونس. وعلى كل حال، إنّ الثورات تأتي في حلقات، وقد انفتحت حلقة ثورية في العالم العربي. لكن من الصعب التنبؤ إلى أين ستذهب. أنا دائماً أقول إنّ الثورة الفرنسية انفجرت في 1789 وأعطت نتائجها النهائية فقط بعد قرن، أي عند تنظيم الجمهورية الثالثة، وإبعاد النظام الملكي عن فرنسا، وتثبيت المبادئ الجمهورية. فالحلقة الثورية تأخذ وقتاً طويلاً للغاية، وهي ليست ضربة سحرية تغيّر الأوضاع. وأنا أتصور أنّنا فقط في بداية مسار. وبطبيعة الحال، انزلاقنا إلى مناقشة قضايا دينية ومذهبية باستمرار هو نوع من الاشهار للثورة: فالنظر إلى ما حصل في البحرين وسوريا واليمن من منظار مذهبي هو خطأ. التحليل في غياب المنظومة الفكرية المستقلة والفلسفية هو مرض، فنحن نحلل حسب أدوات وأساليب الدعاية الغربية والأكاديميات الغربية والإعلام الغربي، ونحلل كل شيء بالمنظور المذهبي والطائفي. الولايات المتحدة بدأت قبل بضعة أشهر من غزو العراق بنشر وجهة نظر حول بلاد بين النهرين تقضي بأنّ المسألة تتعلق بأقلية سنية اضهدت أغلبية شيعية. طبعاً هذا النوع من التبسيط الذي نراه اليوم في تحديد الوضع في سوريا أيضاً هو مؤسف للغاية، وهو يؤدي إلى الهلاك وإلى الكارثة. يجب أن نخرج من التحليل المبني فقط على النظر إلى الشعوب العربية كشعوب دينية ومذهبية الطابع، لنرى حقيقة المعطيات الوضعية على الأرض: قضايا الفساد، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد الريعي الذي يؤبد أنظمة استبدادية. فكل مسار الديموقراطية يدل على أنّ الديموقراطية تقوم على تدمير الاقتصاد الريعي. ولسوء الحظ، إنّ الاقتصاد العربي إلى حد كبير اقتصاد ريعي.
تعريف
جورج قرم (1940) خبير اقتصادي ومالي لبناني، اختصاصي في شؤون الشرق الأوسط ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. درس القانون الدستوري والعلوم الاقتصادية في جامعة باريس، وتخرج من معهد العلوم السياسية في باريس. شغل منصب وزير المال في حكومة سليم الحص من 1998 إلى 2000. هو أستاذ محاضر في الجامعة اليسوعية، وقد علّم سابقاً في الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية. له دراسات عديدة، وقد وضع عدداً كبيراً من الكتب والمقالات المتخصصة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، منها: «شرق وغرب: الشرخ الأسطوري»؛ و«لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع»؛ و«المسألة الدينية في القرن الحادي والعشرين» (نال عنه جائزة «فينيكس»)؛ و«تاريخ الشرق الأوسط ــ من الأزمنة القديمة إلى اليوم».
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 24.01.2012
حسين العودات: متى النهضة العربية؟
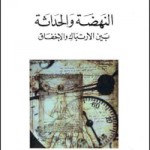
صدر حديثاً عن دار الساقي كتاب حسين العَودات، «النهضة والحداثة بين الارتباك والإخفاق» (2011). هذه الدراسة موسوعيّة، فهي تطلع قارئها على تفاصيل محورية وخطيرة تطاول تطوّر الفكر العربي النهضوي خلال قرنين، وهي تتيح لأهل الاطلاع تعميق معرفتهم بقرائن تاريخيّة وفكرية ضرورية لفهم أحوال العالم العربي الآنية وتمخضاته ونزاعاته. كما تسلّط الضوء على الطاقات الكامنة في الفكر العربي الذي لا يمكن اختزاله بشبه الفراغ المرعب الذي نواجهه الآن، وتطلعنا على تأويلات دينية إسلامية وليدة القرن التاسع عشر، كالاعتقاد أنّ الإسلام «دين ودنيا»، يمكن المرء اعتقاد عمرها من عمر الدعوة الإسلامية. إنّ صدور كتاب العَودات في زمن «الربيع العربي» مرحّب به، لأنّه يجعلنا ندرك أنّ الإشكاليّات التي يتمخض بها سياقنا ليست بحديثة، بل هي نفسها منذ قرنين، تبحث عن حلول لا تزال تتأرجح بين توق الإنسان العربي إلى الحريّة والأصالة، وتسلّط الاستبداد السياسي والأصوليات الدينية. فأسئلة النهضة العربية لا تزال ماثلة أمام المجتمعات العربية، “…لأنّ هذه الأسئلة لم تتلق الإجابات الضرورية التي تحتاج إليها، فبقيت قضايا أساسية تتعلق بمراحل النهضة والتنوير والإصلاح والحداثة والعلمانية والديموقراطية ومفاهيم الدولة الحديثة، تقلق المثقفين والسياسيين والنخب العربية، وتؤثر سلباً على تطوّر المجتمعات العربية، وتثير الصراعات السياسية والفكرية والأيديولوجية داخلها”.
تنقسم دراسة العَودات إلى ستة فصول تعالج مفاهيم متشابكة بعضها ببعض بشكل جذري، بحيث لا يمكن تناول الواحد من دون التطرّق إلى الأخرى. فالنهضة الأوروبية والنهضة العربية، والحداثة، والعلمانية، والديموقراطية وإشكاليات الوطن والقومية والدولة هي مفاهيم متلازمة، لا يمكن إدراكها إلا من خلال قراءة شاملة لتطوراتها وترابطها. ويساعدنا الكاتب على فهم تلك الإشكاليات عبر عرض أفكار عشرات النهضويين من مختلف التوجهات الدينية والثقافية والسياسية، ومن خلال شرح «أسباب فشل النهضة والحداثة وإخفاقهما في البلدان العربية». ومن أهم تلك الأسباب: محاولة نقل «المفاهيم الأوروبية إلى المجتمعات العربية كما هي بلا مواءمة، منطلقين من مفهوم أنّ ما صلح هناك يصلح هنا»، والسلفيّة الدينية الإسلامية، والأنظمة السياسية الاستبدادية. من المستحيل كتابة تحقيق شامل عن تلك الدراسة بعدد قليل من الكلمات، لما تحويه من مادّة فلسفية دسمة جدّاً، ومن جمّ من التفاصيل التاريخية والفكريّة والفقهية. لذلك، سنتطرّق باختصار كبير إلى مادّتي النهضة والحداثة المحوريتين فقط، تاركين للقارئ لذّة التمتّع بقراءة النص الأصلي لهذا الكتاب المرجعي.
يشكّل الفصل الأوّل مقدّمة لفهم الكتاب عبر التطرّق إلى النهضة الأوروبية التي هي في أساس النهضة العربية. والنهضة الأوروبية ليست حصيلة زمن معيّن أو إرادة حاكم أو فيلسوف، بل حالة تطورّت وتكونت على مرّ عدّة قرون وسياقات، وشملت مختلف جوانب المجتمعات الغربية. وقد لزم تلك النهضة قرون عدّة لكي تنقطع عن نظام الحياة القديم، وتهيّئ الطريق للعالم الغربي الحديث بدولته العصرية، وحقوق الإنسان، والإصلاح الديني، والتقدّم التقني، والعلمانية بأوجهها المتعددّة، إلخ. بلغت النهضة الغربية العالم العربي في 1798، عندما وطئ نابوليون أرض مصر حاملاً معه إرثه النهضوي الأوروبي بنموذجه الفرنسي. وبعد توضيح تلك المنطلقات، يتناول الكاتب مسألة النهضة العربية وظروف نشأتها وتطوّرها وإخفاقها، وأحد أهم أسبابه «يعود إلى أنّ معظم النهضويين حاولوا تقليد النهضة الأوروبية … ولم يقوموا بالعمل الدؤوب لتحقيق التفاعل بين مفاهيم النهضة الحقيقية والجذرية وبين ما يجري في العالم العربي». ومن أهم مقومات نضال هؤلاء النهضويين تحقيق الإصلاح الديني الإسلامي، واحترام العقلانية، وإرساء مفاهيم الدولة العصرية، والعلمانية (بالنسبة إلى البعض منهم)، والحرية، والديموقراطية، ورفض الاستبداد. وقد ساهمت عوامل عدّة في نشوء هذه النهضة، ومن أهمّها، تأسيس المدارس الأجنبية وتوسعها، وانتشار المطابع في بلدان عربية مختلفة بعد منعها من قبل العثمانيين لفترة ثلاثة قرون، وظهور الصحافة العربية، والاهتمام باللغة العربية، وتأسيس الجمعيّات التي ستتحوّل لاحقاً إلى أحزاب سياسية، وتزايد عدد الطلاب الذين يسافرون إلى أوروبا طلباً للعلم والذين يتأثرون بمكتسباتها الحديثة، والتحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي حولّت وجه المجتمع. ومن أهم ما استنبطه النهضويّون العرب من النهضة الأوروبية: «الاعتراف بأهمية العقل والعلم في تطور المجتمع، ونشر التعليم، ورفض العادات القديمة البالية، ومحاربة الاستبداد والتخلّف والخرافات، وقبول مبدأ نقد التراث، واستيعاب المفاهيم المعاصرة والوطن والوطنية والأمة والدولة الحديثة، والدعوة إلى حرية الفكر والاعتقاد والمساواة بين المواطنين جميعاً من مختلف القوميات والأديان، والاعتراف بحقوق المرأة، وفصل السلطات». لكن هذه الأفكار جوبهت أقلّه من قبل فريقين، ما حدّ من تطورها وتطبيقها: رجال الدين ودعاة العداء لأوروبا الاستعمارية وأفكارها.
يطلعنا الكاتب من خلال عرضه أفكار النهضويين العرب على التيارات الثلاثة الأساسية التي كانت فاعلة من خلال النهضة العربية، وهي ليست بالضرورة تيارات تتكامل وتتبنى الاتجاهات نفسها، بل هي متعارضة في الكثير من الأحيان، بالأخص عندما يتعلّق الأمر بالمقدّس وبعلاقته بالسياسة وبالمجتمع. فالتيار الأوّل هو التيار النهضوي الإسلامي، الذي أراد النهضة تحت مظلّة النص القرآني والشريعة الإسلامية، ومن أهم من يمثله: رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، أحمد فارس الشدياق، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، عبد الرحمن الكواكبي، قاسم أمين وعلي عبد الرزاق. والتيار الثاني هو التيار النهضوي الليبرالي وهو يلتصق إلى حد كبير بالحراك الفكري والفلسفي، ومن أهم ممثليه: فرنسيس مراش، شبلي الشميل وفرح أنطون. والتيار الثالث هو التيار النهضوي القومي، وقد اهتم مناصروه بالقضايا السياسية بالدرجة الأولى، ومن أهم ممثليه: أديب اسحق، بطرس البستاني، ناصيف اليازجي وابنه إبراهيم ونجيب عازوري. شكّلت هذه النهضة، بأوجهها المختلفة «شرارة الانتقال من عصر الجمود العربي والتخلّف والظلامية إلى مرحلة التنوير والنهوض والإصلاح وامتلاك ناصية التطور، وتحويل المجتمع العربي من الحال التي هو فيها إلى حال أخرى أكثر تطوّراً اقتصادياً وسياسياً وفكرياً وفلسفياً ودينياً». لكن تطبيق هذه الأفكار فشل ولم يتغيّر شيء جذريّ في قلب المجتمعات العربية خلال قرنين، لأنّ بورجوازية محلية قادرة على حمل قضايا النهضة لم تنشأ، ولم ينشأ أي تيار اجتماعي أو حزبي ينادي بهذه الأفكار. وقد وقف «النهضويون الإسلاميون سداً أمام أفكار النهضة بدلاً من أن يحملوا مشعلها حتى النهاية، ولم يروها كما رآها المفكرون والفلاسفة الأوروبيون وبعض المثقفين العرب، وسعوا إلى أسلمتها».
الحداثة مفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهضة، وهو من أحد مكوناتها. الحداثة كما يحدّدها الكاتب هي «منظومة من المفاهيم والعناصر والعلاقات التي تكوّن في مجموعها المجتمع المتطوّر، وتساهم في بناء الدول والمجتمعات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وهي انتصار للعقل في كل الميادين، إذ يصبح العقل هو المرجع، لا النص الديني أو أيّة تقاليد موروثة أو ماورائية. «وتؤكّد أفكارها ونظريتها على تبني العقلانية ونقد التراث، وتطالب بالإصلاح الديني، وتعتمد الفردية والفردانية بحيث لا يحق لأحد الهيمنة على الفرد، وتطالب بتحرير عقله، وأن يوكل إليه تدبير شؤونه وهيمنته على الطبيعة».
لم يمنع هذا الوصف المثالي للحداثة من نقضها، وقد قام بذلك الأوروبيون أنفسهم في القرن العشرين، ولكن على الرغم من ذلك، بقيت الحداثة حاوية للكثير من مقوّمات النهضة، وهي ضروريّة على الرغم من الحذر الذي يجب التمنطق به عند الاستناد إلى معطياتها. ويعتبر الكاتب أنّ الحداثة لم تستوطن بعد العالم العربي، إذ كان تأثيرها جانبياً فقط. فالظروف «الموضوعية والشروط التاريخية والإنسانية المفضية إلى الحداثة لم تتوافر في البلدان العربية». ومن أهم هذه الظروف عدم حسم العرب موقفهم من المقدس بحيث أعطوا العقل دوراً لا يتخطّى الهامش الذي يسمح به الدين، وعدم تحقيق أي إصلاح ديني، فضلاً عن الاستغلال والاستثمار السياسي للدين ومقدساته.
لا شك أنّ هذه الإشكاليّات هي في محور المخاض الثوري الآني. ولكن هل نضج عالمنا العربي، بمشرقه ومغربه لبلوغ ملء قامته النهضوية والحديثة؟ لا ريب أنّ مطالب كثيرة تتلاقى مع المطالب التي ما برح ينادي بها أهل النهضة والحداثة، ومنها الديموقراطية، والتحرر من الاستبداد السياسي، والتخلّص من اللاعدالة الاجتماعية والفقر، والإنماء والإعمار، إلخ. لكنّ العائق الأساسي الذي وقف سدّاً منيعاً منذ قرنين في وجه النهضة والحداثة في العالم العربي لا يزال موجوداً، وتضاعف تأثيره وسلطته على الشعوب العربية، أعني بذلك التيّارات الأصولية والسلفية الإسلامية التي كان وهجها قد اضمحل في منتصف القرن العشرين مع تصاعد القوميات العربية العلمانية النزعة. فهل بالإمكان رجاء نهضة عربية وحداثة عربية، وهما مطلبان إنسانويّان ملحّان، في ظل هيمنة المقدّس المتصاعدة في السياقات العربية المختلفة؟
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 11.01.2012
Extraits
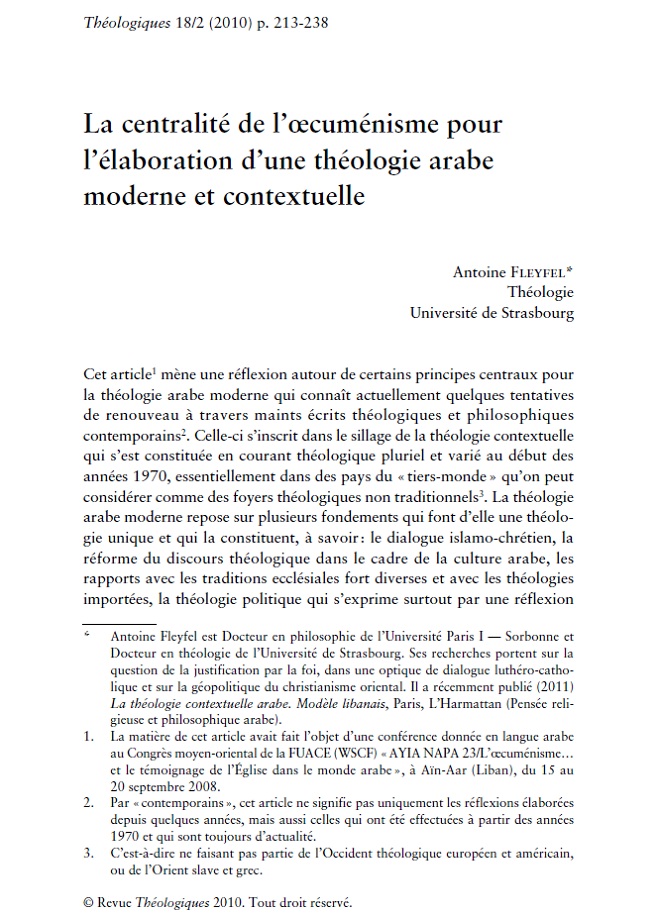
…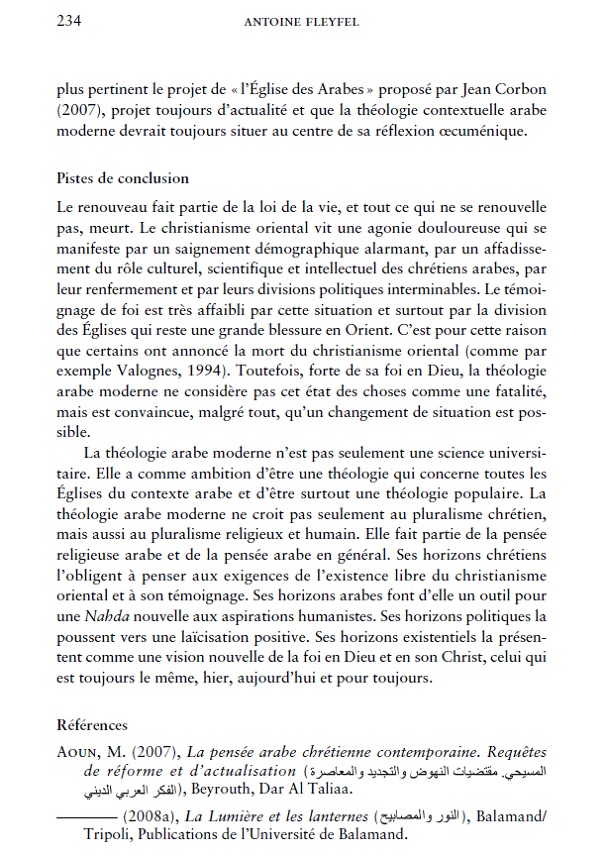
Recension de la “Théologie contextuelle arabe” effectuée par Jacques Schouwey dans “Choisir” (Suisse), revue culturelle, n° 625 – janvier 2012, p.39-40.

Antoine Fleyfel, La théologie contexte arabe. Modèle libanais, coll. “Pensée religieuse & philosophique arabe”, L’Harmattan, Paris, 2011, 330 p., 31,50 euros.
Franco-libanais né à Beyrouth en 1977, Antoine Fleyfel est un homme aux multiples talents : musicien, journaliste, polyglotte, traducteur, enseignant, il est docteur en philosophie et en théologie. Dès 2012, il enseignera ces deux branches à l’Université catholique de Lille.
L’ouvrage qu’il vient de publier est sa thèse de doctorat sur quelques théologiens libanais. Il donne des informations précieuses sur l’histoire, la théologie et la vie des communautés chrétiennes au Liban sous ses aspects humain, culturel, politique, œcuménique et interreligieux. L’auteur y montre aussi les nombreux défis auxquels devraient faire face les chrétiens au Moyen-Orient.
En prenant la théologie libanaise comme modèle de la théologie contextuelle, l’Auteur présente « un nouveau paradigme de la théologie qui opère un changement dans le monde de la théologie, au niveau de sa pratique, de son élaboration et de son rapport à l’Ecriture, aux traditions et au contexte.» (63) La théologie contextuelle, qui tient compte de l’expérience subjective, doit permettre d’éviter de confondre christianisation et occidentalisation. Les penseurs dont les idées sont présentées et analysées ont tous en commun trois éléments majeurs : leur souci de l’œcuménisme, le soin de proposer des critères pour un dialogue interreligieux novateur évitant tout prosélytisme, et une position claire sur la question palestinienne. Tous aussi, selon Fleyfel, s’opposent au sionisme, tout en respectant le judaïsme.
Michel Hayek veut trouver à l’islam une place dans l’histoire du salut. Rattachant l’islam à Abraham, il affirme qu’il n’est ni anti-juif, ni anti-chrétien, mais anté-juif et anté-chrétien. Pour lui, le Liban chrétien – et les maronites en particulier – a une grande responsabilité en Orient : il doit rendre accessible le Christ aux musulmans. Son message n’est pas seulement spirituel, mais aussi humaniste. Il touche à la liberté et au pluralisme. Hayek s’oppose au confessionnalisme (égalité des représentants chrétiens et musulmans dans les pouvoirs publics), car c’est lui qui est souvent considéré comme la cause du problème libanais et de la guerre. Le confessionnalisme « empêche les Libanais d’être libres au sein de leur patrie et d’être des hommes. »(98).
Farouche défenseur de la cause palestinienne, Youakim Moubarak veut que le dialogue islamo-chrétien aborde des questions dogmatiques et n’en reste pas à des questions éthiques et culturelles. Pour lui, l’islam n’est pas une dérive chrétienne sectaire, mais une réactualisation arabe de la foi d’Abraham. (109) Il voit dans l’islam une religion universelle. Un axe important de sa pensée est celui de l’appartenance des chrétiens d’Orient au monde arabe.
Archevêque de Beyrouth entre 1965 et 1975, Grégoire Haddad est démis de ses fonction par le synode, parce qu’il ne correspond pas au standing de son rang, il est trop humble. Surnommé « l’évêque rouge », il est connu pour son engagement social. Il veut une « recherche religieuse radicale », « parce que la religion est une dimension de l’homme et de la société, dimension non provisoire, mais fondamentale et inhérente à l’homme. » (154-5) Sans nier le rôle de l’Ecriture, de la Tradition et du Magistère, Haddad considère que seuls le Christ et l’homme sont les critères absolus de la recherche religieuse. Dans sa démarche, il veut libérer le Christ des représentations traditionnelles pour « faire parvenir le Christ vivant à l’homme vivant. » (158) Pour le Liban, Haddad milite en faveur d’un engagement chrétien en politique et pour un régime politique laïc. Une laïcité globale doit pouvoir viser l’intérêt général. Fleyfel montre que la conception de Haddad rencontre des difficultés de la part des musulmans pour qui les herméneutiques du sacré sont intransigeantes, alors que le christianisme de Haddad repose sur une liberté herméneutique et exégétique.
Présentant la pensée de Georges Khodr, l’Auteur y voit un évêque orthodoxe qui « pense aux voies de rencontre possibles avec l’islam. » (177) Quatre axes articulent cette pensée : le mouvement de réforme du monde arabe, l’engagement pour la cause palestinienne, la dénonciation du sionisme et la réflexion sur la situation au Liban, au Moyen-Orient et dans le monde entier à partir de la foi chrétienne.
Khodr reprend le concept d’une « Eglise des Arabes », développé par Jean Corbon. Il dissocie arabité et arabisme, laïcité et laïcisme ou sécularisme, pour faire ressortir la nécessité de séparer la religion et la politique. La théologie politique de Khodr lie intimement arabité, laïcité et cause palestinienne.
Quant à Mouchir Aoun, jeune penseur libanais, il « propose des solutions aux impasses du dialogue interreligieux, pense les potentialités du renouveau du discours théologique arabe et suggère une laïcité modérée qui est supposées délivrer le Liban des impasses du confessionnalisme. » (219) Il considère le pluralisme religieux comme l’antidote à la violence dans son pays.
S’il voit dans la théologie contextuelle un progrès dans la pensée et des voies d’avenir pour l’avenir de la cohabitation des religions en milieu arabe, Fleyfel déplore cependant que les tentatives élaborées par les penseurs abordés n’aient pas encore eu de suite dans les faits.
Ouvrage de fine analyse et de questionnements multiples, ce livre constitue une excellente approche du milieu théologique, politique, culturel et social du Liban et de la place de ce pays comme modèle possible pour l’établissement d’une paix durable au Moyen Orient.
Jacques Schouwey
PARIS, de Carole DAGHER
Antoine Fleyfel a récemment signé son ouvrage sur « La Théologie contextuelle arabe » à l’Office du tourisme.

Il a l’enthousiasme de la jeunesse et l’audace de pensée qui lui est propre. Blouson de cuir et casque de motard, Antoine Fleyfel bouleverse la docte image que l’on se fait d’un… docteur en théologie et en philosophie. Et pourtant… Il parle avec passion de ce qui le travaille depuis l’âge de 16 ans, à savoir le besoin de « comprendre ma foi, l’Église, les religions ». Il évoque ses engagements dans la vie pastorale de son Église (chorale, groupes de jeunes, veillées évangéliques, lecture de la Bible et de la vie des saints, pèlerinages, mouvements charismatiques…), ses études de théologie à la faculté pontificale de l’USEK d’abord, à « la Catho » de Paris et à Strasbourg ensuite, simultanément avec des études de philosophie (Sorbonne), et sa passion pour la liturgie orientale aussi bien que pour la musique (dont il fut à deux doigts de décrocher la licence). Puis il développe les thèmes de son brillant ouvrage académique : La Théologie contextuelle arabe, modèle libanais, paru dans la collection religieuse qu’il dirige chez L’Harmattan et qu’il signait il y a quelques jours à l’Office du tourisme du Liban à Paris. Ce travail méritoire et pionnier de présentation et d’analyse des écrits des théologiens libanais Youakim Moubarak, Michel Hayek, Grégoire Haddad, Georges Khodr et Mouchir Aoun lui a valu déjà d’être invité dans plusieurs émissions radio ou à la télévision en France pour faire le point de la situation des chrétiens en Orient et des défis auxquels ils doivent faire face aujourd’hui.
Ce livre, explique-t-il à L’Orient-Le Jour, est né d’une interrogation fondamentale qui l’a saisi à l’étude des grands théologiens occidentaux : « Ne puis-je pas mener un discours de foi, un discours religieux contextuel arabe libanais qui réponde à mes problématiques sans être aliéné par deux choses : la tradition et l’Occident ? » Marqué par des philosophes comme Spinoza, Hegel, Kant, Heidegger, ainsi que par les grands théologiens occidentaux comme Bultmann, Kasemann, Küng, de même que par la théologie libérale, Fleyfel a voulu combler le clivage entre « une recherche intellectuelle qui pousse les choses jusqu’à son bout, et un discours religieux et théologique au Liban qui relève d’un autre âge et qui ne répond pas aux attentes existentielles et contextuelles » de nos contemporains. Honorer la tradition, les pères syriaques et les pères cappadociens, saint Ephrem, Grégoire de Nysse, saint Charbel n’interdit pas d’adapter le discours théologique aux problématiques actuelles, et sans forcément devoir traduire dans le but d’appliquer des théologies occidentales.
« Quand j’ai commencé la théologie à Kaslik en 1995, le thème de l’acculturation était à la mode. C’est un néologisme théologique créé par les jésuites dans les années 70, surtout dans les milieux africains, et adopté par Jean-Paul II dans sa lignée évangélisatrice, explique Fleyfel. Mais ceci répond à une logique occidentale propre, qui reste étrangère à la pensée orientale. »
Cherchant un discours théologique propre local, le jeune docteur en théologie découvre, grâce au père Mouchir Aoun, un corpus impressionnant de théologie contextuelle libanaise, regroupant les écrits des pères Michel Hayek, Youakim Moubarak, Mouchir Aoun et Jean Corbon, des évêques Georges Khodr et Grégoire Haddad, et du philosophe Paul Khoury, « qui refuse de s’inscrire dans un corpus théologique ». Ces auteurs, hautes figures du clergé libanais, partagent des points communs : « Ils traitent, chacun à sa manière, de la diversité très belle des Églises, du dialogue islamo-chrétien, et ils le font de manière nouvelle, qui rompt avec la tradition précédente apologétique chrétienne de refus, de rejet (de l’autre). Michel Hayek, Youakim Moubarak, Georges Khodr ont une manière nouvelle d’aborder l’islam. Le deuxième point est une vision partagée de la réforme de l’Église et de la théologie au Liban. Certaines de leurs propositions sont magnifiques comme la restauration d’Antioche, l’Église des Arabes…»
« Le 3e trait de la théologie contextuelle libanaise, poursuit Antoine Fleyfel, c’est la théologie politique, qui aborde les questions de la laïcité, du confessionnalisme, du sionisme, de la cause palestinienne au Liban, de l’arabité. C’est une première au Moyen-Orient, où les chrétiens, de peur de représailles de la majorité musulmane, ont toujours préféré éviter ces questions. Certains textes de Mgr Grégoire Haddad ou de Mgr Georges Khodr sont quasiment militants, mais c’est pour l’amour de la vérité et non pour faire de la politique. La question de la Palestine est en rapport avec la problématique de l’injustice. Cette théologie contextuelle libanaise partage beaucoup d’aspects de la théologie de la libération (concept né en Amérique latine). C’est une théologie de la libération de l’homme. Mais le volet économique est beaucoup moins traité que le volet politique. »
Antoine Fleyfel exhume et présente donc de manière exhaustive, dans son ouvrage désormais recensé dans de nombreux pays européens, des écrits de grande valeur mais oubliés. « La guerre libanaise a notamment tari les recherches, mais elle a aussi été l’occasion d’un grand choc chez Youakim Moubarak et Michel Hayek concernant leurs recherches islamo-chrétiennes, explique Fleyfel. Enfin, ces hommes ont été les exclus de leur Église, ce qui a été un coup dur pour leurs écrits et leurs pensées. Depuis, il n’y a pas eu une génération de théologiens qui prenne le relais. » « Le père Mouchir Aoun, poursuit-il, a repris le flambeau entre 1995 et 2000 en tant que chercheur, philosophe et théologien. Il a de l’audace et va, dans le dialogue islamo-chrétien, jusqu’à parler de pluralisme théologique. »
Par rapport à la théologie occidentale, cette théologie occupe une place exclusive et unique. Le mérite de l’ouvrage d’Antoine Fleyfel est de lui accorder une place dans l’histoire de la réflexion religieuse et philosophique orientale, et de montrer qu’elle peut être un facteur de renouveau au sein des Églises arabes du Moyen-Orient.
Carole Dagher
L’Orient Le Jour
24.12.2011
من مستنقع الشرق… إلى الشرق الجديد

صدور «الآخر» لصاحبيها أدونيس (الصورة) وحارث يوسف، في زمن الثورات العربية ليس مصادفة. هي تصبو إلى الإسهام، على طريقتها، في تقدّم الحراك العربي من أجل إنسانيّة أفضل وعلى طريق التحرر من القيود التي تأسر الإنسان العربي وتحوّل حياته «إلى عالم رهيب من المصحات والمستشفيات السياسية ـــ الاجتماعية». هذه الفصلية التي تقدّم نفسها كمجلّة للذات والآخر، تريد أن تكون مساحة انفتاح بامتياز. تعالج «الآخر» مواد من مجالات متنوّعة. تضع في متناول قارئها مواضيعَ تتعلّق بالفلسفة، والأدب، والشعر، والفن، والموسيقى، وعلوم النفس والسياسة والإنسان. كذلك تنشر مقابلات مع أشخاص لهم عطاءاتهم في عالم الفكر، وتغني بعض مقالاتها بمادة بصريّة لافتة. حجمها المكتنز، وقياسها الكبير، وخطها العريض، وتصميمها السلس، كلّها تفاصيل تجعل قراءتها أمراً ممتعاً.
في العدد الأوّل، لفت انتباه القرّاء ملف مخصص لأحوال الفلسفة العربية المعاصرة، تناول مسائل خطيرة كعجز العرب عن تقديم فيلسوف منظّر على مستوى العالم. وهذا التحري الفلسفي، يأخذ كامل معناه في ضوء الثورات العربية التي ينكبّ عليها العدد الثاني، من وجهة نظر الشباب السوري. هذه الثورات ولدت من رحم تألّم الشعوب العربية الرازحة تحت نير الفقر، والبطالة، والدكتاتوريات، وغياب العدالة. هذه الشعوب التي أرادت التحرّر ممّا يكبل ذاتيّاتها، هي نفسها شعوب تنحو بغالبيتها منحى الحكم الديني والمنطق الديني، ضاربة عُرض الحائط بكل منطق مدني أو علماني يمكن أن يولد مساحات فكرية يمكنها التأسيس لتحرير الذات، أقلّه كما تنظر إليه الفلسفة. لا ريب في أنّ السؤال الفلسفي لا يتعارض مع السؤال الديني. وقد أثبتت ذلك مدارس فلسفية مسيحية وإسلامية ترى التأويل علماً ضرورياً لكل فهم مناسب للنص. لكن السبل الدينية الآنية في العالم العربي، بتأويلاتها العقائدية الإطلاقية، وإصرارها على الترجمة السياسية لهذه الإطلاقية، ستبقى حاجزاً منيعاً ضد كل أرضية تسمح بتحرير الفرد وبلوغه حدّاً أدنى من الوعي الذاتي. هذا الوعي تعدّه الفلسفة مؤسساً لإنسان جديد، متحرر من هيمنة التديّن المُغرِّب والتبعيّة لغرب لم ينته من ابتداع طرق جديدة لاستعمار أرض العرب. تجربة «الآخر» تندرج في هذا السياق، إذ تشرّع صفحاتها على الأفقين المعرفي والنقدي، وترفع لواء الجرأة والفكر الكفيلين في إيقاظ الفرد العربي من سباته الثقافي العميق.
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 21.12.2011
Le « tsunami iraquien » au Liban. Entretien avec Michel Kassarji, évêque chaldéen de Beyrouth
Les chrétiens d’Irak y émigrent dans des conditions misérables en attendant l’obtention d’un visa qui achève leur fuite vers les États-Unis, le Canada ou l’Australie.
Loin de prendre fin avec leur exode des terres de leurs ancêtres, les douleurs des chrétiens d’Iraq prennent souvent des formes diverses avant l’achèvement du périple les déchirant de leur terre d’origine. Le Liban fait partie des États tremplin que les chrétiens d’Iraq visitent pendant quelques temps en attendant l’obtention d’un visa qui achève leur fuite vers les États-Unis, le Canada ou l’Australie. Michel Kassarji, évêque chaldéen de Beyrouth que nous avons rencontré à Paris, nous parle de la situation difficile des réfugiés chrétiens iraquiens au Liban et du rôle central que joue l’Église pour les soutenir.
– Combien de réfugiés iraquiens chrétiens existe-t-il au Liban ?
Il y a un tsunami iraquien au Liban ! Les réfugiés ont commencé à arriver en 1990 suite aux différentes guerres du Golfe, mais c’est surtout après la fin du régime de Saddam Hussein que leur exode s’est fortement accéléré. Le plus grand nombre des réfugiés chrétiens iraquiens sont chaldéens, ce qui est représentatif de leur pourcentage en Iraq où 90% des chrétiens sont chaldéens. Pour ne donner qu’un exemple : on dénombre 30 églises chaldéennes à Bagdad pour seulement 2 syriaque-catholiques. Il existe actuellement 1500 familles chaldéennes (12 000 personnes) au Liban et 75 familles syriaques – catholiques. Notre évêché a la responsabilité des familles chaldéennes.
– Quelle est leur situation humanitaire ?
La situation humanitaire de ces réfugiés est difficile, voire alarmante parfois. Lorsqu’ils arrivent au Liban, ils sont complètement délaissés, et ne peuvent pas accéder convenablement aux écoles ou aux soins médicaux, surtout que certains arrivent gravement malades. Ils vivent dans de très petits espaces, une ou deux chambres qu’ils doivent louer cher, pour y loger à dix ou douze. L’État libanais ne les aide en rien. À cela s’ajoute leur peur de se déplacer à cause de l’illégalité de leur situation puisqu’ils n’ont pas de cartes de séjour. Il y a quelques temps, 450 chaldéens étaient en prison parce qu’ils n’avaient pas de permis de séjour. Normalement, à leur arrivée au Liban, ils obtiennent un visa d’un mois à l’aéroport, renouvelable 3 fois. Mais après cela, ils se retrouvent sans papiers à cause des conditions d’obtention d’un permis de séjour, impossibles pour presque tous les réfugiés. En outre, cela n’est pas le cas en Syrie ou en Jordanie où les conditions sont complètement différentes, puisque ces deux États les prennent en charge. Au Liban, la plus grosse responsabilité repose sur l’évêché.
– En quoi consiste cette responsabilité ?
De prime abord, en tant qu’évêché, nous avons un rôle spirituel à assurer. Le grand nombre des réfugiés a rendu nos locaux insuffisants, c’est pour cela que deux communautés ont mis à notre dispositions leurs églises (les assyriens et les grec-catholiques). Cependant, loin de nous limiter au spirituel, nous assumons beaucoup de rôles humanitaires. Chaque mercredi et vendredi, l’évêché accueille les nouveaux réfugiés en leur créant des dossiers et en leur donnant des aides matérielles et des papiers de reconnaissance. Après cela, il faut les aider à trouver du travail, ce qui n’est pas facile, surtout qu’ils « travaillent au noir ». Cependant, le résultat est largement satisfaisant, puisqu’en attendant leur visa pour l’Occident, 90% de ces réfugiés trouvent un travail temporaire. Quant à la scolarisation d’enfants, l’évêché prend en charge plus de 150 élèves chaldéens. De plus, nous distribuons des aides alimentaires. Pour Pâques 2011, nous leur en avons distribué sous forme de cartons contenant 22 genres d’aliments. Il nous a fallu 120 000 $ pour financer ce projet. Cependant, ces aides sont difficiles à réaliser parce que l’évêché est pauvre et sans revenus, ce qui implique une recherche continuelle de sources de financement. L’Œuvre d’Orient nous aide tous les ans, et de manière ininterrompue. Localement, certains diocèses des différentes Églises catholiques et orthodoxes, apportent de même leur soutien financier. Trouver des fonds est capital pour nous, surtout que le projet d’édification d’un centre médico-social dont bénéficieraient surtout les chrétiens d’Irak est en cours.
– De quel centre parlez-vous ?
Les problèmes de santé vécus par certains réfugiés iraquiens et les complications qu’ils doivent affronter pour accéder au traitement sont à la source de l’idée de ce centre. Le « Centre médico-social Saint Michel », fondé par l’Église chaldéenne au Liban selon les normes internationales des centres de santé, a été inauguré en 2011. Le but de ce projet est d’aider nos frères démunis, surtout les Iraquiens réfugiés au Liban. Effectivement ce centre est ouvert à tout le monde, mais ces derniers ont de larges privilèges et leurs consultations se font à très bas prix. Par exemple, l’échographie qui coûte 100 $ normalement leur coûterait 10 $ chez nous. Le centre, toujours en construction, fonctionne actuellement de manière partielle, et accueille tous les jours presque 20 personnes. Les services médicaux qu’il assure concernent la cardiologie, la pédiatrie, les maladies digestives, l’endocrinologie, la dermatologie, l’urologie, la gynécologie, l’ophtalmologie, l’électrocardiographie, l’échographie, la physiothérapie et bien d’autres domaines. Cependant, il manque toujours des fonds pour qu’il soit complètement fonctionnel, notamment pour acheter du matériel médical nécessaire. Jusqu’au 7 août 2011, date de l’inauguration du centre, la valeur des contributions et des donations avait atteint les 1 120 000 $, et le montant restant pour compléter le projet s’élève à 680 000 $ qu’il faut trouver d’urgence. Cela est le but actuel de mon voyage en France, lever des fonds servant à l’urgence humanitaire des réfugiés iraquiens au Liban.
– Quels sont les horizons d’avenir des chrétiens d’Iraq ?
Je ne partage pas l’optimisme de certains évêques iraquiens. À mon avis, d’ici 25 ans, la situation des chrétiens d’Iraq sera semblable à celle actuelle des chrétiens de Turquie ou de la Terre Sainte, parce que les conditions de vie actuelles des chrétiens iraquiens ne permettent pas une présence durable, surtout avec l’absence d’une vision et d’une stratégie d’avenir. On a l’impression que dès qu’un chrétien naît, son but ultime est d’obtenir un passeport afin d’émigrer. La politique occidentale est partiellement responsable de cet état d’esprit, puisqu’elle encourage l’émigration, du moment qu’il faut penser à une stratégie pour rester. Dans le temps, il a été question d’acheter un grand bout de terrain au Liban pour que 3000 à 4000 familles iraquiennes chrétiennes puissent y habiter et travailler (écoles, usines, commerces). Mais les volontés politiques et ecclésiales n’ont pas convergé, et le but ultime des réfugiés iraquiens au Liban est resté d’émigrer aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Ainsi, le périple des réfugiés iraquiens au Liban va durer probablement 25 ans, le temps que tous les chrétiens d’Iraq émigrent. Chaque vague de réfugiés reste en général entre 1 et 2 ans au Liban.
– Mais qu’en est-il de la situation actuelle des chrétiens en Iraq, et est-ce qu’il y a vraiment une volonté de les exterminer ?
Des 1 400 000 chrétiens qui vivaient en Iraq, dans de bonnes conditions, sous le règne de Saddam Hussein, il reste actuellement 400 000. Quelques 100 000 vivent à Bagdad et le reste est surtout au Kurdistan. Mais la situation est différente selon les régions. À Bagdad par exemple, sur 30 églises chaldéennes, seulement 10 fonctionnent. Les autres sont désaffectées ou n’ont plus de prêtre, et parfois on n’ose tout simplement plus les ouvrir. Cependant, au Kurdistan où les chrétiens immigrent beaucoup, la situation est stable, mais je crois que c’est temporaire. Par ailleurs, il ne me semble pas qu’une volonté générale d’une extermination des chrétiens d’Iraq existe. Ce sont plutôt de petites cellules fondamentalistes qui profitent de la situation instable pour commettre des attentats.
En plus, le conflit entre sunnites et chiites en Iraq provoque une déstabilisation fortement défavorable aux chrétiens qui n’ont ni programme politique ni armes.
Antoine Feyfel
L’Œuvre d’Orient
08.12.2011
الشيخ شفيق جرادي: لا إنسان من دون سؤال

مع افتتاح معهد المعارف الحكمية في ضاحية بيروت الجنوبية، أعاد الشيخ شفيق جرادي الحياة لاختصاصات علمية فلسفية إسلامية. جرادي الذي يرى أنّ الإنسان اضاع الفلسفة الحقيقية للأديان عندما استغرق في اللاهوت ونسي الناسوت، يقول إنّ المنبع الأساسي للفلسفة هو السؤال الإنساني
■ قلّما ألفنا وجود معاهد فلسفة إسلامية في لبنان والعالم العربي. وها هو «معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية» يقوم بنشاط علمي فلسفي رصين. ماذا عنه؟
افتتح المعهد في 1999، وكان المقصود في بداية تأسيسه تعليم الفلسفة الإسلامية من خلال تحصيل دراسي يدوم أربع سنوات ندرّس خلالها مواد عدة، كالمنطق والفلسفة الإسلامية والعرفان، أي التصوف من منطلق فلسفي. وقد اهتممنا بنحو خاص بمدرسة فلسفية يطلق عليها اسم «الحكمة المتعالية» للفيلسوف صدر الدين شيراز (إيران، 1571 ــ1640). تطوّرت الفكرة في ما بعد إذ قام المعهد بإصدار مجلّة «المحجّة» المتخصصة بالفكر الديني المعاصر وفلسفة الدين والفلسفة الإسلامية بفكرها الأخير الذي تمثّله مدرسة «الحكمة المتعالية»، ومسألة الحوار الإسلامي ــ المسيحي. ونحن نرصد كل جديد في الفكر الديني المعاصر، في الشرق والغرب. وبعد انطلاق المجلّة التي هي منبرنا، شرعنا بنشر الكتب وأنشأنا دارنا الخاصة التي أصدرت إلى الآن ما يقارب الثمانين إصداراً. كذلك أنشأنا «المنتدى الفلسفي» الذي نستضيف به دورياً شخصيّات معيّنة لها طرحها الفكري أو بحثها الخاص.
■ لكن أليست العلاقة بين الفلسفة والدين الإسلامي إشكالية منذ عدّة قرون؟
لدي إيمان شخصي بأنّ كلّ دين من الأديان يحمل سعة واسعة جدّاً من التأويل، وذلك ما سمح بإنتاج الكثير من المذاهب والاتجاهات الخاصة، ومنها من أنتجت تطرّفاً، أو عزلة، أو انكفاء أو حتى ديناً شعبياً. ولكن هناك أيضاً مساحات من التأويل الديني تنتج السؤال، وأقول ذلك اعتقاداً منّي أنّه لا دين خارجاً عن نطاق العلاقة مع الإنسان. فلا شكّ أنّ الله هو، في إيماني على الأقل، حقيقة موجودة، بغض النظر عن الإنسان، لكن ذلك لا يعني أنّه يوجد دين من دون الإنسان. بناءً عليه، إن لم يكن الخطاب الديني موجّهاً إلى الإنسان، يصبح خطاباً عبثيّاً. صحيح أنّ هناك نظرة موجودة عن الأديان قوامها أنّها بعيدة عن العقل الناقد وأنّها تمارس الترويج للفكرة أكثر من ممارسة السؤال النقدي، وتلك الصورة تكثّف بنحو كبير في الفترة الأخيرة عند الحديث عن الإسلام، وسبب ذلك أنّ التفكير السائد بين المسلمين يذهب باتجاه مدارس منعت السؤال النقدي بفعل ممارستين: ممارسة داخليّة عند بعض المسلمين الذين لجأوا إلى ترهيب الآخر في الموقف من خلال جمود ذهني، وممارسة الغرب، الذي جعل من هذه الصورة النمطية حقيقة مطلقة، فأصبح المسلم، في المشهد الهوليوودي، يساوي زمناً معيّناً، وهو العربي الخليجي الذي يضع العقال، ولديه تفكير يشبه الصحراء.
■ كيف تواجهون إذاً تلك المعضلة، وكيف تفهمون الفلسفة؟
هل يوجد شيء اسمه فلسفة كحقيقة مطلقة ومستقلّة؟ بتقديري كانت هناك محاولات لم تنجح لتحويل الفلسفة إلى علم، وبقية الفلسفة تحتضن طبيعتها الخاصة التي تنبع من الدهشة، إذا صح ما ينسب إلى أرسطو، والدهشة تعني ملاقاة ذاتي مع المحيط، ومع الآخر، أكان إنساناً، أم السماوات وما فيها، أم أنا بذاتي. هذه الدهشة التي تعبّر عن حقيقتك، تلفت نظرك إلى الأمور المحيطة وتثير بك السؤال. ولذلك، فإنّ الأصل في الإنسان هو طرح السؤال قبل التكلّم عن الإجابات. وكل إجابة قد تسمى فلسفة، أو ديناً، أو فكراً. لكن المنبع الأساسي هو السؤال الإنساني. بناءً عليه، إن كان الدين ينتسب إلى ذلك الإنسان، فالفلسفة تنتسب إلى هذه الدهشة الخلاقة الموجودة عند الإنسان، أو القلق الخلاق، والذي لا بدّ من أن يولد السؤال. لا إنسان من دون سؤال، ولا دين من دون سؤال، ولا فلسفة من دون سؤال. وسر الاختلاف بين الفلسفة والدين هو الاختلاف في الجواب، لا الاختلاف في المنشأ. نحن نعتقد أنّ علينا أن نوحّد الحقيقة الإنسانية التي توحّد السؤال. وينبغي أن يكون السؤال دائماً مفتوحاً ودائماً مهاجراً، يتنقل بين الفلسفة ونقدياتها، وبين الشعوب والأمم، وبين الأفكار والاتجاهات والأديان، وأستغفر الله على هذا الكلام، بين الآلهة التي نعتقد فيها في كافة الأديان. هذا السؤال يتنقل دوماً برغبة جانحة نحو شيء لا يستطيع أحد أن يقبض عليه وهو الحقيقة، تلك التي ترغبها من دون أن يكون بوسعك أن تقبض عليها. وأخيراً، إنّ أجمل شيء في السؤال الفلسفي هو اللحظة التي يرف فيها بالغيب وجع الإنسان. نحن أضعنا الفلسفة الحقيقية للأديان عندما استغرقنا في اللاهوت ونسينا الناسوت الذي له علاقة بالوجع وبالألم وبالموت وبالحياة وبالاختبار وبتقارب الناس وبالسلم وبالحرب. وهنا الفلسفة الحقيقية. فكل شيء متعلّق بالله له علاقة بالإنسان. الرحمن مثلاً أو الرحيم، هو متعلّق بالإنسان. رابطه هو الناسوت. لا شيء خارج هذا الناسوت، وأنا لا أعرف أن أصلي من دون الفلسفة، من دون أن أفهم.
■ كيف تشخّص إذاً مشكلة الفلسفة الإسلامية الحالية بمخاطبتها مع العالم المعاصر؟
نحن المسلمين ندفع ضريبة بالحقيقة، لكون اللغة التي نستخدمها بتحليلنا الفكري وبقراءتنا الفلسفية لغة هي بالغالب خارج الإطار المعاصر. لا يمكنني أن أكلّمك اليوم بلغة القرن الرابع الهجري مثلاً، لأنّك لن تفهم لغتي. لكن هل يقبل الدين بالمعاصرة؟ عند المسلمين قاعدة اسمها «قاعدة الجري»، والمقصود فيها أنّ النص الديني ينبغي أن يجري مجرى الزمن. الثمن الذي ندفعه أننّا لم نعمل على لغة التفكير فضلاً عن لغة المحادثة، واللغة عامل أساسي لفهم الوجود ولمخاطبة الآخرين. فعندما أصبح منتمياً إلى لغة أخرى، كما هي الحال الآن مع الغرب، يحصل عدم فهم بيننا. أنا أدّعي أنّ المعهد يسعى لتقديم محاولات كهذه، وأنا على صعيد شخصي معني بهذا الموضوع، لأنّه ممنوع علينا أن نكون مجرّد مستهلكين في الشرق، بحيث نستجلب السؤال من أفق معرفي غربي. من حقي أن يكون لدي سؤالي الخاص بي النابع من انتمائي وهويتي وبيئتي. هكذا نحاول أن نوجّه الأمور ولا نزال.
■ وما دور هذا النوع من الفلسفة في عالمنا العربي المعاصر؟
قدرة العالم العربي على الاستهلاك تدهشني. مثلاً في أغلب ما كتب في العالم العربي، نحن دائماً معنيون بمنهجيات أخرى. لا أقول ذلك انطلاقاً من عداوة للغرب وأنا لا أكنّ له أي عداوة. أنا جزء منه وهو جزء مني ولا يمكننا أن ننفصل. فنحن نعيش الآن بوحدة إنسانية. أنا أرى أنّ كل ما أنتج تقريباً في الشرق على مستوى الفلسفة هو دون أي أطروحة دينية، سواء كانت مسيحية أو إسلامية، لأنّ هذه الأطروحات فيها إضافات اليوم. لكن في الإطار الفلسفي ما الذي يقدّم؟ لا يوجد إلا ترجمات لفلان بلغة ينسبها لنفسه، أو يترجم أقوالاً مشوهة. تنتهي الموضة في بلاد الغرب ونحن نكمل بها. نشاطنا في هذا المعهد يبغي الخروج من هذا المأزق مع أنّني لا أعرف إلى أي مدى قد نجحنا. ولكنني أراهن على رغبة الاستقلالية الموجودة الآن عند شعوب المنطقة، عسى إرادة الاستقلالية أن تنتج فكراً يرغب في الاستقلال. فالفكر المفصول عن حراكك اليومي ليس بفكر. فإن كنا اليوم في صحوة جديدة نفكر أن نحرر إرادتنا من قيود وارتباطات، من الممكن أن يعمل ذلك في لحظة من اللحظات بعقول قابليّاتها مبدعة لكن ظروفها لم تكن سانحة حتى تبدع. فهناك استفاقة في العالم العربي، وأنا لا أراهن فقط على نزول الناس إلى الشوارع، بل أيضاً على أن يوّلد شارع الشباب والفقراء نموذجاً جديداً. مثلاً، فلنتكلّم عن الحالة المصرية: ليست الحركات الإسلامية من عملت هذه الانتفاضة، ولا جهات مسيحية أو علمانية. من صنع هذه الاستفاقة هم شباب، أي الضمير الحي والطموح. والآن يتناقشون بكل شيء إلا مع الشباب. لكن أين هي إرادتهم وموقعهم في الحكم وشكله ونظامه. حقهم على الأقل أن يأخذ هذا الشكل من الحكم نظراتهم وتطلعاتهم وتضحياتهم، والخوف هو أن تصبح الإرادة التي يجسدها الشباب في ميل ومن يدعي الحكمة في ميل آخر.
■ ماذا عن الطائفية والعلمانية في لبنان؟
المفردة الوحيدة التي أعرف معناها في لبنان هي الطائفية. لكنّني لا افهم ما المقصود بالعلمانية، وهنالك لغط. فكلمة علماني في الأوساط المسيحية غير فهمها في الأوساط الإسلامية. ففي الأوساط الإسلامية تمثّل العلمانية عقدة تاريخية لدخول الغرب إلى بلاد العالم الإسلامي ومحاولة لإقصاء الدين. فالمشكلة ليست في المصطلح بل في عقدة موروثة تاريخياً. أمّا العلمانية في الفهم المسيحي فهي حكم مدني لا يشارك فيه الإكليروس. أعتقد أنّ العلمانية هي اتجاه في ممارسة الشأن الحياتي، قد يكون متطرفاً وقد يحمل الكثير من الإيجابية والاعتدال. أنا لست معها أو ضدها لكنّني أريد أن تحدد الأمور بشكل واضح وهذا ليس ببديهي. خرجت مثلاً في الآونة الأخيرة مسيرة تطالب بالعلمانية. ومن بعدها، بدأت الهتافات ضد الطائفيين. ماذا يقصدون بذلك؟ الجماعات؟ وإلى مَ يؤدّي ذلك؟ إلى تكوين طائفة جديدة ومحدّدة وموجودة في الزاوية، وهذا ما حصل. فأوضح شيء في لبنان هو الطائفية، وفي الوقت الذي تظن فيه أنّك تحاصر بقية الطوائف، فأنت لا تحاصر إلا نفسك. قدر هذه الطوائف أن تبقى منفتحة على بعضها، وأن نتحمّل جوانب الطائفية السيئة. لكن تبقى مشكلة العلمانية أنّها غير محدّدة في لبنان، وحتى تعريف الدين غير محدد. فالأمر الوحيد المحدد هو الطائفية.
تعريف
ولد الشيخ جرادي في بيروت في 1962، واهتم بالفلسفة في عمر مبكر، فبدأ يخوض النقاشات الفكرية في الثالثة عشرة مع اليساريين والقوميين، ممن يكبرونه سناً وثقافة. سافر إلى حوزة قم في إيران حيث تابع دراساته الدينية لفترة سبع سنوات طبعت وجدانه بشكل فريد. فلسفياً، أعجب بفلسفتي ماركس وهيغل، وإسلامياً، تعلّق بشخص الخميني. وهو لا يخفي إعجابه برسالة الأم تيريزا. التزم العمل المقاوم ضد العدو الإسرائيلي منذ بداية الثمانينيات. أسس في 1999 «معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية» (حارة حريك) الذي يلعب دوراً ليس فقط على صعيد الفلسفة الإسلامية المعاصرة، بل أيضاً على صعيد الحوار الإسلامي المسيحي. له إصدارات عديدة، أهمها: «مقاربات منهجية في فلسفة الدين» (2004)، و«إلهيات المعرفة، القيم المتبادلة في معارف الإسلام والمسيحية» (2006).
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 06.12.2011
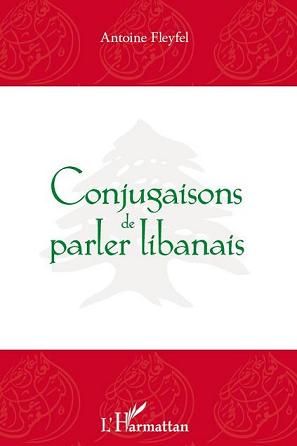
Ces Conjugaisons de parler libanais s’inscrivent dans la continuité du Manuel de parler libanais (L’Harmattan 2010) et des Exercices de parler libanais (L’Harmattan 2011). C’est un outil de travail indispensable pour le perfectionnement de la conjugaison des verbes du dialecte libanais.
Les Conjugaisons de parler libanais sont composées de deux parties. La première conjugue en détail 80 verbes de toutes les catégories et donne avec chaque verbe plusieurs exemples de phrases. La seconde met à disposition plus de 500 verbes avec leurs radicaux, vous permettant de les conjuguer à tous les temps. Et enfin, un appendice récapitule tous les modèles verbaux en quelques tableaux.
N’hésitez pas à visiter : www.parlerlibanais.fr
|
|