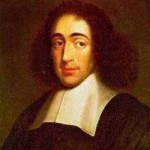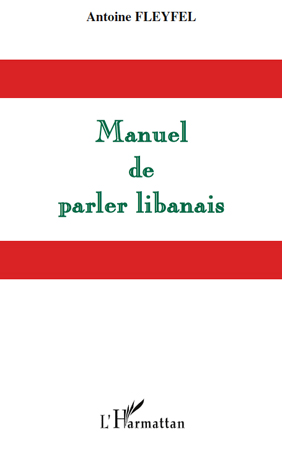|
|
سبينوزا يحلّ ضيفاً على سوريا
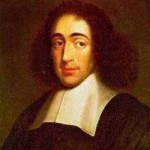
الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا (1632 ــ 1677) ليس غريباً عن شرقنا. فهو، أولاً، من أصل يهودي. وحتى لو حُرم ورذل من أبناء ديانته، واتهم بالتجديف والإلحاد، يبقى فكره الفلسفي والتاريخي النقدي ملتصقاً بالعالم السامي. وهو، ثانياً، قُرئ في العالم العربي المشرقي والمغربي، وقد عرّبت كتاباته.
لا عجب في أن يهتم مفكرون عرب بفكر سبينوزا. فالإشكاليات اللاهوتية السياسية التي يتناولها، لا تزال آنية في تضاعيف معضلات شرقنا الدينية والسياسية والطائفية، حيث صاغ الفيلسوف المتمرد أنظومة فكرية فلسفية علمانية، تحرص على احترام الدين ووجوده، مع تناولها له من زاوية نقدية متقدمة جداً، ومع إخضاعه التام للسلطة السياسية العلمانية. معضلة علاقة الدين بالسياسة شائكة في العالم العربي، إن كان من جهة تطبيق الشريعة الإسلامية، أو من جهة بنية النظام الطائفي. ولا شكّ أنّ المطّلع على السياق الديني والسياسي الأوروبي، الذي عاش فيه سبينوزا في القرن السابع عشر، يجد روابط قربى كثيرة مع أحوال اللاهوت والسياسة في العالم العربي. فالفكر الديني آنذاك كان ينادي بهيمنته على السياسة، وكان يؤسس حجته على «المقدّس»، أي على ما هو خاص بالله، خارج عن التاريخ، ومعطى عبر الوحي للناس، كشريعة دينية تسوس المدينة. أحوال الكثير من الأنظمة السياسية والأنظومات الفكرية في العالم العربي مشابهة لذلك حالياً، إذ يُطبّق أو يُنادى بمنطق يُخضع النظام السياسي لمحتويات فقهية أو لاهوتية، ويجري إخضاع «المدني» لـ«المقدّس». لذلك، تبدو فلسفة سبينوزا واقعية وكاملة المعنى في سياقنا الحالي. ولكن، لا شكّ أنّ صعوبة فكر سبينوزا وقلّة اهتمام أهل العروبة بالفكر وارتباط «المقدّس» بالعنف، لها الوقع الأكبر على التناول، الخفر جداً، لفكر الفيلسوف في العالم العربي.
كم كانت مفاجأتي سارّة عندما وقعت صدفة على كتاب الدكتور منذر شيباني، «سبينوزا واللاهوت»، وقد صدر عن منشورات وزارة الثقافة ـــــ الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009. كلّ عمل فكري يبقى مرتبطاً بالقرائن التاريخية والاجتماعية والسياسية التي يولد في كنفها، لذلك، لا بدّ من التساؤل عن معنى حلول سبينوزا ضيفاً على سوريا في هذه المرحلة التاريخية بالذات، لكن قبل محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، لا بدّ من عرض محتوى كتاب شيباني، وهو خير مرشد لفكر سبينوزا، الناقد للدين.
كنّا نتمنّى أن يأتينا الكاتب بتحليل جلي، ولو مقتضباً، للسياق العربي على ضوء الفلسفة السبينوزية، لكن ربّما دفعته اعتبارات عدّة، منها حساسية هذا الموضوع، الذي محوره النقد الديني، إلى الإعراض عن هذا الأمر. على الرغم من ذلك، يقدّم الكتاب معطيات فلسفية سياسية ومحورية للقارئ العربي، الذي يبحث عن سبل فكرية ناقدة لفهم واقعه الراهن. يبغي شيباني توضيح إلحاد سبينوزا عبر درس موقفه من علم اللاهوت، ولهذه الدراسة علاقة مع قرائن العالم العربي الحالية: «المأزق الحضاري الذي عاشه سبينوزا، الذي يتبدّى من خلال نصوصه وحياته، ربّما يقترب بشكل أو بآخر مما نعيشه راهناً، مع حفظ الخصوصيات التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية». يبدو الانتقال من حضارة النص اللاهوتي إلى القانون العلمي سبيلاً لحل هذا المأزق في الفكر السبينوزي. يوضح شيباني ذلك عبر أربعة فصول.
يتناول الفصل الأول الظروف التاريخية التي أدّت، في عصر النهصة، إلى ولادة النقد اللاهوتي عموماً، والنقد السبينوزي خصوصاً. ويذكر منها التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، ونشاط الطبقة البرجوازية والفكر الإنسانوي. ويشير الكاتب إلى أهمية العامل الجغرافي الذي أسهم في توسيع آفاق الإنسان الذي اكتشف أنّه ينتمي إلى عالم أوسع. أسهم ذلك في زعزعة مطلقية المسيحية التي أيقنت أنّها ديانة قارة صغيرة (أوروبا). أضف إلى ذلك جواً من الحرية الفكرية والفلسفية.
يتكلم الفصل الثاني عن نقد سبينوزا للنص المقدس، وهو نقد قائم على ثلاثة محاور: النقد التاريخي، النقد الفيلولوجي (فقه اللغة)، والنقد البنيوي. الفصل الثالث يتناول النقد السبينوزي للإيديولوجية المبنية على «المقدّس». ففيما يقدّس أتباع هذا المنطق، العالم، لأسباب تعود إلى الهيمنة السياسية، ويربطون كلّ فعل بالتقوى الدينية، يعيد سبينوزا الإنسان إلى مكانته «الطبيعية».
أمّا الفصل الأخير، فيتناول علاقة الكتاب المقدّس بالحقيقة. فيرى سبينوزا أنّه لا حقيقة علمية في الكتاب المقدّس، بل حقيقة أخلاقية وأسس للتعايش الإنساني المسالم. لذلك هو يرفض المفاهيم اللاهوتية الأساسية كالوحي أو العناية أو المشيئة الإلهية، ويرى أنّ الأنظومات اللاهوتية ما هي إلّا بناء ناتج من مخيلة الأنبياء الخصبة.
تستحثّ فلسفة سبينوزا الناقدة التفكّر في أوضاع الدينيّات والسياسيّات في الشرق العربي، وتدفع الباحث إلى طرح تساؤلات تتخطّى إطار الوحي اليهودي والمسيحي وتصيب الإسلام، وما هو مقدّس لديه، لكن، إن كان المفكّرون السبينوزيون وأعداؤهم قد ألفوا فكرة نقد سبينوزا لليهودية والمسيحية، ويمكن هذا النقد أن يُعنى بالصهيونية أو بالنظام الطائفي اللبناني، فإنّ عالم الفكر لم يألف بعدُ تطبيق هذا النقد على الوحي القرآني. ولهذا المنسلك حقول خصبة جداً وآفاق عسيرة حقاً. فطرح مسائل النقد الفيلولوجي للقرآن والاستقصاء التاريخي عن جذور الشريعة الإسلامية والحيز الإيديولوجي للديانة الإسلامية وانصياع الدين لحكم مدني لاديني، وغيرها من الإشكاليات السبينوزية، يمكنها أن تكون مصدر توترات كثيرة. لذلك، نحن لا نظنّ أن نشر كتاب عن النقد اللاهوتي السبينوزي في سوريا هدفه التأسيس لمرحلة نقد شاملة للأنظومة الدينية في الشرق، لكن، لا بد من الإشارة إلى الأحداث الأخيرة في سوريا، حيث النظام يقوم بإجراءات لتعزيز العلمانية وللحد من المظاهر الدينية لعلّها تحتوي بعض النزعات الأصولية. فقد قرأنا أنّ الحكومة السورية اتخذت عدداً من القرارات التي طاولت سلوكيات دينية متعددة، كمنع النقاب في الجامعة، واتخاذ إجراءات بحق المعلمات المنقبات التابعات لوزارة التعليم، وتنظيم الارتياد إلى الجوامع ومنع الاعتكاف فيها، وتنظيم المآدب الرمضانية، والتأكيد على ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة فقط، ما يعني منع وجود مصلى في المطاعم وممارسة الطقوس الدينية في أماكن أخرى، ومنع إبراز الأفراد للشعارات التي توحي بانتمائهم الديني، مهما كان هذا الانتماء. تدفعنا، كلّ هذه المعطيات، إلى الاعتقاد بأنّ سبينوزا لم يحل صدفة ضيفاً على سوريا، وأنّ التطرّق إلى فكره النقدي، في هذه المرحلة بالذات، له دلالات لم ننته بعدُ من قياس كل أبعادها.
هل يحل سبينوزا ضيفاً على لبنان وعلى كل الشرق؟ من العسير دعوة الفيلسوف إلى ديار تأنس، يوماً بعد يوم، معاشرة التطرّف الديني والأصوليات، وتستطيب مسامرة الطائفية بتجلياتها المتعددة، لكن، إن حلّ ضيفاً أو إن بقي غريباً، تبقى تساؤلاته مجدية ونصب كل معضلات الشرق العربي الدينية السياسية.
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 13.01.2011
À quatre-vingts ans, le théologien suisse livre quelques pensées vigoureuses sur la vie en général et la foi en particulier.
Hans Küng, Faire confiance à la vie, Paris, Seuil, 2010, 346 p.
Hans Küng surprend toujours. Estampillé « rebelle » à son corps défendant, interdit d’enseigner en faculté de théologie catholique depuis 1979 à cause de ses positions audacieuses et controversées, le théologien publie un livre d’une toute autre facture que ses précédents. Faire confiance à la vie (Ce que je crois, dans sa version originale allemande) est une œuvre de maturité. L’auteur y propose, à travers nombre d’éléments autobiographiques, une spiritualité et une sagesse de la vie qui traitent de la confiance, du sens, de la souffrance, de la raison d’être, de l’art d’exister… Cet ouvrage, alliant la joie de croire à celle de vivre, s’adresse à des personnes « en recherche », insatisfaites de leur foi traditionnelle ou voulant en rendre compte d’une manière renouvelée.
Un questionnement existentiel
« Ma spiritualité se nourrit d’expériences quotidiennes… Elle est éclairée cependant par des connaissances scientifiques… ». Küng n’emprunte pas les chemins de la foi sans avoir entamé un questionnement existentiel qui concernerait croyants et athée. Les sciences humaines et exactes éclairent sa compréhension du monde et contribuent à élaborer son propre point de vue sur la vie, car « comment croire en Dieu si je ne puis m’accepter moi-même ? ». Ainsi, l’étape fondamentale d’une confiance critique et prudente est dépeinte par le théologien comme une base du vivre ensemble des humains. Ceux-ci sont invités à la joie de vivre à travers la contemplation de la nature ou l’humour, mais surtout par le biais de certains principes éthiques : la non-violence (respect de la vie), la solidarité (contre l’exploitation), la tolérance, le refus du mensonge, l’égalité. Ces normes qui devraient constituer une éthique mondialisée, trouvent leurs assises dans les enseignements de toutes les religions et dans les principes séculiers humanistes.
Une foi qui parachève le sens
Pour Küng, il appartient à chacun « d’inventer le sens de sa vie », de s’engager pour une cause caritative, social, politique, ecclésiale afin de se réaliser. Cependant, cet effort humain ne se parfait que lorsqu’il est parachevé par le « grand » sens qui transcende l’aujourd’hui en ouvrant l’homme à Dieu, « sens définitif et ultime ». Respectant toutes les expériences religieuses, mais écartant tout inclusivisme théologique, le théologien s’imagine les convictions et attitudes critiques qu’il aurait eues s’il était né musulman, hindou ou bouddhiste. Ce qui ne l’empêche pas d’expliquer le sens de sa foi chrétienne. Celle-ci n’implique nullement la vénération d’une autorité, d’une tradition ou d’une herméneutique quelconques, mais se fonde « exclusivement [sur] le Christ réel, historique ». Suivre le Nazaréen engage l’homme sur les chemins d’une « libératrice spiritualité de la non-violence, de la justice, de la charité et de la paix », et ouvre ses horizons à la vie éternelle. Et même si, au moment de la mort, le néant se présentait en maître, Küng réactualise pour nous le pari pascalien : « j’aurais, quoi qu’il arrive, dit Küng, mené une vie meilleure et plus remplie de sens que sans cet espoir ».
Antoine Fleyfel
06.01.2011
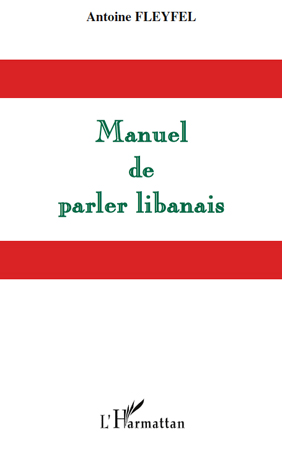
Ce manuel est le fruit de plusieurs années d’enseignement du dialecte libanais au Foyer franco-libanais à Paris.
Il s’adresse à des Français(es) et à des francophones désirant étudier le dialecte libanais, dans le but de le parler et sans passer par l’apprentissage de la langue arabe et de son alphabet.
Cette méthode fournira à celles et à ceux qui la travaillent des éléments de base pour leur apprentissage du parler libanais.
N’hésitez pas à visiter : www.parlerlibanais.fr
«بين الابن والخليفة»: الهويّة الإنسانيّة في الدين والعلمانيّة

صدر حديثاً عن «مركز الأبحاث في الحوار المسيحي الإسلامي» كتاب للدكتور مشير باسيل عون، بعنوان «بين الابن والخليفة، الإنسان في تصورات المسيحية والإسلام» (منشورات المكتبة البوليسية ـ 2010). يروم هذا البحث إلقاء الضوء على مقاربة جديدة في أدبيات الحوار المسيحي الإسلامي، أعني الاستقصاء الأنتروبولوجي عن العناصر الأساسية المكونة للهوية الإنسانية، بروافدها المسيحية والإسلامية والعلمانية. يندرج هذا الإسهام في إطار كتابات عون عن الحوار بين الأديان، نذكر منها «بين المسيحية والإسلام، بحث في المفاهيم الأساسية» (المكتبة البوليسية، 1999) و«النور والمصابيح، التعددية الدينية في جرأة المساءلة اللاهوتية المسيحية» (جامعة البلمند، 2008).
لا ينحصر هذا البحث في إطار المساءلة العلمية الخالصة، إذ يقدّم لقارئه معطيات تساهم في فهم الواقع الاجتماعي العربي بتجلّياته السياسية والدينية والاقتصادية. فتصورات الأنظومتين الدينيتين المسيحية والإسلامية لهوية الإنسان لها الأثر البالغ في قرائن تصرفات أهل الإيمان التاريخية والثقافية. تنعقد هذه الهوية في المسيحية على مقولة «الابن» وفي الإسلام على مقولة «الخليفة»، وبين المقولتين «شَبَه صريح» و«فارق خطير» لهما أثر مباشر على أنماط تدبّر شؤون المدينة الإنسانية.
لهذه المقارنة خلفيات عدّة، تثني القارئ عن الإذعان بحلول سهلة تؤطّر المفاهيم في نظرات أحادية للأمور. على المستوى الثقافي، يجب تجنب اختصار الثقافة العربية بالإسلام أو بمعضلاته الآنية والحضارة الغربية بالمسيحية أو بالعلمانية. إذ إنّ واقع تلاقح الحضارات يحثّ على التبصّر الحصيف بلطائف التباينات الحضارية التاريخية. أمّا على صعيد تناول منطق الأديان التوحيدية، فيجب التحرّي بأمانة عن تحديدها للهوية الإنسانية المنعقدة على مفهوم الكشف الإلهي الذي يبلّغ الإنسان حقيقة الله وحقيقة ذاته. يرفض عون منطق الاستئثار بالحقيقة ونبذ الغيرية، فيدعو إلى التعددية الدينية التي تقوم على التمييز بين الذات الإلهية وما ينكشف عن هذه الذات عبر الاختبارات الثقافية والإنسانية: «فالله أكبر من جميع ما ينسجه الناس في مداركهم اللاهوتية».
عمق التصوّرين الأنتروبولوجيين مبني على تعاليم الديانتين الأساسية. مقولتا الرؤيا المسيحية للكون وللوجود وللتاريخ هما الظهور الإلهي وتألّه الإنسان. بظهوره للإنسان، يكشف الله عن ذاته كواحد في الطبيعة ومثلث في الأقانيم. ويبلغ الكشف ذروته في المسيحية عبر تجسد الابن، الذي يؤلّه الإنسان ويجعله ابناً وارثاً. أمّا الإسلام، فإنّه ينظر إلى الله نظرة التسامي المطلق ويرد كلّ شيء إلى الوحدة: وحدانية الله الأوحد، ووحدة الإيمان والخليقة والجماعة. هذا يضع الله والإنسان في وضعية الخالق والمخلوق، ويستبعد كلّ علاقة قربى بينهما. فلا تألّه للإنسان واشتراك في الحياة الإلهية التي يعجز عن تصورها، بل هداية إلى الصراط المستقيم. وعليه، لا بلاغ عن الله إلا من لدن الله، كلمته الأزلية، القرآن. يظهر ذلك الإنسان كأداة في يد الله، خاضعاً له خضوعاً تاماً. وفيما يكشف الله في المسيحية عن ذاته الإلهية عبر ابنه، يكشف في الإسلام فقط عن إرادته، عبر القرآن.
لهذه المفارقات التأسيسية تأثير مباشر على واقع تدبر شوون المدينة. فالله يعهد إلى الابن، في المسيحية، «استنباط الشرائع والسنن والأحكام من مصدر النور الإلهي المبثوث في مطاوي الضمير الإنساني». فتسمح الحرية المسيحية للإنسان بدائرة وجود خاص، كما أنّ الثالوث يتيح لكلّ من أقانيمه بدائرة وجود خاص. أمّا الإسلام، فيعتقد أنّ «من مسؤولية الاستخلاف تنبثق ضرورة الأمانة في رعاية الخليقة وفاقاً لسنن الله». لذلك، لا يشترك الإنسان في الحياة الإلهية، بل يبلغ، كخليفة، المشيئة الإلهية، ما يجعل حريته «مشروطة بالهداية القرآنية». سياسياً، تترجم تباينات النظرتين بإنسان المسيحية الذي يشترع، على ضوء إيمانه، القوانين التي تلائمه، كابن شريك في الخلق، وفي الإسلام، بإنسان عليه أن يتبع ما تتضمنه الشريعة من تدبير لشؤون المدينة. لطائف هذه التباينات شديدة الأهمية لفهم سلوك الديانتين السياسي، لأنّ «تصوّر الهوية الإنسانية شرط أساسي لتصوّر هوية الفعل الإنساني».
يتابع عون مقارنته الأنتروبولوجية بالتكلم على أسس مشتركة تجمع الديانتين، وأهمها مخلوقية الإنسان. ولكن الاختلاف الأنتروبولوجي يؤول إلى نظرتين مختلفتين في ماهية الأخير. فالمسيحية تقول بارتباطه بالله ارتباط الغصن بالكرمة، وبخلاص يؤلّه، وبنعمة المسيح التي تبرر الخاطئ من خارج الدائرة التاريخية. أمّا الإسلام، فينظر إلى علاقة الإنسان بالله علاقة الجابل بجابله، وينظر إلى الإنسان المهدي كإنسان التقيّد بالهدى الإلهي القرآني من داخل التاريخ. وإن قالت الديانتان بانفتاح الإنسان على الحق الإلهي، يبقى الفرق كبيراً بين علاقة قائمة على المحبة والاتحاد وعلاقة قائمة على الرحمة والطاعة.
تبلغ المقارنة ذروتها عند تناول مسألة الحرية، واليقين «الأقوى المبثوث في مطاوي هذا الكتاب يعتمد الحرية كأصل من أصول الاختلاف في النظرة إلى الفعل الإنساني». ففيما تظهر الحرية في المسيحية كموقف الإيمان الحر، هي في الإسلام تسليم واثق للمشيئة الإلهية وسلوك في سبيل الرشد. تساعد القراءة الثقافية الدينية على فهم معنى الحرية العميق، إذ إنّ اللغة العربية تحددها كعبادة لله، والغرب يفهمها كقائمة على الإرادة الذاتية. أضف إلى ذلك أنّ الإيمان في الإسلام أمانة وفي المسيحية إبداع. لهذا التباين أثر مباشر على اختلاف العقل التشريعي الإسلامي المبني على القرآن عن العقل التشريعي المسيحي المبني على استقلالية الشؤون الزمنية وعلى قيمة الواقع البشري الذاتية. ينتج من ذلك حرص في المجتمعات الإسلامية، من قبل الخليفة، على حقوق الله وأحكامه، وحرص في المجتمعات المسيحية، على حرية الابن. هذا لا يعني أنّ الإسلام لا يراعي مسألة الحرية والمسيحية لا تراعي مسألة حقوق الله. ولكن التشريع في المسيحية مسؤولية ضميرية على الابن الوارث، وفي الإسلام، هو مبني على الشريعة القرآنية. لذلك مُيّز في المسيحية بين الحقلين المدني والديني.
لا تستقيم هذه المقارنة إلا بإسهام الفكر العلماني الذي يغني الإشكالية ويرى أصل الإنسان في ذاته ويبعد كلّ معنى خارج عن التاريخ. يساعد هذا الإسهام على التمييز بين المسيحية والإسلام، حيث الحرية تابعة للمقولة الأصلية التي هي الحقيقة الإلهية أو الحق، وبين الفكر العلماني المحايد، حيث الحرية هي المقولة الأصلية، والحق والحقيقة هما المقولتان التابعتان. يتناول الفصل الأخير من الكتاب مسألة إمكان التلاقي بين هذه النظرات الثلاث. تتخطى المقارنة حدود الإسلام والمسيحية، وتصبح المقارنة ثلاثية تبحث عن إمكانات إسهام الأنظومات المختلفة في «تطلب الأمثل للإنسان». يرفض عون اعتبار الاختلاف في التصوّر الأنتروبولوجي كطريق مسدود، بل يعتبره دلالة على «التنوّع الأصلي اللصيق بالطبيعة البشرية». الأرضية المشتركة واضحة المعالم: «للإنسان كرامة كيانية لا يجوز التفريط بها على وجه الإطلاق». الإسلام والمسيحية يضعان هذه الكرامة في دائرة الإلهيات، أمّا العلمانية فتضعها في ذات الإنسان. والأمر سيان في مسألة الحرية. ولكن في كل الحالات تبقى مسؤولية الإنسان كبيرة وإن اختلفت مصادر الأصول الأخلاقية. لذلك، يجب أن تتعاون الأنظومات الثلاث للنضال في سبيل الإنسان وأن تعتبر «الاختلاف الفكري أصلاً من أصول ثراء الإرث الحضاري الإنساني الكوني»، وأن تجد قيماً مشتركة وفعلاً سياسياً يسهمان في سلام الحضارات والتعدد الكوني. يقترح المؤلّف مبادئ لهذا النضال المشترك ويحددها: «قيم المساواة والحرية والأخوة والعدل والسلام والتكافل».
ينتظر مشير عون من الفكر العلماني المحايد أن يكون فسحة لقاء للنظرات الأنتروبولوجية المختلفة، وخاصة أنّه «الأحرص على الحياد في تصوّر الهويّة الإنسانيّة». فهل تقبل الأنظومات الدينية بأن تسهم الأنظومة العلمانية في فهمها لعمق ذاتها؟
(تعقد «الحركة الثقافية ـــ أنطلياس» ندوة في التاسع من كانون الأول حول هذا الكتاب، يناقشه فيها المطران جورج خضر والدكتور وجيه قانصو)
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 01.12.2010
Imam à Drancy et président de la Conférence des imams de France, Hassen Chalghoumi veut réconcilier la France et l’islam.
Pour l’islam de France, Hassen Chalghoumi, éditions Le Cherche-Midi.
Hassen Chalghoumi est un imam controversé dans les milieux musulmans de France, jusqu’au sein de sa propre communauté à Drancy (Seine-Saint-Denis). Prôner le dialogue judéo-musulman, s’opposer au port de la burqa, dénoncer l’influence des Frères musulmans et plaider en faveur d’un « islam français républicain » ne font pas forcément l’unanimité.
Pour l’islam de France est un ouvrage qui mêle autobiographie et débat d’idées. Mieux travaillé et écourté, son message aurait sans doute gagné en clarté et le lecteur aurait pu s’épargner les nombreuses répétitions et les longs développements qui rappellent un certain style oral oriental. Toutefois, notre « imam républicain de France » avance certaines propositions qui méritent d’être examinées.
INTÉGRATION
Chalghoumi s’assigne la double tâche de « faire sortir de la mosquée tout ce qui nuit à l’islam et aux Français » et de « faire rentrer la mosquée dans le troisième millénaire et l’intégrer dans la conscience tranquille de notre France ». L’imam-type, « citoyen de la République » et autorité morale, y joue un rôle central et s’oppose aux « imams de la haine ».
Cette intégration passe par deux médiations principales : la condamnation d’un islam « obscurantiste » et le rapport nouveau avec la République. L’islamisme reçoit toutes les foudres de l’imam drancéen qui s’attaque en particulier à l’Iran, aux Talibans et à certaines « ambassades ». Localement, Chalghoumi accuse l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), issue de la mouvance des Frères musulmans, d’être source d’extrémisme, d’islamisme, d’affairisme, de propagande et de manipulation de la femme…
Opposé au port de la burqa, l’auteur s’appuie sur le Coran pour plaider en faveur de l’égalité des sexes et écarter la polygamie. Ainsi, un « islam de France » devrait naître, fruit d’un effort commun de l’islam et de la République : « Que l’État sécurise le culte musulman et que les musulmans sécularisent leur religion. »
OUVERTURES
Deux ouvertures majeures sont à relever : le dialogue interreligieux et la relecture de la foi. L’auteur, impliqué dans le dialogue judéo-musulman et surnommé par ses détracteurs « l’imam des juifs », condamne fermement l’antisémitisme et refuse d’amalgamer les occupants de la Palestine et les juifs de France.
Le dialogue entre les religions devrait s’effectuer localement, sans dépendre uniquement du passé ou des évènements du Moyen-Orient. Les propositions « dogmatiques » de Chalghoumi s’éloignent quant à elles un peu du discours sunnite traditionnel. En plus de plaider pour la liberté de conscience et de formuler un balbutiement de pluralisme théologique (« un Dieu, plusieurs Messagers »), l’imam évoque la contextualité de l’islam : « Universel, il est valable partout, mais dire qu’il ne doit s’adapter à aucun lieu ni à aucune culture est du pur délire ».
Cet ouvrage avance donc des idées intéressantes. Mais, encore une fois, l’argumentaire aurait mérité d’être resserré et moins manichéen. Il aurait aussi gagné à s’appuyer sur des références religieuses musulmanes contemporaines faisant autorité.
Antoine Fleyfel
25.11.2010
مسيحيّو لبنان والشرق: كفانا بكاءً على الأطلال

يضيق بي المقام هنا إن وددت التكلّم على كل محاولات استنهاض مسيحيي لبنان والشرق وإنقاذهم. فالمؤتمرات والندوات والكتابات والتجمعات واللقاءات والخلوات والتحركات، لا تني استثارة أوضاع المسيحية المشرقية وأفولها أو تراجع حضورها في كثير من الأقطار العربية. فالتقاسيم تتنوع والنغمة واحدة: خطر الزوال، اضمحلال الشهادة، إعادة تفعيل الدور، النزف الديموغرافي، الإحصاءات العددية، تضاؤل الإسهام الحضاري والثقافي، أخطار الأصوليات المتنامية، قرائن المصالح الإقليمية والدولية. لا شك بأن الكثير من هذه المعطيات تعبّر عن واقع أليم معيش. ولا ريب أن البحث العلمي الحصيف ضروري للتبصّر في أنجع سبل التلاقي الإنساني والعيش في المدينة. ولكن المشكلة هي في طريقة تناول إشكالية الحضور المسيحي العربي، وفي الأكثرية الساحقة من المحاولات التي ينتهي غالباً دورها مع انتهاء آخر محاضرة، فتوضع النصوص على رفّ مكتظّ بالكتب والملفات والغبار.
يندرج السينودس المنعقد الآن في حاضرة الفاتيكان من ضمن المحاولات الرامية إلى تحسين أوضاع المسيحيين والمسيحية في المشرق. لا شكّ أنّ عدداً من ذوي النيّات الحسنة والقدرات العلمية والمزايا الإنسانية والأخلاق الإنجيلية موجودون في صفوف هذا الجمع الإكليريكي الذي يفتقر أشد الافتقار إلى حضور النساء والعلمانيين والأشخاص المتزوجين، ولا ريب أنّ بعض المداخلات والأفكار لا تخلو من الحكمة والقراءة الفذة للواقع. ولكن الكثير من المؤشرات تحثّ المراقب على عدم انتظار أي نتيجة عملية ومحسوسة من هذا السينودس. فنحن بعيدون كامل البعد عن واقع سينودسات تحدث تغيرات كبيرة، كذلك الذي انعقد في أميركا الجنوبية في مدينة مدلين عام 1968 والذي ولد من رحمه لاهوت التحرير الذي واجه الفقر واللاعدالة الاجتماعية ووقف بوجه الرأسمالية والروح الاستعمارية الحديثة للغرب. ولربّما تكون هذه أول إخفاقات هذا السينودس الفاتيكاني في أنّ همّه يصيب بالأساس أحوال فئة مذهبية واحدة من المجتمع العربي، وكأنّ الفقر، والصهيونية (وهي لم تفرّق بين مسلم ومسيحي فلسطيني)، والإرهاب (وقد تأذّى منه المسلمون أكثر من المسيحيين في العراق)، والسياسة الغربية (وقد رأينا كيف حافظت الدولة المسيحية العظمى، الولايات المتحدة، على المسيحيين في العراق)، والظلم الاجتماعي، والحالة الاقتصادية المتردية، والهجرة، والجوع، والكثير من العوامل الأخرى التي تغرّب الإنسان عن ذاته، وكأنّ كل تلك تميّز بين مسيحي ومسلم. فمن يجب إنقاذه في الشرق العربي؟ أهو المسيحي والطائفة أم هو الإنسان؟ وهل أخطار الأصوليات الدينية والهجرة أعظم شأناً من أخطار الجهل والانطواء على الذات والتخلف؟ وعليه، فإنّ أسباباً كثيرة تدفع بنا إلى الشك بقدرة هذا السينودس على الإتيان بنتائج عملية، نذكر منها ثلاثاً:
أوّلاً، من الصعب الإذعان بفعالية مبادرة كنسية تخص مسيحيي المشرق، وتنعقد على نحو أحادي في ديار الكنيسة اللاتينية في الفاتيكان، وخارجاً عن الشرق. ربّما أراد هذا العهد البابوي أنّ يؤكد، من ضمن سياسته التقليدية، محورية «خلافة بطرس» حتى في أرض العرب، ولكن من النافل التصديق أن سينودساً لا يضم كل المسيحيين العرب، وأغلبهم من غير الكاثوليك… سينودساً لا يقوم على أرضنا المتألمّة، يمكنه أن يأتي بحلّ ما. فمكانة «كرسي بطرس» ما زالت موضع إشكاليات كبيرة لدى الكنائس الأرثوذكسية، وهي تمثّل الأغلبية في الشرق الأوسط. فعدد من مسؤولي هذه الكنائس يتساءلون كيف يمكن سلطةً كنسيةً كانت مسؤولة عن إحداث الانشقاقات في كل الكنائس الشرقية وإضعافها، أن تضطلع بحل ما، وهي ما زالت تعتبر نفسها كالتجسيد الكامل الوحيد لكنيسة المسيح.
ثانياً، كيف يمكن أن تستقيم أوضاع المسيحيين المشرقيين وهم لا يجلسون معاً ولا يبحثون عن سبل الاستقامة. هل بلغ قسط منهم حالة استقالة وجودية متقدمة تقودهم لشلل ذاتي يوجب قيام مبادرات غربية لاستنهاضهم؟ هل كُتب على أبناء هذه الأرض أن يُعتبروا أو أن يَعتبروا أنفسهم قاصرين وموصى عليهم حتى في أمورهم الدينية؟ إن أراد المسيحيّون المشرقيون الشهادة والدور والوجود الحر، فالحلول المناسبة ليست موجودة في روما، ولكن في اجتماع كل الكنائس في الشرق، من دون استعلاء أي واحدة على الأخرى، وبروح وطنية وإنسانية، بعيداً عن الطائفية والتقوقع الديني. ربّ قائل إن أحوال مجلس كنائس الشرق الأوسط سيّئة جداً، وإنّ العلاقات بين بعض الكنائس متوترة، وهذا كلام فيه نظر. ولكن إن أرادت الكنيسة الكاثوليكية أن تضطلع بدور إنقاذي في الشرق، فهنا فرصتها، إذ إنّ الأمين العام المقبل لمجلس كنائس الشرق الأوسط عليه أن يكون، بحسب قانون المداورة، كاثوليكياً. فالتحدي الحقيقي للكنيسة الكاثولكية ليس في روما حيث كل المجتمعين كاثوليك أو تقريباً، ولكن في أرض العرب، حيث اجتماع كل الكنائس وأغلبها رسولية وعريقة، أقلّه بقدر عراقة كنيسة روما.
ثالثاً، إنّ الغائب الأكبر الوحيد ليس فقط الشريك المسيحي غير الكاثوليكي، ولكن أيضا الشريك المسلم. فوجود بعض المسلمين الحسني النية في السينودس لا يعني حضور الفريق الذي يتشارك معه المسيحيون المشرقيون الحياة والمصير. فهل من آفاق للمسيحيين في الشرق من دون المسلمين؟ وهل من حل ممكن لمعضلات المسيحية العربية من دون أن يشارك المسلم في صياغة لهذا الحل؟ لا جرم أنّ غياب المسيحيين غير الكاثوليك وغياب المسلمين عن اجتماع يخصّ المسيحيين المشرقيين هو خير مؤشر على أنّ هذا السينودس لن يكون أكثر من أنشودة جميلة تنشد، وتفسح المجال بعد قرع أوتارها إلى صمت الواقع.
لن تنقذ روما مسيحيي الشرق، وقد رأينا النتائج غير المرضية لزيارة أسقف روما في العام المنصرم على أحوال مسيحيي الأراضي المقدسة الذين ما زالوا يعانون، كما إخوتهم المسلمون، من تصرفات الاحتلال الصهيوني. ولن يُنقذ الغربُ مسيحيي الشرق، وهو مسؤول عن الكثير من ويلاتهم. لن ينقذ المسيحيين في الشرق إلا المسيحيون الشرقيون أنفسهم، عندما سيجلسون معاً، في الشرق، مع شركائهم المسلمين والعلمانيين، بروح مسكونية وحوارية. وحينها، عندما يكفون عن البكاء على الأطلال، وعندما يلتزمون كل قضايا الإنسان العربي الحقة، بعيداً عن التمييز الديني والطائفي، ونصرة للفقير وللمظلوم، أياً كان، وبحثاً عن الإنماء الاجتماعي، والحضور الثقافي، والالتزام الوطني العلماني، حينها سيضحي وجودهم ضرورة حياة للشرق، حينها سيكونون فعلاً كما يريدهم سيّدهم، ملحاً للأرض ونوراً للعالم.
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 23.10.2010
Sur fonds de problèmes financier, structurel et identitaire, auxquels viennent s’ajouter des tensions entre les Églises copte et grecque-orthodoxe, le Conseil œcuménique des Églises du Moyen-Orient (CEMO) traverse actuellement une crise majeure. Simple essoufflement institutionnel ?
Le 28 avril 2010, Guirgis Saleh (copte orthodoxe), secrétaire général du Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO), élu pour un deuxième mandat de 4 ans en 2007 comme représentant de la famille orthodoxe orientale, annonçait aux chefs des 27 Églises membres la décision de son Église de quitter le CEMO.
Le pape Chenouda III, chef de l’Église copte orthodoxe, avait pris cette décision en réaction aux « insultes » adressées à un évêque copte, Anba Bishoy, membre du conseil exécutif du CEMO et Secrétaire du Saint Synode de l’Église copte orthodoxe. En se retirant du CEMO, l’Église copte orthodoxe laisse un grand vide, puisque presque deux-tiers des chrétiens vivant au Moyen-Orient sont des fidèles de cette Église.
De quelles « insultes » parle-t-on ici ? Lors d’une réunion du conseil exécutif du CEMO, à Aman en Jordanie le 20 avril 2010, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, aurait jugé que Guirgis Saleh « paralysait l’effort œcuménique » et lui aurait demandé de démissionner. Expliquant que le Conseil était devenu un « club privé » copte, le patriarche aurait aussi accusé l’évêque Bishoy de manquer de « loyauté et de dévouement » à la cause du CEMO.
Les tensions entre les deux Églises, copte et grecque-orthodoxe, ne sont pas nouvelles. Guirgis Saleh rejette quant à lui ces accusations et considère les revendications de Théophile III comme illégales. Il explique par ailleurs que le patriarche grec de Jérusalem s’était absenté en 2009 d’une réunion très importante, et avait déjà envoyé une lettre demandant la démission du conseil financier et du secrétaire du CEMO. Ambiance…
Fondé en 1974, le CEMO est la seule instance œcuménique au monde dont l’Église catholique est membre (depuis 1990). Son règlement intérieur stipule : « Le Conseil est composé des quatre familles ecclésiales du Moyen-Orient : orthodoxe, orthodoxe orientale, évangélique et catholique, lesquelles croient en Jésus-Christ comme Dieu et sauveur selon les Écritures. […] Le Conseil tire ses pouvoirs des Églises chrétiennes membres réunies et ne se considère pas comme organe suprême les supplantant » (art. 3, 2).
HERETIQUE
Vingt-sept Églises (26 actuellement) constituent le CEMO (Voir document joint). L’Église assyrienne, dite des deux conciles, est la seule Église orientale qui ne fut jamais admise au Conseil à cause du refus des coptes. Ces derniers considèrent, depuis le Concile d’Éphèse en 431 et la – tristement – célèbre querelle entre Cyrille d’Alexandrie et Nestorius, que l’Église assyrienne demeure « hérétique ».
Un dialogue théologique a eu lieu au niveau du CEMO en 1990, ce qui était une avancée considérable, et les catholiques voulaient introduire les Assyriens dans leur famille puisqu’il était impossible administrativement de créer une cinquième famille. On était sur le point d’aboutir à une solution, mais au dernier moment, les positions se sont confessionnellement durcies.
Le CEMO a vu le jour dans un contexte très problématique. La guerre libanaise (1975) l’a par exemple obligé à déplacer ses bureaux de Beyrouth à Chypre pendant presque vingt ans, la guerre israélo-palestinienne, les régimes totalitaires, les tensions religieuses et confessionnelles, une région traditionnelle et pauvre, la guerre irako-iranienne, l’occupation du Kuwait, les deux guerres du Golf, les deux intifada n’ont pas non plus facilité les choses.
Ainsi, dès sa naissance, le CEMO a du relever beaucoup de défis. Et il y a souvent réussi. Au niveau du dialogue de charité, une grande et rapide avancée a eu lieu et le Conseil a joué un rôle très important pour établir des relations fraternelles : il a été un espace pour la rencontre des Églises, laquelle s’est traduite par des réussites dans les domaines spirituel et humain.
Le CEMO s’est engagé pour la cause palestinienne, pour la reconstruction du Liban, pour l’urbanisme des régions défavorisées, pour les droits de l’homme (et ceux de la femme !), pour les chrétiens en Irak, etc. Mais au niveau théologique, rien de très innovant n’a eu lieu excepté le dialogue mené entre l’Église assyrienne et l’Église copte orthodoxe en 1990 évoqué plus haut. À part cela, plusieurs formations et recherches théologiques comparées ont eu lieu, ainsi que des études pour parler de la Trinité aux musulmans et la rédaction de textes éthiques sur le dialogue avec l’islam, le respect et l’acception de l’autre.
Trois problèmes ont gravement nuit au CEMO ces dernières années : un problème financier, un problème structurel et un problème identitaire. Comme le Conseil Œcuménique des Églises (COE) et beaucoup d’organisations œcuméniques, le CEMO a subi les conséquences de la crise financière mondiale récente. Il n’a plus de ressources, parce que les « partenaires » qui le subventionnent ont décidé d’arrêter de le financer. Ceux-ci sont principalement des Églises et des organisations réformées originaires des pays germaniques et nordiques. Les Églises membres payent seulement des abonnements symboliques qui n’ont jamais dépassé les 2% du budget total (certaines n’ont même jamais payé). Les partenaires voulaient que les Églises assument au moins 10% des charges financières. Structurellement, un surplus d’employés a étouffé le Conseil (88 employés avant les restrictions récentes pour un peu plus d’un million de dollars de budget).
CRISE IDENTITAIRE
Quant à la crise identitaire, elle est encore plus grave que le problème financier qui ne paralyse qu’extérieurement, puisqu’elle ébranle la raison même de l’existence du conseil. Un haut responsable du CEMO témoigne :
« Le Conseil n’existe pas sans les Églises à qui il a beaucoup donné. Mais que lui ont-elles donné en retour ? Elles lui ont souvent donné des gens incompétents, elles lui ont infligé de dures conditions par des comportements plus communautaires qu’ecclésiaux, elles ne l’ont pas aidé financièrement lorsqu’il y a eu une crise, elles ont récupéré les partenaires pour leurs projets personnels. Si chacune des Églises opte pour un œcuménisme particulier, à quoi bon ? Est-ce que les Églises sont prêtes à se sacrifier quelque part au service de l’œcuménisme et de la collégialité ? ».
Certains préconisent de redéfinir l’identité du CEMO de manière à bannir tout recroquevillement confessionnel et de remettre la collégialité au centre des préoccupations. Il faudrait, dit-on encore, que les Églises prennent conscience de leur mission qui ne se résume pas par une survie du christianisme oriental, mais à un témoignage commun du Christ. C’est pour cela que le Conseil serait un besoin et que les Églises ne peuvent pas s’engager dans l’œcuménisme sans lui puisqu’il est justement le signe de leur collégialité et de leur unité espérée.
Le même responsable du CEMO ajoute que « le Conseil ne peut plus continuer comme il était, parce qu’il a perdu son efficacité, il a été dépassé. Il nous faudrait un Conseil qui rende la collégialité aux Églises, parce que lorsqu’elles sont ensemble, elles sont plus fortes et leur témoignage est plus puissant. Il faudrait que les Églises l’appuient moralement et financièrement. Elles doivent choisir la collégialité et non le renfermement. Il est exigé des chefs des Églises un grand éveil et du courage. Il faut que les partenaires regagnent confiance ». La responsabilité des Églises catholiques est très grande à tous ces égards l’année prochaine, parce que ce sera à leur tour d’offrir au Conseil un nouveau secrétaire.
Pas de doute, donc : l’œcuménisme au Moyen-Orient traverse une épreuve décisive. Les Églises orientales sauront-elles la traverser ensemble, sans attendre d’hypothétiques avancées au niveau mondial ? Oseront-elle prendre l’initiative, pour un jour abandonner leurs vieilles querelles et devenir enfin cette Église des Arabes tant attendue, témoin de l’amour du Nazaréen sur une terre qui ne cesse de souffrir ?
Antoine Fleyfel
18.10.2010
Tous les christianismes moyen-orientaux antiques et un certain nombre d’Églises occidentales sont représentés au Liban. Cela fait du Pays des Cèdres une terre qui possède l’une des plus grandes densités œcuméniques au monde.
Les querelles dogmatiques – notamment christologiques – plus que millénaires, sources des plus grandes divisions entre les chrétiens durant des siècles, sont aujourd’hui dépassées. Pour autant, les relations entre les différentes Églises demeurent complexes. Trois ecclésiastiques locaux, Mansour Labaky (1), Paul Rouhana (2) et Gabriel Hachem (3) nous ont aidés à y voir plus clair.
PÂQUES
Sur le plan pastoral et humain, la diversité chrétienne au Liban est vécue positivement. Le brassage entre communautés est très fort, notamment grâce aux écoles et aux mariages mixtes. Depuis la guerre du Liban, on parle d’un « camp chrétien », solidaire face à plusieurs défis communs sur les plans social, politique et culturel.
« Il est de la plus grande importance, explique Paul Rouhana, de développer l’œcuménisme pastoral. Toutes nos Églises sont apostoliques, elles ont beaucoup de choses en commun : le sacerdoce, la Bible, la liturgie… On vit ensemble sur cette terre. »
Mansour Labaky assure dans le même esprit « qu’au quotidien, il n’y a aucune différence entre les chrétiens ». La logique des systèmes ecclésiastiques, en revanche, réaffirme régulièrement les distinctions. Pour peu que le dialogue théologique et le droit canonique stagnent, les croyants, qui ignorent les raisons des divisions ecclésiales et les « boucheries théologiques », selon l’expression de Mansour Labaky, peuvent donc se retrouver en porte-à-faux.
Le besoin d’une pastorale œcuménique concrète du mariage et de la catéchèse se fait particulièrement sentir. Paul Rouhana évoque aussi un problème emblématique qui scandalise beaucoup de chrétiens locaux : la date de la fête de Pâques, différente selon les calendriers retenus par les Églises :
« À la suite de Vatican II, les catholiques orientaux ont théoriquement le droit de décider de fêter Pâques en même temps que les autres chrétiens. Malheureusement, depuis 45 ans, rien n’a été fait en ce sens. Le blocage est patent. Il n’y aurait pourtant pas de mal à ce que les catholiques fêtent Pâques en même temps que les orthodoxes. Le christianisme libanais aurait besoin de quelques initiatives de ce genre. »
Gabriel Hachem souligne lui aussi l’importance de l’œcuménisme pastoral et rappelle qu’un « niveau très intéressant concernant les protocoles pastoraux a été atteint. Le dernier a été signé en 1996 ( les accords de Charfeh (4) ) et portait sur les mariages mixtes, sur le catéchisme œcuménique commun et sur l’identité confessionnelle des enfants. » Depuis… rien.
Sur le plan théologique, les Églises du Liban « sont d’abord des petites entités qui dépendent d’autres Églises mondiales », précise Paul Rouhana. Elles ne peuvent que répercuter des décisions qui sont prises à un niveau supérieur. Leur principale contribution au dialogue œcuménique se manifeste par la présence de théologiens libanais au sein de certaines commissions théologiques internationales.
Gabriel Hachem évoque certaines initiatives locales, comme les échanges de professeurs, de bases de données de bibliothèques et de revues entre les facultés de théologie. Les Églises orientales catholiques sont quant à elles pour l’essentiel soumises aux décisions romaines.
Le Conseil des Églises au Moyen-Orient (CEMO), la seule instance œcuménique au monde dont l’Église catholique est pleinement membre, souffre par ailleurs de problèmes financiers, structurels et spirituels, ce qui ne facilite pas les choses. Gabriel Hachem rappelle que lorsque ce Conseil a été fondé en 1974, « l’espoir était qu’on puisse s’engager à un niveau local dans un dialogue théologique œcuménique qui contribuerait au progrès du dialogue international ».
Un espoir déçu, apparemment. Car si le mouvement œcuménique semble avancer rapidement au niveau des rencontres et de ce qu’on appelle le « dialogue de charité », les freins s’enclenchent très vite lorsqu’on aborde les questions doctrinales : « C’est à ce moment-là qu’on a tendance à se replier sur son identité confessionnelle, et c’est là qu’on a l’impression qu’il y a une stagnation œcuménique. »
Entre rencontre concrète allant de soi et rapports théologiques limités, les Églises du Liban vivent donc une situation paradoxale. Le temps des concessions au service du « ministère de l’unité » ne serait-il pas venu ? Gabriel Hachem s’avoue sceptique : « Les chefs des Églises ne sont pas prêts à ce genre de démarche qui exige beaucoup de courage. »
MARONITES
L’Église maronite (catholique) est le partenaire principal de toutes les Églises au Liban, non seulement parce que le plus grand nombre de chrétiens libanais sont maronites, mais aussi en raison du grand rôle politique qu’elle continue de jouer. Si elle ne fournit pas actuellement de contribution significative dans le cadre du dialogue théologique œcuménique, elle essaie tout de même de repenser sa situation à la lumière des défis qu’affrontent ensemble tous les chrétiens libanais.
Ces défis se résument surtout à des mutations religieuses souvent inquiétantes et à des problèmes d’émigration chrétienne accélérée, d’économie et d’instabilité politique. Deux grands événements incarnent la réflexion qu’a entamée l’Église maronite ces deux dernières décennies : le Synode pour le Liban qui a été réuni à son initiative et qui s’est clôturé par l’Exhortation apostolique pour le Liban de Jean-Paul II en 1997, et le Synode patriarcal maronite (5) en 2006.
« L’Exhortation apostolique pour le Liban, analyse Paul Rouhana, incarne une prise de conscience après la guerre. Il fallait tendre la main aux musulmans. Le Synode s’inscrit dans cette ligne. »
Ces deux événements rendent les « chrétiens du Liban beaucoup plus fort lorsqu’ils parlent. On sent qu’il y a un discours qui commence à s’entendre chez eux, un discours de rationalité, un discours de réalisme, un discours d’acceptation de l’autre, de dialogue et de convivialité ». Gabriel Hachem salue lui aussi l’entreprise synodale mais s’interroge sur sa réception concrète, aussi bien par le clergé que par la population en général.
PROPHÈTES
Les Églises du Liban sauront-elles s’impliquer d’avantage dans une entreprise œcuménique et interreligieuse audacieuse qui inaugurerait une nouvelle ère de présence et de témoignage ? C’est l’une des grandes questions du moment. Les chrétiens orientaux et les assemblées qui se réunissent ces temps-ci savent qu’il leur faudra y répondre. Reste un autre problème, bien réel, que souligne Paul Rouhana : « Il n’y a plus de figures charismatiques susceptibles de porter efficacement ces idées. » Et Mansour Labaky de confirmer : « Nous n’avons plus de prophètes maronites.»
———————————————————
1. Chorévèque maronite, auteur de plus de 200 hymnes chantées par tous les chrétiens orientaux à travers le monde et fondateur de plusieurs associations religieuses, dont Lo Tedhal.
2. Moine maronite, spécialiste en œcuménisme et doyen de la Faculté Pontificale de Théologie à l’Université Saint-Esprit de Kaslik.
3. Prêtre grec-catholique, spécialiste en œcuménisme et responsable au Conseil des Églises du Moyen-Orient.
4. « Accord catholique-orthodoxe sur trois questions pastorales importantes (Charfeh, 1996) », Les lieux de communion, Jean Corbon, éd. Cerf, 2009, p. 637-648.
5. Site web du Synode : http://www.maronitesynod.com
Antoine Fleyfel
14.10.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 7
خاتمة: العلمانية الآتية؟

انعقدت سلسلة مقالات «العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان» على المساهمة في البحث حول المسألة العلمانية في لبنان عبر إلقاء الضوء على هذا المفهوم من زاوية الفكر المسيحي الديني في لبنان. وقد خلص هذا البحث إلى استنباط ميل هذا الفكر الواضح إلى العلمانية، نزعة تتفاوت بين الإذعان الخفر بتبني شكل من أشكال هذا المفهوم والنضال من أجل تطبيقه الشامل. يمكننا تصنيف العلمانية لدى المفكرين الذين تطرّقنا إلى فكرهم على الشكل الآتي: ميشال الحايك، الوطن اللاديني؛ يواكيم مبارك، النضال العربي الإنسانوي العلماني؛ جورج خضر، الدولة المدنية؛ مشير عون، العلمانية المعتدلة ذات الحياد المطلق؛ بولس الخوري، العلمانية المعتدلة الناقدة؛ غريغوار حداد، العلمانية الشاملة. من اللافت للنظر أنّ أشدّ النزعات العلمانيّة موجودة عند المفكرين من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك (عون، الخوري وحداد)، أما النزعة الخفرة، فهي موجودة عند المفكرين الموارنة (حايك ومبارك). فيما نجد نزعة معتدلة في الطائفة الإنطاكية الأرثوذكسية (خضر).
يجتمع هؤلاء المفكرون على أفكار عدّة ومن أهمها: نبذ الطائفية ومحاربتها والتمييز بين الدينيّات والسياسيّات. فجلي أنّ الفكر الديني المسيحي اللبناني يرفض أيّ ضرب من ضروب الدمج بين الدين والسياسة. ولكن مفكّرينا يتمايزون بنظراتهم إلى تطبيق العلمانية على صعيد النظام اللبناني. ففيما ينادي عون والخوري وحداد بإلغاء الطائفية السياسية، نلمس أحياناً عند الحايك ومبارك، وبوضوح عند خضر نوعاً من القبول بمشاركة الطوائف في الحكم ضمانةً للوجود المسيحي. ولربّما أثّر تمثيل الطوائف في الحكم بشكل ما على هذه النزعات: فالميل الخفر إلى العلمانية موجود عند الموارنة، وهم ينعمون بأعلى المراكز في الدولة اللبنانية. أمّا طائفة الروم الملكيين، فامتيازاتها أقل شأناً من امتيازات الموارنة والروم الأرثوذكس الذين ينعمون بثاني أهم المواقع السياسية بين الطوائف المسيحيّة. يبقى كل ذلك من باب الفرضيّة، وهذه الفرضية اللافتة ثانويّة لأنّه في كل الأحوال يبقى مغزى هذه النزعة العلمانيّة: تغيير سلوك سياسي ووطني يضع مصلحة الطائفة وحقوقها قبل مصلحة المواطن وحقوقه؛ ونقض عقلية تستعمل الطائفة أداة استعلاء وتنابذ وتمييز عنصري؛ وتجنّب كل شكل من أشكال الحكم باسم الله، لأنّ الشهادة لله إمّا أن تكون بمحبّة القريب، بعشق الحريّة، بالنضال من أجل كل إنسان، بالاحترام المطلق للغيريّة، وبغسل الأرجل كما يقول خضر، وإمّا ألا تكون.
اقترنت كتابة هذا البحث مع صدور النص التحضيري Intrumentum Laboris لسينودس المسيحيّين الكاثوليك المشرقيين الذي سينعقد في مدينة الفاتيكان في شهر تشرين الأوّل من عام 2010، والذي سيتناول مسألة الحضور المسيحي في الشرق وشهادته. ومن اللافت للنظر أنّ هذا النصّ يلتقي مع أحد مقوّمات العلمانية المسيحية اللبنانية الأساسيّة، ألا وهو الطبيعة الإيجابية لهذه العلمانية تجاه الأديان: «على الكاثوليك أن يقدموا أفضل ما عندهم عبر التعمّق، مع المسيحيين الآخرين وأيضاً مع المفكرين والإصلاحيين المسلمين، بمفهوم العلمانية الإيجابية». لا يقدّم لنا النص المزيد من التفاصيل عن كيفية تطبيق هذه العلمانيّة، ولكنّه يتلاقى ولا شك مع الفكر المسيحي اللبناني العلماني على مسألة العلمانية الإيجابية تجاه الأديان. إذاً يتابع النص ويتكلّم عن سبل إحلال «مساواة أكبر بين المواطنين من الديانات المختلفة، عبر العمل على تطبيق ديموقراطية سليمة، علمانيّة إيجابية، تعترف كاملاً بدور الدين في الحياة العامة، وتحترم تماماً التمييز بين الديني والزمني».
المناداة المسيحية بالعلمانية أتت من كبار أعلام الطوائف المسيحية في لبنان. ومن النافل القول إنّ هؤلاء القوم لا يأبهون بالوجود المسيحي الحر والفاعل والكريم والشاهد في لبنان والشرق. فحياتهم وفكرهم وتضحياتهم والتزاماتهم المتنوّعة هي خير شهادة على أمانتهم للدعوة المسيحية وللرسالة الإنجيلية الإنسانويّة. فالطائفية ليست قدراً على لبنان وليست شرط الوجود المسيحي الوحيد، إذ يمكن المسيحية أن تستمر بعيداً عن الطائفية وفي ظل نظام علماني ما زال يجب تحديده. وإن صدّقنا المنادين بالعلمانيّة الإيجابية، يجب علينا القول إنّ المسيحية تستعذب هذا الشكل من الحكم السياسي الذي يجعلها في حالة نقد ذاتي وتجدّد دائم وفي حوار مستمر مع الحداثة ومع ما بعد الحداثة.
نأمل أن تُغنى مسألة العلمانية في لبنان بمقالات عدة أخرى من الأبحاث الضرورية التي تستنطق النزعات العلمانيّة في الفكر المسيحي اللاديني، في الفكر السنّي والفكر الشيعي والفكر الدرزي. ولدى كل هذا الطوائف أعلام كبيرة تكلّمت إيجاباً عن العلمانية ومالت إليها أو نادت بها. نذكر على سبيل المثال ولا الحصر: لدى المسيحيين اللادينيين، نصيف نصّار؛ لدى الطائفة السنيّة، عبد الله العلايلي؛ لدى الطائفة الشيعيّة، مهدي عامل؛ ولدى الطائفة الدرزية، كمال جنبلاط.
يصرّ المنادون بالعلمانيّة على أنّها تطوّر حتمي للمجتمعات الإنسانيّة. فهل يتطوّر لبنان إلى مجتمع علماني عربي حديث؟ لا شكّ بأنّ الإشكاليّة الدينيّة السياسية في لبنان تختلف أشد الاختلاف عن الإشكاليّات التي عاشها العالم الغربي والتي أدّت به إلى تبنّي علمانيّات متنوّعة. فهذه الإشكاليّة تتمحور في لبنان حول المسألة الطائفيّة وهي إرث عثمانيّ تعود جذوره البعيدة إلى القرن السادس عشر. أشكال الحكم المتتالية التي عرفتها أرض بلاد الأرز كانت تأخذ دائماً بعين الاعتبار المسألة الطائفيّة، من فخر الدين، إلى بشير الشهابي، من المتصرّفية إلى القائمقاميتين، من لبنان الصغير إلى الجمهوريّة اللبنانيّة. ولكن، على رغم كل الشحن الطائفي الذي عرفناه في الحرب اللبنانيّة وفي المرحلة الحالية، هناك معطيات كثيرة في تاريخ لبنان الحديث تبشّر بمقوّمات عدّة لقيام علمانيّة لبنانيّة ومن أهمّها: الإجماع الوطني على مناصرة القضيّة الفلسطينيّة الحقّة في الستينيّات من القرن الماضي (إذ زالت الاعتبارات الطائفية في حينها)؛ جزء لا يستهان به من المقاومة الوطنيّة التي واجهت الكيان الصهيوني العنصري غير آبهة بالانتماء الطائفي ولكن مؤمنة بتحرير أرض مغتصبة؛ دستور وقوانين الدولة اللبنانيّة التي هي، باستثناء قوانين الأحوال الشخصيّة والأعراف، قوانين مدنيّة تطبّق باسم الشعب؛ الحركات الشعبيّة والتيّارات السياسيّة والجمعيّات والأشخاص المؤمنون بالعلمانيّة والمناضلون من أجلها، وهم من كل حدب وصوب، من كل الطوائف ومن كل المناطق؛ المفكّرون الذين نادوا وينادون بالعلمانيّة، ومنهم من التزم دينيّاً ومنهم من التزم إنسانيّاً. طبعاً هذا لا يكفي لتطبيق العلمانيّة، ولكنّه كاف للإيمان بمؤشّرات قد تبشّر بعلمانيّة آتية.
إن أتت العلمانيّة اللبنانيّة وإن أذعنّا لتطلعات المفكّرين المسيحيّين الدينيّين، فإنّها ستكون في حالة صدام مباشر مع الطائفيّة. ومن أكبر تحدّيات هذه العلمانيّة احترام خصوصيّات العائلات الروحيّة وصونها، بحيث يشعر كل مواطن بأنّه منتم لوطنه، حرّ بمعتقداته وفكره من ضمن قوانين الدولة العلمانيّة، غير آبه بمعطيات ديموغرافية أو بتتطرّفات دينيّة أو طائفيّة قد تقلق وجوده. فمحور هذه العلمانيّة سيكون الإنسان وحياته الكريمة بدلاً من الطوائف وحقوقها. فهل يصبح لبنان، وهو موجود في منطقة تستبسل في الدفاع عن حقوق الله، الوطن اللاديني (حايك) الذي يستشرس في الدفاع عن حقوق الإنسان (مبارك وعون)، كل إنسان، كل الإنسان (حدّاد)؟
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 18.08.2010
مسيح العرب (1)
المسيح هو هو لكن السؤال:
كيف يفهم المسيحيون العرب شخصه؟
“من أنا في قولكم أنتم؟” سؤال طرحه السيّد على التلاميذ، سؤال ما برح يطرح على كل المسيحيين على اختلاف الأزمنة والأقطار والحضارات والكنائس. إنّ جمالية هذا السؤال تكمن في تنوّع واختلاف الإجابات وغناها. وتولد مشكلة الإجابات عندما يثني المرء أو تثني الجماعات عن إعطاء إجابات خاصّة بها، لا بل تتبنّى إجابات لا تمت لواقعها الوجودي بصلة. إنّ من شأن هذا المقال محاولة إعطاء إجابة عربيّة عن هذا السؤال المحوري.
لا شك أن المسيح واحد، وأن السيد الذي نعبد هو هو، الأمس واليوم وإلى الأبد. لكن سرّ التجسّد يحتّم علينا عدم الانزلاق إلى جعل مفهومنا للمسيح مفهومًا شموليًا بحيث نعتبر أنّ هذه النظرة للسيّد أو تلك هي النظرة الوحيدة المناسبة والمؤاتية لكل زمان وكل مكان. فالتجسّد هو واقع إيماني يجعل من المطلق تاريخًا ومن الأبديّة زمنًا ومن الكلّية محدودًا. لم تتجسّد كلمة الله في كل الأديان وفي كل الأقطار وفي كل الأزمان، بل إنها أضحت خصوصيّة: يسوع الناصري الإنسان الذي عاش في القرن الأول، اليهودي ذو الثقافة الجليليّة… وعلى رغم جوهرية ألوهته وشموليّة الرسالة المسيحيّة، تبقى فرادته السياقيّة محطّة محوريّة لفهم رسالته. وهكذا إنّ كل محاولة فهم لرسالة المخلّص تعبر حتما بالسياق الذي منه يِحاول فهم الرسالة، سياق له فرادته الثقافيّة والتاريخيّة والجغرافيّة. فلا بلوغ إلى شموليّة الله إلا عبر خصوصيّة الإنسان. وبما أنّ خصوصيّة الإنسان متقلّبة ومتغيّرة مع تقلّب وتغيّر الزمن، ففهم شخص المسيح ورسالته متنوّع مع اختلاف السياق المعاش. فليس من مفهوم واحد أو نظرة واحدة للمسيح، والعهد الجديد هو الحجّة القاطعة على ذلك. فيوحنّا مثلاً، الذي يتكلّم عن مسيح يعلن ألوهته جهاراً يضعنا أمام مفهوم آخر عن المسيح الذي في إنجيل مرقس، ذاك الذي يجهد في إخفاء مسيحانيّته… اختلاف سياق الإنجيلين أدّى إلى مفهومين متنوّعين لمسيح واحد في كيانه.
فلنتكلّم عن مبدئ عام: لكل كنيسة ولكل ثقافة إطار يجعل من واقع فهمها لشخص المسيح ورسالته واقعًا خاصّاً بها لا يصلح بالضرورة لإطار آخر مختلف. بالتالي، على رغم كل غنى حوار الثقافات والكنائس، يبقى مفهوم روماني لاتيني لشخص المسيح مفهومًا غربيًا لا يتناسب بالضرورة مع سياق مسيحي شرقي؛ ويبقى مفهوم لاهوت التحرير الأسود لشخص المسيح في جنوب إفريقيا لاهوتًا إفريقيًا لا يتناسب حتماً مع سياق أسترالي؛ ويبقى مفهوم لاهوت الداليت لشخص المسيح مفهومًا هنديًا لا يتناسب حتماً مع سياق أمريكي. فكل محاولة فهم لشخص المسيح تنطلق إجمالاً من إشكاليّات يطرحها سياق معيّن ونادراً ما يصلح الحل المقترح لهذه الإشكاليّات إن كان من خارج السياق.
يطرح هذا المبدأ العام المذكور آنفاً إشكاليّة اللاهوت العربي في طريقة فهمه لشخص المسيح. فعندما يؤمن المسيحيّون العرب بالمسيح، بأي مفهوم يعبّرون عن إيمانهم بالمسيح وكيف يفهمون شخصه؟ مشكلتان تلخّصان مأزق اللاهوت العربي على هذا الصعيد، الأولى داخليّة والثانية خارجية.
تكمن المشكلة الأولى في مفاهيم عن المسيح ورثناها عن التقاليد الكنسية. من المؤكّد أنّ هذه المفاهيم عريقة وعميقة وجميلة وجديرة بالاحترام. لكن هذه المفاهيم لم تعد تمت للواقع الحالي المعاش بصلة وثيقة. فما يعني لاهوت الحقلة ومفهوم المسيح النابع من حراثة الأرض في عالم ندر فيه الفلاحون واتّبعت فيه الأكثريّة الساحقة نهج حياة المدن؟ وما يعني مفهوم المسيح النابع من البلاط البيزنطي الهلاني في عالم تكوينه السياسي والحضاري بعيد كامل البعد عما كان عليه في زمن القسطنطينيّة؟ وكيف تعالج كريستولوجيا المجامع المسكونيّة على أهميّتها ومحوريتها الإيمانية إشكاليّات الوجود المسيحي الحالي وشهادته في الشرق؟
فيما تكمن المشكلة الثانية في مفاهيم عن المسيح أورثنا إيّاها الغرب. أهمّها هو مفهوم المسيح المُليتَن والمُليتِن الذي يتساءل الكثيرون عن فحوى وجوده بعد مقررات المجمع الفاتكاني الثاني المتعلّقة بالكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة. هذا المفهوم المتجلّي بعبادات تقويّة غريبة عن أنتروبولوجيا الشرق وتراثه، وبنظرة كنسيّة قانونيّة لا تخلو أحياناً من فرض الذميّة على الكنائس الشرقية الكاثوليكية خاصّة تجاه جالياتها في الغرب. أمّا المفاهيم الأكثر تغرّبًا عن السياق العربي فهي في الرسوم التقويّة وفي الأفلام التي تقدّم لنا مسيحاً شكله غربي، أوروبي أو أمريكي، أشقر الشعر، فاتح العينين ووسيم يتمتّع بجسد لا يختلف كثيراً عن أجساد الرياضيين المتمرّسين.
لا شكّ أنّ وجوديّة الإنسان تحتّم نظرات مختلفة للواقع، لكن المفاهيم ما أن تخرج من التجربة الشخصيّة حتّى تضحي موضوعيّة، وتعتبر مرجعاً لفئة معيّنة من الناس يحتذون به ويعيشونه. ومشكلة مشاكل هذه المفاهيم غير الملائمة لإشكاليّات المسيحي العربي المعاصر هي في الافتراق والتناحر اللذين تسبّب بين المسيحيين. فذاك الذي يفهم شخص المسيح من خلال الكتاب المقدّس فقط والذي ينبذ لا بل يدين أحياناً مفهومًا أسراريًا لشخص المخلّص. وذاك الذي ينظر إلى المسيح عبر التراث ويرفض مفهوم المسيح المنبثق من الإكلوزيولوجيا الرومانيّة. ناهيك عن مسيح وجوده ملتصق جذريّاً برجال الدين، وهلم جرّ.
لكل هذه المفاهيم أوجه حقيقة وهي جديرة في الكثير من نواحيها بالاحترام وبأن تكون مصدر وحي لواقعنا الحالي. لكنني كمؤمن عربي غير راضٍ عن هذه المفاهيم التي لا تجيب بشكل مناسب عن تساؤلاتي الإيمانيّة والوجوديّة ولا تفي بالغرض عندما أبحث عن إجابات لواقعي التاريخي والحضاري والسياسي. ومن غير الممكن أن أحصل عن هذه الإجابات من مفهوم أوروبي أو أمريكي للمسيح، سرياني أو بيزنطي. فالمفهوم الذي يكلّمني فعلاً هو المفهوم العربي للمسيح : المسيح العربي، هذا المخلّص الآتي أبداً عبر العصور والحضارات، ذاك السيد الذي معه أتكلّم العربيّة وأتأوه بالعربيّة وأشكيه همّ وطني العربي وأسمعه عربيّاً وأرجو منه الخلاص كعربي. والمسيح الذي يكلّمني هو عربي مثلي بحمله أوزاري، مسيح عاش آلامي ومسيح سوف يحرّرني. فمن هو مسيح العرب؟؟؟
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 13.07.2008
|
|