|
|
مسيح العرب (1)
المسيح هو هو لكن السؤال:
كيف يفهم المسيحيون العرب شخصه؟
“من أنا في قولكم أنتم؟” سؤال طرحه السيّد على التلاميذ، سؤال ما برح يطرح على كل المسيحيين على اختلاف الأزمنة والأقطار والحضارات والكنائس. إنّ جمالية هذا السؤال تكمن في تنوّع واختلاف الإجابات وغناها. وتولد مشكلة الإجابات عندما يثني المرء أو تثني الجماعات عن إعطاء إجابات خاصّة بها، لا بل تتبنّى إجابات لا تمت لواقعها الوجودي بصلة. إنّ من شأن هذا المقال محاولة إعطاء إجابة عربيّة عن هذا السؤال المحوري.
لا شك أن المسيح واحد، وأن السيد الذي نعبد هو هو، الأمس واليوم وإلى الأبد. لكن سرّ التجسّد يحتّم علينا عدم الانزلاق إلى جعل مفهومنا للمسيح مفهومًا شموليًا بحيث نعتبر أنّ هذه النظرة للسيّد أو تلك هي النظرة الوحيدة المناسبة والمؤاتية لكل زمان وكل مكان. فالتجسّد هو واقع إيماني يجعل من المطلق تاريخًا ومن الأبديّة زمنًا ومن الكلّية محدودًا. لم تتجسّد كلمة الله في كل الأديان وفي كل الأقطار وفي كل الأزمان، بل إنها أضحت خصوصيّة: يسوع الناصري الإنسان الذي عاش في القرن الأول، اليهودي ذو الثقافة الجليليّة… وعلى رغم جوهرية ألوهته وشموليّة الرسالة المسيحيّة، تبقى فرادته السياقيّة محطّة محوريّة لفهم رسالته. وهكذا إنّ كل محاولة فهم لرسالة المخلّص تعبر حتما بالسياق الذي منه يِحاول فهم الرسالة، سياق له فرادته الثقافيّة والتاريخيّة والجغرافيّة. فلا بلوغ إلى شموليّة الله إلا عبر خصوصيّة الإنسان. وبما أنّ خصوصيّة الإنسان متقلّبة ومتغيّرة مع تقلّب وتغيّر الزمن، ففهم شخص المسيح ورسالته متنوّع مع اختلاف السياق المعاش. فليس من مفهوم واحد أو نظرة واحدة للمسيح، والعهد الجديد هو الحجّة القاطعة على ذلك. فيوحنّا مثلاً، الذي يتكلّم عن مسيح يعلن ألوهته جهاراً يضعنا أمام مفهوم آخر عن المسيح الذي في إنجيل مرقس، ذاك الذي يجهد في إخفاء مسيحانيّته… اختلاف سياق الإنجيلين أدّى إلى مفهومين متنوّعين لمسيح واحد في كيانه.
فلنتكلّم عن مبدئ عام: لكل كنيسة ولكل ثقافة إطار يجعل من واقع فهمها لشخص المسيح ورسالته واقعًا خاصّاً بها لا يصلح بالضرورة لإطار آخر مختلف. بالتالي، على رغم كل غنى حوار الثقافات والكنائس، يبقى مفهوم روماني لاتيني لشخص المسيح مفهومًا غربيًا لا يتناسب بالضرورة مع سياق مسيحي شرقي؛ ويبقى مفهوم لاهوت التحرير الأسود لشخص المسيح في جنوب إفريقيا لاهوتًا إفريقيًا لا يتناسب حتماً مع سياق أسترالي؛ ويبقى مفهوم لاهوت الداليت لشخص المسيح مفهومًا هنديًا لا يتناسب حتماً مع سياق أمريكي. فكل محاولة فهم لشخص المسيح تنطلق إجمالاً من إشكاليّات يطرحها سياق معيّن ونادراً ما يصلح الحل المقترح لهذه الإشكاليّات إن كان من خارج السياق.
يطرح هذا المبدأ العام المذكور آنفاً إشكاليّة اللاهوت العربي في طريقة فهمه لشخص المسيح. فعندما يؤمن المسيحيّون العرب بالمسيح، بأي مفهوم يعبّرون عن إيمانهم بالمسيح وكيف يفهمون شخصه؟ مشكلتان تلخّصان مأزق اللاهوت العربي على هذا الصعيد، الأولى داخليّة والثانية خارجية.
تكمن المشكلة الأولى في مفاهيم عن المسيح ورثناها عن التقاليد الكنسية. من المؤكّد أنّ هذه المفاهيم عريقة وعميقة وجميلة وجديرة بالاحترام. لكن هذه المفاهيم لم تعد تمت للواقع الحالي المعاش بصلة وثيقة. فما يعني لاهوت الحقلة ومفهوم المسيح النابع من حراثة الأرض في عالم ندر فيه الفلاحون واتّبعت فيه الأكثريّة الساحقة نهج حياة المدن؟ وما يعني مفهوم المسيح النابع من البلاط البيزنطي الهلاني في عالم تكوينه السياسي والحضاري بعيد كامل البعد عما كان عليه في زمن القسطنطينيّة؟ وكيف تعالج كريستولوجيا المجامع المسكونيّة على أهميّتها ومحوريتها الإيمانية إشكاليّات الوجود المسيحي الحالي وشهادته في الشرق؟
فيما تكمن المشكلة الثانية في مفاهيم عن المسيح أورثنا إيّاها الغرب. أهمّها هو مفهوم المسيح المُليتَن والمُليتِن الذي يتساءل الكثيرون عن فحوى وجوده بعد مقررات المجمع الفاتكاني الثاني المتعلّقة بالكنائس الكاثوليكيّة الشرقيّة. هذا المفهوم المتجلّي بعبادات تقويّة غريبة عن أنتروبولوجيا الشرق وتراثه، وبنظرة كنسيّة قانونيّة لا تخلو أحياناً من فرض الذميّة على الكنائس الشرقية الكاثوليكية خاصّة تجاه جالياتها في الغرب. أمّا المفاهيم الأكثر تغرّبًا عن السياق العربي فهي في الرسوم التقويّة وفي الأفلام التي تقدّم لنا مسيحاً شكله غربي، أوروبي أو أمريكي، أشقر الشعر، فاتح العينين ووسيم يتمتّع بجسد لا يختلف كثيراً عن أجساد الرياضيين المتمرّسين.
لا شكّ أنّ وجوديّة الإنسان تحتّم نظرات مختلفة للواقع، لكن المفاهيم ما أن تخرج من التجربة الشخصيّة حتّى تضحي موضوعيّة، وتعتبر مرجعاً لفئة معيّنة من الناس يحتذون به ويعيشونه. ومشكلة مشاكل هذه المفاهيم غير الملائمة لإشكاليّات المسيحي العربي المعاصر هي في الافتراق والتناحر اللذين تسبّب بين المسيحيين. فذاك الذي يفهم شخص المسيح من خلال الكتاب المقدّس فقط والذي ينبذ لا بل يدين أحياناً مفهومًا أسراريًا لشخص المخلّص. وذاك الذي ينظر إلى المسيح عبر التراث ويرفض مفهوم المسيح المنبثق من الإكلوزيولوجيا الرومانيّة. ناهيك عن مسيح وجوده ملتصق جذريّاً برجال الدين، وهلم جرّ.
لكل هذه المفاهيم أوجه حقيقة وهي جديرة في الكثير من نواحيها بالاحترام وبأن تكون مصدر وحي لواقعنا الحالي. لكنني كمؤمن عربي غير راضٍ عن هذه المفاهيم التي لا تجيب بشكل مناسب عن تساؤلاتي الإيمانيّة والوجوديّة ولا تفي بالغرض عندما أبحث عن إجابات لواقعي التاريخي والحضاري والسياسي. ومن غير الممكن أن أحصل عن هذه الإجابات من مفهوم أوروبي أو أمريكي للمسيح، سرياني أو بيزنطي. فالمفهوم الذي يكلّمني فعلاً هو المفهوم العربي للمسيح : المسيح العربي، هذا المخلّص الآتي أبداً عبر العصور والحضارات، ذاك السيد الذي معه أتكلّم العربيّة وأتأوه بالعربيّة وأشكيه همّ وطني العربي وأسمعه عربيّاً وأرجو منه الخلاص كعربي. والمسيح الذي يكلّمني هو عربي مثلي بحمله أوزاري، مسيح عاش آلامي ومسيح سوف يحرّرني. فمن هو مسيح العرب؟؟؟
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 13.07.2008
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 5
جورج خضر

تناول المطران جورج خضر مسألة العلمانيّة في أكثر من مناسبة، أذكر منها التفكّر في العلمانيّة كحلّ للقضيّة الفلسطينيّة، اتفاق الطائف الذي ينصّ على إلغاء الطائفيّة السياسيّة، إضافة إلى الجدل المتكرّر حول المفهوم منذ سنين عديدة. يذكّر الأسقف الأرثوذكسي أنّ علاقة الإيمان المسيحي بالسياسة قائمة أساساً على كلمات السيّد المسيح القائل: «مملكتي ليست من هذا العالم». فلا خلط في المسيحيّة بين الدينيّات وفحواها الحياة بالإيمان، والسياسيّات وهي معنيّة بشكل الحكم: السياسة «نطاق له قواعده وتقانته ولغته وأسلوبه وإن ملكوت الله له قواعده ولغته وأسلوبه». لذلك، فليس من موقع لرجال الدين في السلطة السياسية، بل يجب تجنّب الخلط بين هذين الحقلين عبر «تحرير الوطن من وطأة الطوائف وتحرر للإيمان من دخول السياسة إليه». فالتمييز بين الديني والسياسي يلازمه مبدأ قائل بإمكانية عيش المسيحي في ظل أيّ نظام، شرط أن يكون عادلاً وغير قامع للحرّيات. بإمكان المسيحيّة القبول بأنواع شتّى من أشكال الحكم لأنّ الإيمان المسيحي لا يحتوي على مبادئ نظام سياسي.
ولكن يبدو أنّ مسألة التمييز بين الحقلين تواجه مشكلتين كبيرتين في لبنان. أولاهما مشكلة الهويّة: فاللبنانيّون يختبرون ضربين من ضروب الانتماء، الانتماء الديني والانتماء السياسي، وهذا يتعارض مع الهويّة السياسيّة التي لا تحتمل الازدواج، لأنّ هويّة المواطن واحدة وهي الهويّة الوطنية، وهو «عضو في مجتمع وطني واحد ليس مؤلّفاً من أجزاء دينيّة». وثانيتهما مشكلة الطائفية، وهي مرتبطة جذريّاً بمشكلة الهويّة. خضر يدين الطائفيّة بوضوح، إذ يعتبر أنّ «كل الطائفيات جريمة وكل الطائفيات فتن وحروب أهلية». ولكن الطائفية لا تعني حتماً أن النظام الطائفي سيئ بحد ذاته. فالأسقف اللاهوتي يعتقد أن استغلال الطوائف في لبنان أدّى إلى مآزق شتّى. فليس»الانتساب الديني جريمة ولكنه لباس تتخذه الجريمة الكامنة في النفس». أضف إلى ذلك التدخلات الأجنبية التي تستفيد من هشاشة التركيبة اللبنانية الطائفية لخدمة مصالحها. لذلك، لا يكمن حل المشكلة الطائفيّة بالإقصاء المطلق للطوائف من الحكم لأنّ المشكلة مصدرها أساساً تصرّفات السياسيين الذين يستغلّون الطوائف. فإلغاء الطائفيّة السياسيّة لن يحلّ مشكلة أساسها في تصرّفات السياسيين. ولكن، إذا ألغيت الطائفيّة السياسيّة وسنّت القوانين العلمانيّة، يجب على الأقل الحفاظ على المقوّمة الطائفيّة الإيجابية التي تقضي بإعطاء ضمانة للمسيحيين، وحمايتهم من مساوئ الأكثريّة العدديّة.
اللغط حول العلمانيّة. «العلمنة كلمة صعبة القبول في أوساط كثيرة لكونها أفهومة محسوبة مرادفة للإلحاد أو نافية للشرع الإسلامي». وتزيد اللغة العربيّة من غموض المفهوم، إذ تعطي مرادفاً واحداً لمفهومين: laïcité من جهة وsécularisme أو laïcisme من جهة أخرى (هذان التعبيران مرادفان في نصوص خضر). يختلف المفهومان أشد الاختلاف. فالأول هو مرادف للحكم المدني. أمّا الثاني، فهو فلسفة ملحدة تستبعد الله من السياسيّات ومن الحياة الفكريّة. يرفض المتروبوليت الأرثوذكسي المفهوم الثاني ويعارض كل تيّار سياسي يقصي الجانب الروحي ويتصرّف وكأنّ الدين غير موجود.
هذه التحاليل اللغويّة والتقنيّة حول مفهوم العلمانيّة تخوّلنا توضيح موقف جورج خضر منها. فهو يقبل بعلمانيّة تعني «الحكم المدني» ويرفض علمانيّة مرادفة للإلحاد تناهض الدين أو تتجاهله. فالحكم المدني يحافظ على التعدّدية الروحيّة ويضمن دورها فيما الـlaïcisme يقصي تأثير الدين ودوره. يضرب لنا خضر مثل الإمبراطوريّة البيزنطيّة للتكلّم عن الدولة العلمانيّة كحكم مدني. فالإمبراطوريّة لم تكن تيوقراطيّة، بل كان الحكم يساس بتناغم بين الدولة والدين. لم يحكم الإمبراطور الكنيسة، ولم تحكم هذه الإمبراطوريّة. أمّا الكثير من نماذج الحكم السياسي الإسلامي، فهي تنحو منحى مماثلاً: «تعلمت من المؤرخين المسلمين المعاصرين أن الفقهاء كانوا بعامة على مسافة من السياسة وأنهم كانوا وجدان الخلفاء». فحوى القول أنّ العلمانيّة كحكم مدني هي أحد الحلول التي يجب اعتمادها لحل مشكلة الطائفية، للحفاظ على التعدّدية الدينيّة وعلى التناغم السليم بين الدينيّات والسياسيّات. ولكن هذا الحل يبقى حلاً خارجيّاً، ضرورياً ولكنه غير كاف، لأنّ جذور المشكلة قابعة في النفوس: «العلمانيّة حلٌّ إداريٌّ لمشاكل الدولة، وليست حلاًّ فلسفيًّا. تجاهلُ الموجود الفاعل في النفوس لا يُقيم مجتمعًا واحدًا». فعمق المشكلة في الإنسان، وتحديداً في عدم القبول بالآخر: «قبل أن تقتنعوا بالعلمانيّة، اقتنعوا بعضكم ببعض».
استبعاد العلمانيّة كـlaïcisme وتجنيبها كل منحى أيديولوجيّ، يُبقي الدرب سالكاً للروحيّات التي يجب أن تبقى مصدر وحي في الوطن، مع الحفاظ على التمييز الواضح بين الدينيّات والسياسيات. وعليه، يمكن الدولة العلمانيّة (حكم مدني) أن «تستوحي المصادر الدينيّة استيحاءً لقانون وضعي، وقد يأتي القانون الوضعي حراً من أي استيحاء ديني ولكن لا يصدم ضمير الناس وإخلاصهم الروحي». تندرج مسألة الزواج المدني اللبناني في هذا السياق، إذ يعتقد خضر أنّه يجب، من ضمن الحفاظ على قوانين الأحوال الشخصيّة في إطار حكم مدني، إيجاد حل للشخص الذي «لا يريد الخضوع لإيمان جماعته». وبذلك يكون الحكم المدني قد احترم علمانيّة الدولة وأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعيّة الطائفيّة للسياق اللبناني.
ختام القول في هذا المقال أنّه على المسيحي اللبناني الإسهام بمجيء الحكم المدني، الضامن للتعددية، والمميّز بين الدينيّات والسياسيّات، والكفيل بالتوازن الطائفي السليم في لبنان. ويجب على المسيحيين أن يبقوا مصدر وحي للحياة السياسيّة للإسهام بتأطيرها ضمن خير الإنسان الزمني الأسمى: «لا بد من الشهادة لله في أمور دنياك بحيث تلتزم شؤونها فتنغمس في صفحاتها وتناضل وتغيّر فيها ما قدرت على ذلك… أنت تحمل الإنجيل في قلبك وتترجمه في الإنسانيّات، في الهيكليّات».
الحلقة المقبلة: بولس الخوري
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 03.06.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 6
بولس الخوري

يتميّز فكر بولس الخوري (1921-…) باستعراض مباشر وعميق وصريح لمفهوم العلمانيّة بحيّزاته الفلسفيّة والتاريخيّة والسياسيّة. ففيما سعى الكثير من المسيحيين العرب العلمانيين إلى تلطيف منحى العلمانيّة المناهض للدين أو إلى عدم التعمّق به، استرسل بولس الخوري بوصف العلمانيّة كفكر تكوّن أساساً للتخلّص من سطوة الدين ووجوده. ولكنّ الفيلسوف الخوري لم يتوقّف على هذا المستوى التاريخي من الوصف، بل تفكّر في تطوّر المفهوم واعتداله وعلاقته بالثقافة والأنظومة الدينّية والإيمان، مما سنح له التكلّم عن شكل من العلمانيّة يتكامل مع الدين ويسير معه مسيرة تطوّر المجتمع الإنساني.
يذكّر الخوري بأنّ الفكر العلماني نشأ في أوروبا «كثورة على هيمنة الدين وتسلّط رجال الدين واضطهادهم لأصحاب الفكر وإذلالهم للناس باسم الدين». ولعب التقدم العلمي دوراً هاماً في بروز المفهوم الذي مرّ تطوّره بمراحل عدّة: النهضة، الأنسيّة (humanisme)، الإصلاح الديني، عصر التنوير، الثورات السياسية ومنها الفرنسية والبولشفية، والثورات الصناعية والثقافية والعلمية. امتدّت هذه المراحل على أربعة قرون تكوّن فيها الفكر العلماني ومبادئه، وأخطرها بالنسبة للأنظومة الدينيّة التقليدية «أن العقل البشري سيّد نفسه، وأن الخبرة الحسيّة أساس المعرفة». أدّى ذلك الاعتقاد إلى تطبيق مبدأ النسبيّة واعتماد الذهنية الناقدة ورفض الماورائيّات. ولد بين هذا الفكر العلماني والدين حالة توتّر كبيرة. فالعلمانيّة تتعارض مع الفكر الديني الأسطوري والقدسي وتسعى إلى إحلال كل ما هو عقلي ودنيوي ومدني. ولكنّ تطوّر الفكر العلماني أدّى إلى التكلّم أقلّه عن نوعين من العلمانيّة: علمانيّة متطرّفة وعلمانيّة معتدلة.
العلمانيّة المتطرّفة مبنية على نظرة علمية صرف للعالم، وهي لادينية وملحدة، ومن ممثّليها فويرباخ وماركس وفرويد. أمّا العلمانية المعتدلة، فهي تؤمن بالتكامل بين العلم والدين، بحيث إنّ حقل الدين هو المعنى، أما حقل العلم فهو الظاهرات وقوانينها. وفيما تنظر العلمانية المتطرفة إلى العبادات الدينية والقواعد الأخلاقية كأشكال خداع، تعتبرها العلمانية المعتدلة كقدرة على التنشئة الإنسانية الشخصية. وفيما تنقض العلمانية المتطرّفة المجتمع الديني، تعتبر العلمانية المعتدلة المجتمع واحداً تتوافر فيه مقومات تفعيل الإيمان في مؤسسات كالكنيسة. تنقض العلمانية المتطرّفة تدخّل رجال الدين في الشؤون الزمنية، أمّا العلمانية المعتدلة، فتحدّ من هذا التدخل وتدرجه في إطار قوانين مدنية تتيح لأي كان التعبير عن آرائه شرط عدم المس بأمن المجتمع، وهذا بحسب الخوري هو الفصل بين الدين والدولة.
إذا كانت العلمانيّة المتطرّفة لا تتلاقى البتّة مع الأنظومة الدينيّة المسيحية، فاللقاء ممكن بين العلمانيّة المعتدلة وهذه الأنظومة انطلاقاً من مفهوم التجسّد: «فاللّه يصبح معنى للإنسان، والإنسان يصبح الوجود الواقعي للّه». مسألة اللّه لا تعود مسألة وظيفية تعتبر أن الله يدير العالم، ممّا يبرّر الخلط بين الدينيّات والسياسيّات، ولكنها تصبح مسألة كيانيّة بحيث يعطي اللّه للعالم معناه. فالعلمانيّة المعتدلة تؤمن بأنّ الإنسان قادر على أن يدير شؤونه من دون وصاية دينيّة أو إلهية، ولكن هذه العلمانيّة عاجزة عن إعطاء المعنى لأنّ ذلك يتخطّى حقل صلاحيّتها، وهنا دور الدين.
قبلت المسيحية الغربية بهذه العلمانيّة بعد صراع مرير أدّى إلى فصل الدين عن الدولة على أساس التمييز بين الروحي والزمني. وتمّ الإذعان باستقلال الفلسفة والعلوم عن الدين الذي بلغت به الأمور إلى الاستفادة من معطيات الفلسفة والعلم وتطبيقها على العلوم الدينية. صُدّرت العلمانيّة إلى الشرق وانقسمت آراء المسيحيين العرب بين مؤيّد ومعارض. وعلى الرغم من أنّ بعضاً منهم نحا منحى المسيحيّة الغربية بقبولها، صعب على الكثير من المسيحيين المشرقيين تقبّل فكرة العلمانية. الأسباب التي حالت دون ذلك هي أساساً معطيات ثقافيّة كالطائفية والفكر الديني الحاضر في كل شرايين الحياة الاجتماعية والتقاليد والتديّن والتعلّق بالماضي وبحرفيّة النصوص المقدسّة واعتبارها منزلة، إلخ.
يمكن أن يكون للمسيحيّة المشرقية موقف إيجابي من العلمانيّة لأنّ للمسيحيّة قدرات كبيرة للتغيير وللاستفادة من بعض مكتسبات الحداثة كالتعدّدية التي هي قبول للآخر وكالعقليّة الناقضة التي هي نادرة في العالم العربي ومفيدة له، وكالعلمانيّة المعتدلة التي هي فرصة للدين بحيث تدعوه «إلى التحرر وإعادة تفعيل وظيفة الإيمان فيه وفي المجتمع الإنساني». أمّا سبل التلاقي بين العلمانيّة والأنظومة الدينيّة فهي كثيرة، تمرّ بعدّة وسطاء كالرمز والفعالية والمحبّة وقدسية الإنسان. يتشاطر الدين والعلمانية كل ذلك، ولكن لكل منهما تعبيره الخاص الذي يتلاءم مع جوهر بحثه. إلا أنّ التلاقي الفعلي لا يحصل إلا عندما يُميَّز بين الأنظومة الدينية التي هي «تعبير ثقافي عن الإيمان»، والإيمان الذي هو «قصد المطلق وطلب المعنى»، وهذا أمر موجود عند كل إنسان. جرى التعبير عن الإيمان بواسطة أنظومة دينية تتناول إمكانات الثقافة التعبيرية وتتجسّد بها، لكي لا يبقى حيّاً فقط في القلوب. فالإيمان إذاً مقياس الأنظومة الدينية، يحاسبها إن لم تعبّر عنه بالشكل المناسب. وعليه، فللإيمان دور ناقد يقرّبه من العقلانية العلمانيّة التي هي ناقدة بذاتها.
المجتمع العلماني أمر حتمي بالنسبة لبولس الخوري. لذلك فهو يعتبر أنّ علينا، «مسلمين ومسيحيين في هذا الشرق، أن نبتكر معاً مجتمعاً مشرقياً حديثاً علمانياً، قام على ما يجمع ولا يفرّق، عنيت الإنسانيّة». هذا المجتمع العلماني الإنساني بحاجة إلى من يكون ضميره، وهنا يكمن دور الإيمان الذي يضطلع بالدفاع عن القيم الإنسانية والذي يساهم مع العلمانيّة بتأسيس مجتمع إنساني صحيح مبني على الديموقراطية.
ملاحظة: لمزيد من الاطّلاع على فكر بولس الخوري، يمكن مراجعة الكتاب الصادر حديثاً عن منشورات
الجامعة الأنطونيّة: “بولس الخوري، فيلسوف اللاكمال”.
أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 30.06.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 4
مشير عون

مشير عون (1964) هو بلا شكّ من أحدث المنظّرين للعلمانيّة في لبنان. أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة يتناول الإشكاليّة الدينيّة السياسيّة، اللبنانيّة والعربيّة، من منظار الفلسفة واللاهوت وعلم الفسارة. يندرج تفكّره حول العلمانيّة ضمن أنظومة فكريّة كاملة متكاملة، وفي إطار بناء نظري فطن وجريء. فهو يدعو إلى تجديد في البناء الفكري المسيحي اللبناني، عبر قراءة متجدّدة لمسائل حوار الأديان، والخطاب الديني المسيحي العربي، واللاهوت السياسي. يستنبط عون فكره على ضوء عنصر جوهري من مقوّمات الحداثة، أعني التعدّدية. يضيق بي المقام هنا إن وددت التكلّم عن محوريّة هذه الأخيرة بالنسبة لتجديد الخطاب الديني. ولكن فحوى القول أنّ الفكر التعدّدي يحثّ الأديان على تجاوز استئثارها بالحقيقة الإلهية التي لا يمكن أي خطاب إنساني أن يستولي عليها، ويستنهض العقل السياسي اللبناني للبحث عن سبل لعيش التنوّع الطائفي في إطار مختلف عن إطار الطائفيّة الحالية. العلمانيّة التي يقترحها عون هي مقوّمة محوريّة من اللاهوت السياسي المسيحي الذي يصبو إلى أن يكون شريعة المسيحيين العرب السياسية. فجذور الطرح العلماني موجودة في أصول الدعوة المسيحيّة، الكتابيّة واللاهوتيّة والتاريخيّة.
لا يشاطر البروفيسور عون رأي الذين يعتبرون النظام الطائفي ركيزة لتعايش الطوائف في لبنان ولضمان وجودها. فالطائفية هي «مرض مؤذ جدّاً لصدقيّة النموذج اللبناني» بسبب العواقب السلبيّة التي يبرزها الاستغلال الأيديولوجي للدين. ويتجلّى إخفاق الطائفية عبر غياب المواطنة، وفقدان الانتماء الوطني المستعاض بالانتماء الطائفي، وولاءات الطوائف لقوى خارجيّة تضعف الوحدة الوطنيّة، والإساءة إلى حريّة الفكر بحيث تطغى النظرة الأحاديّة للحقيقة، وتواطؤ غير سليم بين الدين والسياسية بحيث «السياسة تستغلّ الدين على قدر ما يستغلّ الدينُ السياسة». رأس الكلام في هذا كلّه أن النظام الطائفي اللبناني غير قابل للتصديق بسبب لاملاءمة بنائه النظري مع واقع تطبيقه العملي، على الرغم من شرعيّة بحثه عن ضمانة للوجود المسيحي الحر والكريم. فالطائفية تؤول بهؤلاء «إلى الانعزال والاختناق». تدفع هذه المعطيات مشير عون إلى اقتراح لاهوت سياسي يعبّر عن نظرة إيمانيّة لالتزام المسيحيين وعملهم السياسيّ.
المسيحيّة دين ودنيا، وهي ليست ديانة الغيبيّات أو الروحيّات فقط. ولكنّها تختلف عن الإسلام بعدم امتلاكها شريعةً سياسيّة إلهيّة، إذ يتمحور عملها السياسي حول قيم إنسانيّة وإنجيليّة، يحاول تطبيقها في واقع الحياة السياسية. وللسياسة موقع جلل في الأنظومة المسيحيّة. فتعاليم السيّد تعتبر الدولة جزءاً من مشيئة الله، وبولس الرسول ينادي باحترام السلطة المدنيّة. كتاب أعمال الرسل يعترف بوجود الدولة ورؤيا يوحنا تشرّع المقاومة الروحيّة للاستبداد السياسي. وأما الكثلكة والأرثوذكسية والبروتستانتيّة، فكان لكل منها، عبر التاريخ، نظرات لاهوتيّة سياسيّة مبنيّة على تأويلاتها الإيمانيّة. فاللاهوت السياسي، حتّى ولو لم يمارس في قرائن المسيحيّة اللبنانيّة، هو بناء شرعي وأصلي على المسيحيّين اللبنانيين اعتماده «كشرط ضروري لإصلاح هيكلي للمجتمع».
على عكس النظرة الإيمانيّة المنزّهة عن التاريخ، يقترح اللاهوت السياسي نظرة سياقيّة للإيمان المسيحي، أي متوافقة مع الشروط التاريخيّة الحاليّة للوجود المسيحي في الشرق العربي. ويقوم هذا اللاهوت السياسي على مبدأ الحريّة الذي يذهب حتّى احترام الخيار الديني الشخصي لكل فرد، على التمييز بين الحقلين الديني والسياسي والفصل بينهما على صعيد الحكم، وعلى اعتماد شرعة حقوق الإنسان والديموقراطيّة «كأفضل أطر قانونيّة وتنظيميّة ممكنة حاليّاً لتدبير المجتمع الإنساني». تندرج هذه المبادئ ضمن الرسالة الإنجيلية الداعية إلى تحرير الإنسان من كل وصاية، أدينيّة كانت أم زمنيّة، وتوجيهه إلى سبل الإيمان الحق. ما يجعل من المسيحية دين نضال اجتماعي وسياسي. فكل ما يغرّب الإنسان عن ذاته معاكس لمشيئة الله. ولا يستقيم هذا النضال إلا إذا كان انفتاح، وحوار وتعدّدية. وأسس هذه المبادئ موجودة في اللاهوت الثالوثي عبر مفهوم الانفتاح المطلق الموجود أصلاً في ذات الله، وفي اللاهوت المسيحياني الذي يقترح الحبّ وبذل الذات بديلاً للعنف وللكراهية. كل هذه المبادئ تتعارض مع واقع الطائفية، وتدفع اللاهوت السياسي بالمناداة بعلمانيّة معتدلة، أمينة للشهادة المسيحيّة الأصيلة وضامنة للوجود المسيحي الحر في لبنان.
العلمانيّة المعتدلة ذات الحياد المطلق هي شرط أساسي لنهضة المسيحيّة اللبنانيّة والشرق العربي، وضمانة للتعددية الطائفيّة. هذا الاقتراح ضمانة للتركيبة الاجتماعيّة الطائفية وللمواطنة في آن واحد. وهو يحرّر المسيحيين من سلبيّات الطائفية. فالفكر المسيحي يزدهر من ضمن الأنظومة العلمانيّة، وهو يستكره الانغلاق الطائفي. جذور العلمانيّة المعتدلة التي تتمايز عن العلمانيّة الأيديولوجيّة الملحدة وتناهضها، موجودة في جوهر الإيمان المسيحي الذي هو محبّة وانفتاح واحترام مطلق للآخر. «فالإنجيل علماني من صلب دعوته. والمسيحيّة تستكره الخلط بين حكم الله وحكم قيصر»، بل تدفع بالمؤمنين إلى الالتزام السياسي عبر تجسيد القيم الإيمانيّة في معترك النضال الإنساني السياسي والاجتماعي. وعليه، فالعلمانيّة المعتدلة تحاور الأديان وتتبنّى قيمها، كقيم إنسانيّة، على شرط ألا تتعارض هذه القيم مع مبدأ المواطنة وشرعة حقوق الإنسان. وبذلك، تزول عن التعاليم الدينيّة صفة الإطلاق والاصطفاف الطائفي، وتصبح سبيلاً للتقدّم الروحي والفكري المتجسّد والملتزم. بتمييزها بين الدينيّات والسياسيّات وبفصلها للسلطتين، تبحث العلمانيّة المعتدلة عن أشكال النظام السياسي التي تؤمّن للطوائف عيشها الكريم، وتضمن خصوصيّتها الحضاريّة، وتقيم حواراً دائماً حول القيم التي عليها استنباط معاني الوجود الإنساني في لبنان، على ضوء التراثات الدينيّة التي تكوّنه. هذه العلمانيّة معتدلة بسبب انفتاحها وتفاعلها الفذ مع الواقع الديني الطائفي الذي تنظر إليه إيجاباً.
قابليّات الائتلاف بين هذه العلمانيّة والإيمان المسيحي واضحة بالنسبة لمشير عون. فالتمييز الإنجيلي بين السلطتين، والوثوق بقدرة الإنسان على إدارة شؤونه الدنيويّة، وحريّة اختيار السبل الدينيّة هي قناعات مشتركة بين المسيحيّة والعلمانيّة. وعلى الرغم من وجود اختلاف على بعض المبادئ الأخلاقية، يبقى البحث عن حلول ممكناً عبر الحوار. أمّا في ما يتعلّق بالتكافل، فالعلمانيّة المعتدلة تكفل للمسيحيّة اللبنانيّة حضورها، وإيمانها، ومبادئها وتطورّها التاريخي السياقي. فهل تكون المسيحيّة في لبنان كفيلة لنظام علماني إنسانوي يضمن لكل المواطنين حقوقهم السياسيّة، والمواطنيّة، والروحيّة والأخلاقيّة، ويعزز التعدّدية الدينيّة والحوار بين الأديان؟ لربّما حافظ اللبنانيّون المسيحيّون على وجودهم عبر النظام الطائفي. ولكنّهم بذلك يساهمون بالتخلّف السياسي والاجتماعي في العالم العربي، ويؤطّرون شهادتهم الإيمانيّة في أجداث الانغلاق الطائفي.
العلمانيّة المعتدلة تلخص جزءاً أساسياً من نضال المسيحيين اللبنانيين السياسي المقبل. فهي مشروع نهضوي، إنسانوي، تأويلي وإصلاحي يصيب الحياة الإنسانيّة في كل أبعادها ويستنهض قدراتها على التجدّد. علّ هذا النضال يصبح نضال المجتمع اللبناني بكل روافده، المسيحيّة والإسلاميّة والعلمانيّة، وأن يجعل من قضيّة الإنسان القضيّة الأولى التي يبنى على أساسها الوطن.
الحلقة المقبلة: جورج خضر
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 11.05.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 3
ميشال الحايك
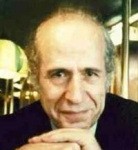
العلمانيّة نزعة في الفكر العربي الديني المسيحي في لبنان، ولو أنّها عند بعض اللاهوتيين قضيّة محورية. فكر الأب ميشال الحايك (1928ــــ2005) يميل ميلاً خفراً إلى وجه من وجوه العلمانيّة دون تسميتها، عبر تكلّمه عن وطن لاديني، ومن خلال لاهوته الإنسانوي التعدّدي الذي يناهض الطائفية ويشجبها. صداقة هذا العلّامة الحميمة بكمال جنبلاط ودفاعه عن القضيّة الفلسطينية، إضافة إلى مشاريعه الكنسيّة النهضويّة، آلت في السبعينيات إلى اعتبار فكره يساريّاً رغم عدم التزامه بأي من التيارات أو الأحزاب السياسيّة.
يتمحور قسم كبير من كتابات ميشال الحايك حول مسائل جوهريّة تتناول الأديان الإبراهيميّة الثلاثة. فسياق التعايش الإسلامي المسيحي في لبنان حثّ المفكّر الماروني على النظر إلى الإسلام نظرة متجدّدة تختلف عن المفاهيم الموروثة التي تطرد الديانة العربية من تاريخ الخلاص وتدرجها في منازل الضلال. فالإسلام بنظر حايك هو من ذريّة إسماعيل، وهو بذلك وارث شرعي للإيمان الإبراهيمي وأمين أشدّ الأمانة للتوحيد الإلهي. ولكن الإسلام ما زال بالنسبة لحايك كإسماعيل في صحراء نفي، ما عبرها بعد إلى أرض الميعاد المسيحانية. وعليه، فإنّ هذه القراءة للإسلام تبرّر لاهوتيّاً إدراجه في سر التدبير الإلهي، وتلقي جانباً كل خطاب إقصائي، لا بل تستثير حوار الإخوة. أمّا مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، وفي جوهرها القضيّة الفلسطينيّة، فهي بالنسبة لحايك صراع يدوم منذ تباعُدِ ابنَيْ إبراهيم. جوهر حل القضية الفلسطينيّة هو في مصالحة إسحاق وإسماعيل، وفي الدور الذي على الفرع الإبراهيمي المسيحي أن يلعبه في سبيل هذه المصالحة.
يدين الأب العلامة، وهو مؤمن بتعدّدية الإنسان وبحرّيته، كل أحاديّة فكرية، أكانت دينيّة أم سياسيّة أم حضاريّة، وهي في كل الأحوال قاتلة لذات الإنسان. يتعارض هذا المنطق والمشروع الصهيوني المبشّر بأحاديّة العرق والدين، النابذ للغيريّات باسم عقيدة دينيّة سياسيّة فوقيّة، ممّا يدفع حايك إلى التمسّك بالمشروع اللبناني، رغم كل نكساته، لأنّ هذا المشروع أعطى لتاريخ العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة نموذجاً فريداً من اللقاء الأخوي. فمثال تعايش أبناء إبراهيم في لبنان هو حلّ ممكن للقضيّة الفلسطينيّة ولتصالح أبناء إبراهيم على أرض فلسطين: «بصفتي لبنانيًّا أتبرّم بكلّ وطن متقوقع في الفرديّات، ولا أقدر أن أتصوّر من بعد وطنًا يُعاش فيه من دون أن يكون شموليًّا تترابط فيه الأعراق والأديان والحضارات بميثاق إنسانيّ وممارسة حريّة تسقط دونها دساتير التيوقراطيّات والقوميّات والعنصريّات، مهما كان نوعها ولونها» (لبنان وفلسطين، «النهار»، 6 أيّار 1975). ربع قرن بعد كتابة هذه السطور، كتب حايك مجدّداً عن أهميّة التعدّدية الإنسانيّة، وأدرجها في إطار الشهادة: «نحن هنا لنبقى شهادةً للشرق، شهادةً على التعدّد الإنسانيّ، ودعوةً مستمرّةً إلى الحرّيّة، واختبارًا للّقاء الروحيّ، وإرادةً للتجدّد والإبداع. لا امتياز لنا إلا بما نتميّز به من مبرّرات في تجميل الأرض والفكر والروح» (كالمسيح كنّا رهائن للأمم حتّى الأقربين، «النهار»، 22 نيسان 2000).
يزيّن لي أنّ تكلُّم حايك عن نبذ التيوقراطيّات وإصراره على اللقاء الإنساني يندرجان في إطار نظرة تميل إلى وجه من العلمانيّة. فالحكم باسم الله يولّد غالباً منطقاً يتعارض مع التعدّدية الإنسانيّة الحرّة. يؤيّد تفكّري هذا مقطع فريد كتبه المفكّر الماورني سنة 1970، تكلّم به عن نظرته إلى لبنان كوطن تحييه روح الإيمان بمعزل عن الدين: «أمّا نحن في لبنان، وقد عظمت علينا المسؤوليّات، فقد حتّم علينا التكفير عمّا يظهر في العالم وفي شرقنا من عصبيّة وإلحاد. وتكفيرنا يحتّم علينا أن ننقل الجهاد إلى ساحة الحقّ، إلى الظفر بالإنسان وبالله، أي أن ننشئ في هذه الديار وطنًا للتسامح الإنسانيّ والإيمان الإلهيّ، وطنًا لادينيًّا بل إيمانيًّا تترسّخ أساساتُه لا على التعصّب الطائفيّ، الذي هو أخسّ مظاهر التديّن، بل على الثقة بأنّ الحقّ هو الظفر، لأنّ الحقّ يكفيه أن يكون ليظفر، حتّى ولو انقلبت المفاهيم إلى حين» (رسالة إلى بني جيلنا، 1970، ص 79ــــ80). ميشال الحايك هو في هذا الموضع كغيره من اللاهوتيين العرب التقدميّين، لا يتناول إشكاليّة علاقة الديني بالزمني إلا من خلال إيلاء مسألة الروح مكانة مميّزة ومحوريّة في الحياة الوطنيّة. وهو لا يني يميّز بين مسألة الإيمان من جهة، وأنواع التديّن التي تستثير ضروباً شتّى من العصبيّات الدينّية والطائفية من جهة أخرى. إن كان الإيمان يستنهض طاقات الإنسان ويخوّله المضي في سبيل أصالته الوجوديّة، فللدين جوانب عدّة تستثير أفول الإنسانيّة وتغرّبها.
ما كتبه حايك في 1970 عن التعصّب الطائفيّ تحقّق مع الحرب اللبنانيّة حين تقاتل أبناء الوطن الواحد وتنافروا على أسس أغلبها طائفي، ممّا دفع اللاهوتي إلى اعتبار الطائفيّة أول العيوب اللبنانيّة الثلاثة: «طائفيّة ولاعقلانيّة وفوضويّة: هذه هي عيوبنا الثلاثة» («النهار»، 4 أيلول 1975). مشكلة الطائفيّة الأساسيّة هي في السوء الذي تجلبه على الإنسان. إن كانت إشكاليّة وجود الكيان اللبناني تُبرّر بالنسبة للكثيرين انطلاقاً من أهميّة هذه الأرض لعيش الطوائف ولإيلائها حقوقها، فبلاد الأرز هي بالنسبة لحايك أرض الحرية التي يجب أن يولد عليها الإنسان الجديد بمعزل عن كل ما يغرّبه عن ذاته. وهنا تظهر إنسانويّة فكر الكاهن الماروني: «الإنسان قبل الأوطان. إذا سلم سلمت، وإذا خارت روحه انهارت أرضه. من تحرير الروح تبدأ عملية تحرير الأرض. فعلينا اليوم، كما على الجميع، وكلنا نازحون مشرّدون عن لبنان الروحي، أن نتجنّس روحيًّا فيه لنستحق استيطانه من جديد» (محاضرة في سيّدة إيليج). ولنقلها مرّة أخرى، التمييز بين عالم الروح والإيمان من جهة، وعالم الدين من جهة أخرى، محوري في فكر حايك الذي يميّز في نصّ آخر بينهما ويربطهما بشكل من التفريق بين الديني والزمني: «كلّ دين يخشى حرّيّة الفرد باطلٌ كذبت فيه الرسلُ وخُدِع به الناس. وعلى كلّ حال، فالناس اليوم، في كلّ أرض، تفلّتوا من الأغلال، فهُم يطلبون الحقّ لا عن طريق التراث وتقاليد الجدود، بل عن طريق الاقتناع الشخصيّ المسؤول. فإذا هم بعدما فرّقوا بين الدين والدولة فأبوا أن يربطوا غاية الدين بمآرب الدنيا، إذا بهم يفرّقون بين الدين والإيمان…» (رسالة إلى بني جيلنا، 1970، ص 75).
لا شكّ بأن فكر حايك يندرج في إطار النزعة العلمانيّة في الفكر المسيحي، وهو يتناول خفراً مسألة علاقة الدينيّات بالزمنيّات عبر الهمّ الإنسانوي والإيماني. رسالته تحثّنا على البحث، في غمر تفكّرنا في العلمانيّة، عن أصالة الإنسان الذي هو بالنسبة للإيمان محور مشروع الله وبالنسبة للزمان محور الحياة السياسيّة. دعوة الأب ميشال الحايك دعوة نبويّة تذكّرنا بأنّ هويّتنا ما زالت تحدّد الآن «بكلّ شيء غريب عنها، بكلّ انتساب وكلّ انتماء، إلا بالإنسان». (أرض الميعاد، 1970، ص 66).
الحلقة المقبلة: مشير عون
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 14.04.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 2
غريغوار حدّاد

يُعدّ غريغوار حدّاد (1924ـ)، الذي عُرف بالمطران الأحمر، من روّاد الفكر العلماني في لبنان. تتمحور تطلّعاته حول تفكّرات إنسانويّة لا تتناول اللاهوت والكنيسة والسياسة والحياة الوطنيّة إلّا من خلال مطلقين لا ثالث لهما، هما الله والإنسان. فكر حدّاد يندرج في إطار نضالي يروم تحرير الله من مفاهيم خاطئة حول كيانه، وتحرير الإنسان من تغرّبات شتّى تمسّ وجوده، وأهمّها الطائفيّة. يجب فهم تنديد حدّاد بهذه الأخيرة واقتراحه إقامة نظام سياسي علماني انطلاقاً من هذه الأسس الفكريّة الإنسانويّة المسيحيّة. يرفض غريغوار حدّاد استيراد علمانيّة غريبة عن السياق اللبناني العربي. فالعلمانيّة التي ينادي بها مرتبطة جذريّاً بسياقه، وهي ترى أنّ الدين (مع تمييزه عن الطائفة والطائفية) كعامل إيجابي يمكن الاستناد إلى الكثير من مقوماته لبناء مجتمع إنساني صالح.
يعتقد حدّاد أنّ العلمانيّة مرفوضة في لبنان بسبب سوء فهمها. فتعدّد الأنظمة العلمانيّة ومنها الملحدة، وعدم التعريف عن العلمانيّة بطريقة واضحة ونهائية عبر مفهوم محدّد يؤدّيان إلى نبذها. ولكنّ الأسقف يظن أن معرفة حقيقيّة للعلمانيّة لا يمكنها أن تؤول إلى الرفض، بسبب ما تحويه هذه الأخيرة من قيم أساسية تعني أصالة الإنسان وعيشه الكريم. لذلك يجتهد حدّاد بإزالة كل سوء فهم حول الأمر عبر عرض للمفاهيم التي لا يجوز الخلط بينها وبين العلمانيّة. فالعلمانيّة ليست العلميّة، أي تفسير العالم انطلاقاً من العلم؛ وهي مختلفة عن أنظمة سياسيّة أخرى على رغم تقاربها أحياناً، كالديموقراطيّة أو المواطنة؛ هي ليست ملحدة، مناهضة للدين أو رافضة لقيمه؛ هي ليست بمسيحيّة أو إسلاميّة، بشرقية أو غربيّة؛ وهي لا تبغي إقامة طائفة إضافيّة بل علمنة النظام اللبناني برمّته. ويزيد المطران الأحمر على ذلك أنّ الاستغلال الجزئي للعلمانيّة يسهم في تشويه المفهوم. فالبعض يريدها فقد لتشريع الزواج المدني أو لمآرب توظيفيّة في الدولة، والبعض الآخر يستثمرها في إطار ايديولوجي سياسيّ يخص مصالحه. مشكلة كل هذه الاستثمارات الجزئيّة تكمن في أنّها لا تهتم بعلمانيّة شاملة هدفها المصلحة العامّة وكل أجزاء المجتمع.
ينادي حدّاد بعلمانيّة شاملة، «تؤكّد استقلاليّة العالم بكل مقوّماته وأبعاده وقيمه تجاه الدين ومقوّماته وأبعاده وقيمه. أي مثلا: «استقلاليّة الدولة، والمجتمع، ومؤسساتهما وقوانينهما، وقضاياهما، وسلطتيهما عن المؤسّسات والقوانين والسلطات الدينيّة». هذا التحديد الذي يفترض قيمة ذاتيّة للعالم ليس بحسب الأسقف أفضل تحديد، ولكنّه صالح للاستعمال وقابل للتطوير، لأنّ العلمانيّة ليست فكراً متحجّراً أو عقيدة دينيّة أزليّة، بل «تفاعل جدلي بين الكيان والفكر والعمل». على العلمانيّة أن تتطوّر أبداً مع تطور الإنسان وتقدّمه. لذلك، فتفاعل الفكر العلماني مع الإنسان اللبناني وتاريخه يؤول إلى اقتراح علمانيّة ذات حياد إيجابي تجاه الأديان، أي علمانيّة تحترم هذه الأخيرة وتتفاعل معها إلى حد تبنّي البعض من قيمها، من دون اعتبارها إلهيّة أو موحى بها، بل وضعيّة وصالحة للإنسان وقابلة للنقد. يريد حدّاد بذلك المحافظة على غنى الإرث الديني والاستفادة منه عبر إدراجه في إطار لا طائفي. يعتقد حدّاد أنّ على تطبيق هذه العلمانيّة الشاملة أن يكون تدريجياً عبر عدّة مراحل، بدءاً بإلغاء الطائفيّة السياسيّة ومروراً بإزالة الطابع الطائفي عن المجتمع، إلى علمنة الإدارات والنقابات والأحزاب والقوانين (بالأخص الأحوال الشخصيّة). فلا يجوز للحياة السياسيّة أن تتمحور حول الطوائف وحقوقها، بل حول المواطن وحياته الكريمة. العلمانيّة تعطي هذا الأخير حريّة اتّباع درب ديني أو لا دينيّ، تحرّر الفرد من الانتماء الطائفي الموروث وتعزّز انتماءه الوطني. أمّا المؤسّسات التعليميّة أو الاجتماعيّة التي هي بمعظمها بين أيدي الطوائف، فيجب على الدولة أن ترعاها مع المحافظة على التعليم الديني واعتباره تعليماً خاصاً غير إلزامي. ويبلغ تطبيق العلمانيّة ذروته عندما تُعدّ العلمانيّة قيمة إنسانيّة مستقلّة عن المنابع الدينيّة مع الحفاظ على التفاعل البنّاء. أمّا محتوى هذه القيمة الإنسانية، فهو «الحرية والعدالة، والمساواة، والتضامن، والسلام، والديموقراطيّة، والفضائل الأخلاقيّة، كالصدق، والإخلاص، والخدمة، والتضحية والفداء».
يؤول تحقيق العلمانيّة الشاملة إلى تحرير لبنان من مآزق عديدة مصدرها الطائفية عبر «إحلال الانتماء الوطني بدلاً من الانتماء الطائفي» وبناء دولة لا يكون أساسَها اتحادٌ فدرالي لمجموعات طائفيّة بل سيادة كاملة أساسها المواطنون. يحل ذلك مشكلة البحث عن هويّات إسلاميّة أو مسيحيّة للبنان، بحيث تصبح هويّة موطن الأرز علمانيّة وإنسانيّة ملتزمة بكل قضايا الإنسان العربي (وأهمّها القضيّة الفلسطينيّة) بغض النظر عن انتمائه الطائفي. وهكذا لا ترتهن الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لتوازن الطوائف، ولا يجري إنماء المناطق على أساس هوياتها الدينيّة ولكن بحسب الحاجة الإنسانيّة. ويجب على ذلك أن يجعل محاكمة السياسيّين الفاسدين ممكنة، إذ يوضع جانباً التخوّف من ردّات فعل الطوائف. أمّا على صعيد الدين، فالعلمانيّة تساعد على التفريق بين الإيمان من جهة، والمرتكزات الاجتماعيّة الطائفية من جهة أخرى. فالدين ليس الطائفة، والإيمان يختلف عن الانتماء الطائفي. تطبيق النظام العلماني يتيح للمؤمنين «أن يقوموا بالنقد الديني الجذري ضمن إطار ديانتهم، بدون التخوّف من مضاعفات جانبيّة قد تكون عنيفة جدّاً». ويمكن أن يساعد هذا النقد على العودة إلى جذور الإيمان، وإلى التحرّر من المنظومات الطائفيّة. تسهم العلمانيّة أيضاً في تحرير مفهوم الله والأديان من التشويهات الناتجة من خلط الديني بالسياسي وتحرير المسيحيين والمسلمين «السوسيولوجيين» من خوف الزوال لأنّ الدولة تصبح كفيلة بحياة كل مواطنيها. وأخيراً تؤكّد العلمانيّة أنّ «كل إنسان هو القيمة المطلقة بالنسبة إلى الدولة ومؤسساتها وإلى الدين ومؤسساته… وهو الغاية الأخيرة لجميع المؤسسات الدينيّة والمدنيّة، والمقياس المطلق لأجل إحداث التغييرات فيها أو إبقاء ما يجب إبقاؤه من بنياتها وقوانينها». لعلّ العلمانيّة أن تكون مصدر قيم، وأخلاق وحوارات، وأن تعطي المواطن ثقة بالنفس، بعيداً عن كل تعصّب وفي إطار تحقيق ذاتِ كل فرد كما يحلو له.
يعي غريغوار حدّاد صعوبة تحقيق مشروع كهذا لكنّه يؤمن بإمكان إنجازه. فعل إيمانه مبني على قابليّة الإنسان للتطوّر، وعلى قراءة تاريخيّة تظهر تحوّل الكثير من المجتمعات من دينيّة إلى علمانيّة. مشروع كهذا لا يتحقق بين ليلة وضحاها، ولكنّه مسيرة طويلة تبدأ بإنجاز علمانيّات جزئيّة مرماها تحقيق العلمانيّة الشاملة.
أظنّ أن طرحاً كهذا يضع نصب أعيننا تحدّيين، على العلمانيّة اللبنانيّة أن تواجههما: مسألة حقوق الإنسان ومسألة مكانة الدين في المجتمع السياسي. يريد حدّاد أن يضع جانباً تفكّراً يروم الحفاظ على حقوق الطوائف على حساب حقوق الإنسان. فلا تعود علاقة الفرد مع الدولة علاقة منتمٍ إلى طائفة لها حقوق محدّدة، ولكن علاقة مواطن منتمٍ إلى دولته، له حقوق متساوية مع باقي مواطنيه، بغض النظر عن أي انتماء طائفي. أمّا مكانة الدين، فعلى العلمانيّة اللبنانيّة أن تكون نموذجاً لإمكان توافق الدين والعلمانيّة. فقوانين الدولة المدنيّة عليها أن توفّر للمؤمن الإطار السليم والحقوق التي تخوّله عيش إيمانه ودينه والحفاظ على إرثه الروحي. العلمانيّة التي يقترحها حدّاد هي علمانيّة تسهم في البحث عن أصالة إيمانيّة أكبر، لا يكون فيها الدين مسألة وراثيّة أو اجتماعيّة أو طائفيّة، بل خياراُ شخصياً حراً. العلمانيّة الشاملة تعارض خلط السلطة الدينيّة بالسلطة السياسيّة، ولكنّها تجعل من الوطن مساحة يمكن كل الأديان أن تزدهر بها روحيّاً، ثقافيّاً واجتماعيّاً.
الحلقة المقبلة: ميشال الحايك
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 19.03.2010
النزعة العلمانية في الفكر المسيحي في لبنان 1
يواكيم مبارك

كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن الطائفية في لبنان، في ظلّ وابل من المشاريع السياسيّة المبشّرة بإلغائها أو تكريسها، بتعديلها أو إعادة صياغتها. جعجعة ومزايدات تثني المواطن اللبناني، وهو المعني الأوّل بالعلمانيّة وضحيّة سلبيّات النظام الطائفي، عن الفهم الرصين والتفكّر العقلاني بهذه المسألة. تروم سلسلة المقالات هذه توضيح مفهوم العلمانيّة اللبنانيّة المبتغاة عبر التطرّق إلى أبحاث مفكّرين دينيّين مسيحيّين، أي لاهوتيّين، تناولوا هذا المفهوم وتكلّموا عن ضرورة تطبيقه بحثاً عن أصالة أكبر للإنسان عبر حياته السياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة.
الأب يواكيم مبارك (1924ــــ1995)، وهو من أكبر المفكّرين الموارنة في القرن العشرين، تطرّق إلى العلمانيّة انطلاقاً من لاهوت التعدّدية الدينيّة الذي نحته ومن ضرورة إيجاد سبل للعيش المشترك السليم بين الأديان في الشرق الأوسط، وقد أدّى الفكر الطائفي إلى تصادمات وحروب آلت إلى دمار وأصوليّات وآلام وتغرّبات شتّى. يعتبر مبارك أنّ المسيحيّة والإسلام ديانتان إبراهيميّتان وفيّتان للتوحيد الإلهي الذي كشفه الله لإبراهيم. ويرفض اللاهوتي اعتبار إحداهما ناقصة في إيمانها التوحيدي، أو مبدعة في كلامها عن الله. إذ اشتف مبارك من السيّد المسيح تخلّق الحب والاحترام المطلق للآخر، وقام بأبحاث جمّة لإظهار أوجه التلاقي العميقة بين المسيحيّة والإسلام. لاهوت المساواة هذا، كما يدعوه مشير عون، يتعارض جذرياً مع مبدأ «المدينة المقدّسة»، تلك التي تسنّ قوانينها انطلاقاً من التشريعات الدينيّة، أقديمة كانت أم حديثة، أمحكومة كانت من ملك أو من قيصر، من خليفة أو من سلطان، أكان اسمها جمهوريّة إسلاميّة، دولة يهوديّة أو منطقة مسيحيّة. المدينة المقدسة تتعارض والتعددية الفكرية والدينيّة، إذ تسوسها نظرة أحاديّة لحقيقة الوجود والإنسان، ورفض للتمايز الإيماني والنظري. العلمانيّة نقيض لهذا المفهوم وأساس سياسي لبناء مدينة إنسانيّة يتلاقى فيها البشر على فراداتهم الدينية، وضمن أطر وجوديّة تعددية.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أظهر بالنسبة لمبارك عواقب الفكر الديني الأحادي ولزوم إقامة نظام علماني يعيش الكل في ظلّه إيمانه وفرادته الحضاريّة. اللاهوتي الماروني، وهو من المدافعين الأكثر ضراوة عن القضيّة الفلسطينيّة في الغرب، يبرّر وجوب إقامة نظام علماني محلّي شرقي، لا على ضوء المشكلة الطائفيّة اللبنانيّة وحسب، بل انطلاقاً من الصراع العربي الإسرائيلي الذي عليه أن يدفع المسلمين والمسيحيين واليهود في الشرق إلى اعتماد العلمانيّة نظاماً بديلاً للحروب المقدسّة. إذ كان يعتقد مبارك في الستينيات والسبعينيات أن حل القضيّة الفلسطينيّة يكون بإقامة دولة فلسطينيّة علمانيّة، عربيّة ــــ يهوديّة. آلت لسوء الحظ التطرّفات الدينيّة إلى عدم إمكانيّة تحقيق مشروع كهذا، وإلى إقامة المدن المقدّسة التي كان يخشاها مبارك، تلك التي تقتل التعدديّة وتسيء بذلك أشدّ الإساءة إلى الإنسان. ولكنّه يزيّن لي أنّ الوضع الحالي المزري للقضيّة الفلسطينيّة لا يسقط تفكّر مبارك، لا بل يؤيّده ويثبت مخاطر الخلط بين الدين والدنيا من ضمن أنظومة أحادية المرمى ورافضة للغيرية. أكثر من أي وقت مضى، يجب على مأزق الوضع الفلسطيني الراهن أن يدفع الأديان التوحيدية إلى البحث الجدي والحصيف عن سبل العلمانيّة الإيجابيّة، البنّاءة والإنسانويّة كما يعتقدها مبارك.
لا يعتقد اللاهوتي الماروني، وهو عاشق روحي للإسلام وعالم كبير في الإسلاميّات، أنّ الإسلام والعلمانيّة يتنافيان. فقراءته للديانة المكيّة تختلف اختلافاً جذريّاً عن القراءات المسيحية الرفضيّة وعن المفاهيم الإسلاميّة الأصوليّة والمتطرّفة. يرى مبارك في الإسلام دعوة للسلام وديناً للمنبوذين من تاريخ الخلاص، الأمينين للتوحيد الإبراهيمي، هؤلاء الذين لم ولن يتخلّى الله عنهم كما لم يتخلَّ عن إسماعيل في صحراء نبذه. لهذه الديانة الأصيلة إمكانيّات تجدّد وتحديث هائلة رغم التوتّر الكامن بها، وهي غير محكومة بالجمود، لا بل مخوّلة وقابلة كالمسيحيّة لمواكبة تطوّر المجتمعات التعدّدية ولتعزيز نظام سياسي للأمم يكون فيه العامل الديني حافزاً للمساواة بين البشر وللحريّة.
أمّا المسيحيّون العرب، فعليهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في سبيل العلمانيّة المشرقيّة، بدءاً من تغيير فهمهم لمعنى وجودهم في الشرق العربي. فيجب على نضالهم ألا ينحسر على همّ بقائهم الحر فحسب، بل عليه أن يضحي نضالاً من أجل كل إنسان بصرف النظر عن انتمائه الديني أو الطائفي. يجب على المسيحيين الإسهام في علمنة قضيّة الإنسان عبر تسليط الضوء على القيم الإنسانويّة الموجودة في الديانات التوحيديّة لدرء التجربة الأصوليّة من البلوغ إلى النفوس. فللمسيحيّة المشرقيّة حظوظ أوفر للاستمرار والشهادة، إن أضحى نضالها لا ضد المسلمين، ولكن في سبيل كل إنسان ولكل الإنسان، عبر قواعد وقيم مشتركة لكل الفئات الدينيّة التي تكوّن شرقنا النازف.
العلمانيّة ليست مفهوماً عرضياً أو ظرفياً، بل هي أحد العناصر اللاهوتيّة المحوريّة في فكر يواكيم مبارك. هي ليست مجرّد خيار سياسي، بل مقوّمة أساسيّة للشهادة المسيحيّة، لالتزام المسيحيين بمحيطهم ولتجسيد سياسي مناسب للفكر المسيحي التعدّدي المنفتح أشدّ الانفتاح على مثال حب المسيح غير المشروط. العلمانية اللبنانيّة، كما يفهمها مبارك، لا ترفض الدين بتاتاً ولا تتجاهله، فهي تستفيد من كل نزعة إنسانويّة موجودة في الإرث الروحي التوحيدي وتضمّها إلى تفكّراتها. إنّها علمانيّة إيجابيّة إزاء الأديان، تحترمها وتقتبس منها تطبيقها العملي ضمن إطار فصل واضح بين الديني والزمني. جليّة إرادة اللاهوتي فهم العلمانيّة بصورة محليّة تختلف عن مفاهيم غربيّة مناهضة للدين. فالعلمانيّة الملحدة غير واردة، والعلمانيّة المفروضة مرفوضة أيضاً. أمّا العلمانيّة المبتغاة، فهي تعطي لكل مواطن لبناني وعربي الحق المطلق بحريّة المعتقد الديني، وتمنح الدولة استقلاليّة مشروعة عن السلطة الدينيّة. علّ القيم الإنسانويّة المسيحيّة والإسلاميّة تتجسّد في المدينة الزمنيّة، وتجعل منها مدينة مُرَوْحَنة. تساعدنا هذه التفكرات على فهم حلم يواكيم مبارك بجعل لبنان وطن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
الحلقة المقبلة: غريغوار حدّاد
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة الأخبار 17.02.2010
يبحثون عن الأصوات وأنا أبحث عن الإنسان
تستوقفني الشعارات الانتخابية الرنّانة يوما بعد يوم. فتلك التي تحذرني من الخطر الامبريالي الامريكي الصهيوني وتينك التي تضع نصب عيني مخططات محور الشر الايراني السوري. وما اكثر البازارات الاعلامية المسوقة للانتماءات الوطنية، من عربية الى غربية، من حجازية الى اعجمية، من فرعونية الى شامية، من قدسية الى بيروتية…
أما لغة التخاطب السياسي الدنيئة فحدث ولا حرج، فبضع ساعات من تصاريح مسؤولينا كفيلة بإفساد سنين من التربية المدنية والأخلاقية. هذا يبشرني بمشروع ثورة الأرز السرمدية وذاك يبغي اقلاق وجودي بمشروعه الوطني الداحر للتدخلات الغربية السافرة. مللت وكليت من لغات التخاطب الخشبية الفارغة، تلك التي تروم احقاق الطائفة وتجنب تهميشها، تلك التي تؤثر ابعاد اشخاص غير أكفياء والخروج عن الطاعة الدينية، تلك التي تؤلّه الرئيس والقائد والسيد والعماد والوجيه والأستاذ والمعلّم وصاحب المعالي، وصاحب السعادة…
سئمت الخطابات المجوفة، تلك التي تدّعي رسم مستقبلي ومستقبل اولادي، خطابات ملؤها التعصّب والتحزب ونبذ الاخر والتجريح بالغير والجهل والتقوقع والانغلاق، خطابات خلت من أي مشروع سياسي بالمعنى النبيل للكلمة، اي مشروع محوره بناء انسان اصيل وانسانية جديدة تستند الى مبادئ موجودة في شرعة حقوق الانسان وفي تعاليم دياناتنا التوحيدية السامية. انني ارى في بلاد الأرز رهوطا من المشاريع ووابل من الانتماات ولست ادري في العمق ما يميزها، اذ غاب عنها كلها مشروع الانسان، ضحيّة الوطن الأولى والشهيد الدائم لمصالح قوم ما عرفوا من الانسانية الحقة الا ومضها. مصيبتنا الاساسية في لبنان ليست في كل المشاكل المعروضة من قبل الافرقاء السياسيين، مصيتنا الأولى على ما قاله الشاعر أنّ حسّ السؤال عن الإنسان عندنا قد غاب.
فمن هو انساننا وما هويته وكيف تحدّد؟ اهو انسان الانتماء الطائفي ؟ أم هو انسان المناطق والطبقات الاجتماعية ؟ اهو انسان الاحزاب وقد اعمت بصيرته عقائد كره الاختلاف ام هو انسان الاقطاعيات السياسية ؟ اهو المجاهر بلبنانيته او عربيّته أم المجاهر بجذوره الفينيقية او المتوسطيّة ؟ اهو رجل سوريا او مصر، السعودية او ايران، الغرب او العدو ؟ كثرة التحديدات وكثرة الانتماءات وكلها تبعد الانسان عن اصالته المبتغات وتغرّبه عن ذات لم يبلغها بعد، عن كينونة هي مصدر كل انتماء وكل وجود وكل ولوج الى الحياة.
مشكلتنا ان كل الطرق المحيطة بنا تبحث عن صورة معيّنة لانسانها وهي تحاول ان تجعله دينيّا او علمانيا، لبنانيا او عربيا، غربيا او محازبا، مناصرا او مؤيدا. والمبتغى الحق يقتدي بجعل المتديّن انسانا واللبناني انسانا والمحازب انسانا والمناصر انسانا. المفقود هو الانسان والمرام هو الانسان والبحث هو عن الانسان. فكل الانتماات وكل العصبيات السياسية والدينية والوطنية باطلة ان بقي انساننا ضائع. فما نفع تحرير الارض ان لم يحرر الانسان من نبذه لقريبه الانسان ؟ وما نفع انتصار الطائفة ان لم ينتصر الانسان على تقوقعه ؟ وما نفع الاغلبيات النيابية ان بقي الانسان اقلية فاقدة الصوت والهويّة ؟
في قلبي حسرة تتوق الى الانسانية الحقّة، تلك التي هي على صورة الله، الرحمن والرحيم والحب المتجلّي الذي اعطى ذاته بكليّتها ليرينا طريق الحريّة الحقيقية التي مصدرها حب القريب وقبول الاختلاف وصون التنوّع. يا ليتنا نرمم الانسان قبل ان نرمم الاوطان، يا ليتنا نصون الحب قبل ان نقتل ما نعتبره شر ويا ليتنا نسير مسرى تحريرنا من ذاتنا قبل ان نبحث عن تحريرنا من الاحتلالات الخارجية.
رحم الله الاب والمعلم الكبير ميشال الحايك الذي قال أن الوطن لا قيمة له إذا لم يكن إطارًا لتنمية الإنسان، وأنّ الانسان قبل الأوطان، وأنّه إن سلم سلمت، وإن خارت روحه انهارت أرضه. من تحرير الروح تبدأ عملية تحرير الأرض. فعلينا اليوم، كما على الجميع، وكلنا نازحون مشرّدون عن لبنان الروحي، أن نتجنّس روحيًّا فيه لنستحق استيطانه من جديد. فمتى يولد الانسان عندنا في لبنان ؟
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 31.05.2009
أؤمن…
“أؤمن” كلمة تلفظ مرارا وتكرارا على لسان المسيحيين العرب وفي أكثر من سياق وإطار. وإن كانت هذه الكلمة تستعمل لإعطاء المسيحي تسمية هي من أجمل التسميات، أعني “مؤمن” بالله (أي من أمّن ذاته إلى الخالق) وبمسيحه، فإنّها ترد مرارا عندما يقول المرء : أؤمن بالكتاب المقدّس، أؤمن بالأسرار، أؤمن بتقليد الكنيسة، أؤمن بتعليم الكنيسة، أؤمن بالسلطات الكنسية (الأساقفة والكهنة والقسس)، أؤمن بالعذراء، أؤمن بالقدّيسين، أؤمن بوجود الشيطان، أؤمن بوطني، أؤمن بقائدي، أؤمن بعقيدة حزبي، أؤمن بتاريخ طائفتي، أؤمن بوجهاء منطقتي، أؤمن بدولتي، أؤمن بالعدالة الدولية… أمن الصواب استعمال هذه الكلمة على هذا النحو ؟
يظهر الإيمان في صلب الدعوة المسيحية، فهو شرط وأساس ولوج الإنسان إلى حقيقة وجوده كمبرّر ومحرّر ومخلوق محبوب حتّى الموت، موت الصليب. بداية الإيمان المسيحي ليست في الإنسان، فهو يعجز بقدراته الذاتيّة عن معرفة الله الذي يتخطّى واقع المرء الوضعي، بل هي في الله الذي يدعو المرء الى حياة جديدة محورها الحب والأصالة. هذه الدعوة بيّنها الله بيسوع الناصري، كلمته في التاريخ ومسيحه. عندما يدعو الله الإنسان الى حياة منه وبه واليه، يضعه أمام خيارين : قرار رفض أو قبول هذه الدعوة. وعلى أساس أحد القرارين، يُبنى ايمان المرء أو عدمه. هذا القرار وجودي، فاختيار الله بالمسيح يحتّم على المؤمن التصرّف والتكلّم والعمل والتفكير والوجود بحسب شريعة الحب اللامحدود الذي أبانه الناصري في حياته وتعليمه واخلاء ذاته وبذلها. إنطلاقا من هذه المبادئ الأساسية يمكننا القول أنّ الإيمان المسيحي هو دعوة إلهيّة جلّ محتواها تحقيق الذات الإنسانيّة. لربمّا قال البعض بأهميّة تأليه الإنسان، ولكنني أعتقد أنّ أسمى ميّزات الإيمان المسيحي هي في أنسنتها للإنسان، فإحدى أرقى المفاهيم للتجسّد يقضي بفهمه كرسالة إنسانوية راديكاليّة، أي كأبهى التجلّيات للوجود الإنساني.
لعمري أنّ الإيمان بمفهومه السامي الآنف الذكر يتخطّى الكثير من الأطر الضّيقة التي يحاول الكثير زجّه بها. فالإيمان بالله يتخطّى الدين الذي هو، كما قال فينيلون Fénélon الأسقف والمتصوّف الكبير، إختراع إنساني. هذا الإختراع هو ضروري ربّما إلى حين بلوغ الإنسان سنّ الرشد كما يقول اللاهوتي الألماني بونهوفر Bonhoeffer عندما يتكلم عن المسيحيّة اللادينيّة أي الراشدة. والإيمان يتخطّى الكنائس التي هي في الأساس جماعات ولدت من نور القيامة وتلاقت وتنظّمت للإحتفال بالمنتصر على الموت. الكنائس محوريّة للمؤمنين ولكنّها مكوّنة من بشر ومرتبطة جذريّا بالتاريخ والجغرافيا والسياق والحضارة. تخطئ مرارا ولكنّ الروح يبقى فاعلا بها كما يفعل خارجها، إذ لا حدود لعمل الله. فالإنجيل يخبر عن الروح الذي يهبّ حيث يشاء، وعن الله الذي يعمل في كل الشعوب، وعن الناس الذين كانوا يصنعون العجائب باسم المسيح، دون أن يكونوا من تلاميذه. والإيمان يتخطّى حتما الإطار الطائفي الضيّق والمقية. لا ريب أنّ التنظيم الطائفي كان له بعض الحسنات الديموغرافيّة والتنظيميّة في العهد العثماني، ولكنّه أضحى في عصرنا هذا جرثومة فتّاكة تتعارض وتعاليم السيّد، لما يولده من نبذ للآخر وتقوقع على الذات الطائفيّة وسوء لمفهوم المواطنيّة وتحريف لشموليّة الدعوة المسيحية التي تضحي حصريّة ومرتهنة لمصالح الطائفة، نابذة لكلّ ذاتية أخرى تتعارض مع خصوصيّتها.
الكتاب المقدّس هو في أساس حياة المؤمن وهو المصدر الأوّل والأهم الذي يخبرنا عن قصّة حبّ الله لمخلوقاته وتدخّله الخلاصي في تاريخ البشر. ولكنّه يبقى وسيلة للإيمان وليس غاية، يخبرنا عن الإيمان بالله ويحثّنا في الوقت ذاته على عدم اقتصار إيماننا بحبر وورق، بل جعله روح ولحم وحياة. وكذلك الأسرار، وكم يتصارع المسيحيين حولها أحيانا، راذلين بعضهم بعضا على حسب إذعانهم بصوابيّة التفكّر الأسراري أو بعدم صوابيّته. ولكأنّ الطابع القانوني والطقوسي للأسرار هو في صلب حياة المؤمن وليس من تنقله لنا الأسرار أي المسيح. لا يمكن لشكل الأسرار الخارجي أن يكون موضع إيمان، بل المسيح القائم الذي تعطينا إيّاه، ذاك الذي هو حاضر أيضا في سر هذا العالم والذي يعطي المؤمنين باسمه أن يعبدوا الله بالروح والحق. أنا لا أؤمن بالعذراء ولكن بابنها يسوع الذي يريني وجه الآب وسبيل الإنسانيّة الحقّة. ولكنّني أعشق وجه مريم وإيمان مريم وحضور مريم في كل مرّة تكون لي مثال إيمان بالله. وكذلك القدّيسين وكذلك رجال الكنيسة : لا أؤمن بهم البتّة، ولكننّي أستوحي من حياتهم وتعليمهم ومثلهم في كل مرّة يشهدون للحب بالجمال والحق. تعاليم الكنائس وما أكثرها، هي محاولات تعبير سياقيّة عن الإيمان المسيحي. أنا لا أؤمن بها، بل بالذي تكلّمني عنه، وأنا أتّبعها بقدر ما تكون وفيّة لإنجيل يسوع المسيح وبقدر ما تلاقي الإنسان في مسيرته لتحقيق ذاته.
أمّا المسؤولين الروحيّين، فهم ككلّ عضو في جسد المسيح مؤمنين بالله يعبّرون عن إيمانهم بحسب فرادة رسالتهم، ولكل إنسان رسالة فريدة. وجودهم ورسالتهم مهمّان جدّا وضروريّان، ولكنّه من المنافي للعقل الإيمان بهم لا بل يجب محاورتهم أو حتّى معارضتهم إن اعتقدوا أنهّم وسطاء بين الله والناس –والمسيح هو الوسيط الوحيد– أو موزعين الخلاص والحياة الأبدية التي يعطيها الله فقط. وأمّا التقاليد الكنسية، فأنا لا أؤمن بها، بل بالذي توصله إلي. وأنا أتّبعها بقدر ما تكون تعاليمها إجابات لإشكاليّاتي الإيمانيّة الحالية. وأمّا الشيطان، فمن السخيف القول بالإيمان بوجوده، إذ أنّ الإذعان بهذا الوجود يبقى رهن الكثير من معتقدات القرون الوسطى والتراثات الشعبيّة.
القول بإيمان سياسي بالوطن أو بالقائد أو بالوجيه أو بالرئيس أو بالتاريخ هو فارغ تمام الفراغ. لا يمكن أن نؤمن بالأرض والوطن، مهما عزّا علينا، كما نؤمن بالله، ولكن الإيمان الحق بالله يحث الإنسان على حبّ أخيه الإنسان وعلى البحث معه عن إطار سليم لعيشهم المشترك. ليس للتاريخ إدراك أو ضمير لكي يكون موضع إيمان الإنسان، فهو واقع وجودي يصنعه المرء. والقول بإيمان بالأحزاب وبقادتها، بالدول وبرؤسائها ضرب من ضروب الجنون. فما من إنسان يستحق أن نؤمن به ونسلّمه حياتنا والكتاب قال : “ملعون من يتّكل على ذراع بشر”. لربّما أثق بشخص على قدر ما يجسّد توجهاتي السياسيّة، ولربّما انتميت إلى حزب عبّر أو يعبّر عن طموحاتي الوطنيّة، ولربّما ساهمت بانتخاب من هم في السلطة لأنّ برنامجهم أقنعني في حين من الأحيان. لكنّ حياتي أغلى عطايا الخالق، لا أبذلها إلّا في سبيل حبّه المتجلّي في حب القريب. لذلك لا يمكنني الإيمان بالأحزاب والسياسة والأوطان التي، عندما تبتعد عن خير الإنسان –وهذا الأمر شائع جدّا– وتعلّم الحصريّة، وأحاديّة الفكر والتفرقة والكراهية والعنصريّة والطائفيّة، تجعلني معارضا لها، باسم إيماني بإله الحبّ وباسم التزامي بقيمة الإنسان الذاتيّة كقضيّة حياة.
أردت القول أنّ الإيمان قرار وجودي بالغ الأهميّة وعظيم المسؤوليّة، مصدره الله وغايته طوبى الإنسان الحقّة. الإيمان ينقل الجبال وينتصر على الموت. به تحقيق للذات الإنسانيّة التي تدرك أصالتها من خلال تسليم حياتها للحب المطلق والتصرّف مع القريب والمساهمة في بناء الأوطان والمجتمعات على أساسه. لا أحد يستطيع أن يصنع من العدم حياة، ومن الموت قيامة، ومن القبح جمال إلّا الخالق. لذلك، فهو وحده يستحقّ الإيمان، وحده يستحقّ تسليم الذات إليه. والباقي كلّه ثانوي وعرضي، مهمّ فقط وبشكل نسبي جدّا، على قدر ما يؤول إلى إنسانويّة حقّة وإلى بحث أصيل وسليم عن الله. والسلام.
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار 10.05.2009
اللاهوت السياقي العربي
سبق وتكلّمت مرارا عن اللاهوت العربي الحديث وعن بعض مقوّماته. يروم هذا المقال الى توضيح معنى هذا المفهوم عبر ادراجه في اطار منطق لاهوتي سياقي (Contextual Theology) يقترح رؤية جديدة للعمل اللاهوتي ومفهوما جديدا يختلفان عمّا يمككنا معرفته من خلال المنظومات اللاهوتية التقليدية. هذا التفكر ليس بترف فكري، وقد اصاب العمارة اللاهوتية العربية الترهل والتفسّخ والتراخي كما يقول مشير عون. النهضة اللاهوتية واجبة ان اراد المسيحيون البقاء الحر والفاعل وان اردنا، نحن المسيحيون العرب، المساهة الفعّالة بانهاض شرقنا النازف.
أسس العمل الاهوتي التقليديّة تتكلّم إجمالاً عن مصدر أو مصدرين لكل بناء لاهوتي. فاللاهوتيّات التقليديّة الكاثولكية أو الأرثوذكسيّة تتكلّم عن مصدرين هما الكتاب المقّدّس والتقليد. أمّا لاهوت الإصلاح فهو يعتبر الكتاب المقدّس كمصدر وحيد. لاهوت السياق هو لاهوت حديث يعتبر أنّه لا يمكن بعد الآن الإعتماد في العمل الاهوتي على المصدران الآنف ذكرهما فقط. فعلى السياق أن يكون مصدر أساسي لللاهوت بجانب الكتاب المقدّس والتقليد. وما السياق إلّا الإطار الذي يُحاول في خضمّه فهم كلمة الله وفهم العالم على ضوئها، العيش والتصرّف والتفكير على أساسها والشهادة لها. ما هذا السياق الّا الإطار التاريخي والجغرافي والوجودي المعاش، بكل نواحيه الإجتماعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة والثقافيّة… تعدّدت آراء اللاهوتيين السياقيّين حول تراتبيّة المصادر اللاهوتيّة الثلاثة: فالبعض من قال بأولوية السياق والبعض الآخر من قال بأولويّة الكتاب المقدّس. ولكن الثابت هو طريقة العمل اللاهوتي الجديدة والتعددية التي تعتبر السياق كمصدر أساسي للعمل اللاهوتي. التيّارات اللاهوتية السياقيّة المعاصرة كثيرة، سأستعرض منها نموذجان لمزيد من الفهم والوضوح.
لاهوت التحرير في أميركا اللاتينيّة ولد بحسب تعبير مؤتمر مدلّين عام 1968 في سياق “بؤس عام ]أضنك جملة الشعوب في أميركا اللاتينيّة[، يعبّر عنه كظلم صارخ نحو السماوات”. فضرّاء هذه الشعوب وفقرها واللاعدالة الإجتماعيّة أدّت إلى إعادة تفكير الإيمان المسيحي والكتاب المقدّس والتعاليم الكنسيّة بشكل مختلف عمّا قبل، لا يدنو من اللاهوت إلّا من خلال السياق الإجتماعي والسياسي والإقتصادي. فبدل فهم الواقع على ضوء الكتاب المقدّس والتقليد، فُهم الكتاب المقدّس والتقليد انطلاقاً من الواقع وبعيداً عن الغيبيّات اللاهوتية التقليدية والروحيّة المنزّهة عن واقع التاريخ المباشر. أدّى ذلك إلى بلورت منهجية لاهوتية جديدة، عبّر عنها غوستافو غوتييريز، ليوناردو بوف، جون سوبرينو وغيرهم…
اللاهوت الأسود (Black Theology) ولد في سياق صراع سود الولايات المتحدة من أجل تحريرهم من التمييز العنصري. جذور هذا اللاهوت التاريخيّة تمتدّ إلى تجارة الرق في القرن السادس عشر، ويشتفّ تفكّره ماهيّته من عمل وفكر شخصين محوريّين له هما مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس. جايمس كون هو المنظّر الأساسي لهذا اللاهوت الذي يفهم الإيمان المسيحي على ضوء معانات أحفاد العبيد الذين لم يتحرروا بعد من استعباد البيض لهم. فعلى ضوء السياق المعاش، يؤمن اللاهوت الأسود بالمسيح كمسيح أسود أي مسيح يضطهد كأي أسود مستعبد، والله كإله ذات بشرة سوداء أي إله موجود في خندق السود الذين يعانون من التمييز العنصري واللاعدالة الإجتماعيّة… إله معهم في معركة تحريريهم من العبودية. الله ليس محايداً، ومن الخطأ القول أنّه مع المضطهِد والمضطهَد. فهو حتماً مع المظلوم وضدّ المستبد. واقع الجور هو منطلق أي فهم لحقيقة الله والكتاب المقدّس ورسالة الكنيسة. لهذا اللاهوت امتدادات في عدّة أقطار كأفريقيا الجنوبيّة.
أهدف من خلال هذان المثلان المقتضبان إعطاء فكرة وجيزة عن منطق اللاهوت السياقي عامة وعن الفرق بينه وبين اللاهوتيّات التقليدية التي نادراً ما تعتبر السياق مصدراً في بنائها. فهي غالبا ما تنطلق من التقليد الكنسي أو من قراءتها التقليديّة والموروثة للكتاب المقدّس، وتتكلّم على هذا الأساس مع السياق من دون أن تكون كلمتها إجابة على هواجس مؤمني السياق وإشكاليّتهم. وتجدر الإشارة أيضا إلى اختلاف المنهج. فمنهج اللاهوت السياقي يختلف عن منهج اللاهوتيات التقليدية في علاقته مع العلوم الأخرى. العلم الذي تحاور معه اللاهوت تقليديّا هو الفلسفة. أمّا اللاهوت السياقي، فهو يحاور العلوم الإنسانيّة كعلم الإجتماع، علم النفس أو علم الإقتصاد… ولا يتردد في استعمال منهج هذا العلم أو ذاك من أجل الإتيان بالتفكّر الملائم للواقع. هكذا استعمل لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية منهجيّة التحليل الماركسي للمجتمع من دون أن يتبنّى الحلول أو الأيديولوجيا الماركسية. وأمّا تعدّديّة لاهوت السياق، فهي تحتّم تعددية في المناهج. فليس هناك طريقة واحدة لصنع اللاهوت السياقي بل هناك لاهوتيات سياقيّة. المنهج اللاهوتي السياقي الأنسب هو المنهج الأكثر ملاءمة في منطقه مع السياق ومتطلّباته. الثابت في اللاهوت السياقي هو حداثة منهجيّته التي تتمايز عن المنهجيّات التقليدية، وعلاقته بالسياق كمصدر أساسي للعمل اللاهوتي. أمّا نماذج اللاهوت السياقي، فهي متنوّهة مع تنوّع السياق وتبدّله.
اللاهوت السياقي يفرض تحوّلا جذريّا في التفكّر اللاهوتي، يقيم مسافة نقديّة بينه وبين اللاهوت التقليدي، ينكبّ محلّلا السياق بكل أبعاده ويتجنّب الغيبيّات وكل منطق يبعده عن العالم. حتى ولو كان البعد الأخروي (الإسكاتولوجي) يجعل آفاق المؤمن تتخطّى هذا العالم نحو موطنه الحقيقي حيث ملك الله الأزلي، فإنّ المؤمن يبقى من هذا العالم، ويبقى هذا العالم مسؤوليّته. ومن هذا المنطلق، على علم اللاهوت، بما أنّه محوري لحياة الكنيسة، اعتبار العالم كأحد المنطلقات الأساسية لعمله. تتنافى هذه المنهجيّة اللاهوتيّة الجديدة مع لاهوتيّات تقليديّة شائعة في الشرق، عميقة في فكرها الروحي والصوفي والتقوي، ثابتة في طلبها الطاعة للرؤساء الروحيين، ومتنزّهة عن أمور الدنيا وكأنّ حياة المدينة ليست من مسؤوليّة المؤمن، ولكأن الخطيئة أفسدت كل الخليقة وانتصرت على النعمة الأولى وعلى بذور الكلمة الكامنة في الوجود، كل الوجود.
إن لم يكن اللاهوت العربي الحديث متجدّدا وسياقيّا، فما هو إلّا تكرار ببغائي لما هو قديم وغير ملائم لوجوديّة الإنسان التاريخيّة، التي تجعل من الكائن البشري مخلوقاً أبدا جديدا ومتجدّداً. ولكن التجدّد، على رغم كل المسافات النقديّة التي يضع بينه وبين القديم، لا يتضاضد مع ما سبقه من تفكّر لاهوتي. فلولا القديم لما كان الجديد. ولكن التجديد يفرض نوعا من التخلّي الإيجابي عن القديم أي الإتيان بمنهجيّة عمل جديدة وبنظرة للأمور جديدة لا تخلو من الإستيحاء من الماضي والتعلّم منه أحياناً.
ماهيّة تجديد واصلاح اللاهوت العربي تكمن في فهمه كلاهوت سياقي. فمن دون الإنفتاح على السياق الحالي المعاش ومن دون اعتباره مصدراً أوّليّا لعلم اللاهوت، يبقى اللاهوت العربي لاهوتا غيبيّا غير ملائم لإشكاليّات الوجود المسيحي الحر والفاعل في الشرق، وشاهداً على اضمحلال الشهادة المسيحيّة الإيمانيّة والحضاريّة، وهو مسؤول جزئيّا عن هذا الإضمحلال بعدم تجديد بنيته. لربّما كنت أول من يتكلّم بهذا الوضوح عن اللاهوت العربي الحديث كلاهوت سياقي يندرج ضمن إطار تيّارات لاهوتية سياقيّة. ولكن العمل اللاهوتي العربي السياقي، وإن لم يكنّ بهذه الكنية، له سوابق عند الكثير من اللاهوتيين العرب وله في الوقت الحاضر بعض المفكّرين الجديرين بالثقة. أذكر على سبيل المثال جان كوربون ومحاولته السياقيّة الجريئة : “كنيسة العرب”. وميشال الحايك الذي أعطى من خلال فكره العربي السياقي تبريرا لاهوتيا مسيحيا لوجود الإسلام – شريكنا الأساسي في السياق، وعدم اعتباره كخطئ تاريخي أو كدين الخطأ. أنعم الروح على الكنائس العربيّة ببعض المفكرين المستنيرين، يمكن اعتبار أفكارهم كمنطلقات وثوابت لللاهوت العربي الحديث، أذكر منهم على سبيل المثال ولا الحصر يواكيم مبارك، جورج خضر، غريغوار حدّاد، بولس الخوري، عادل تيودور الخوري، جيروم شاهين… ومشير عون الذي يجسّد بكتاباته المعاصرة التوجّه اللاهوتي العربي السياقي، دارجاً إيًاه في منطق تعددي، مسكوني، فلسفي، حواري وسياسي.
هذه السطور اللاهوتية العربية ما هي الا صرخة امل اضعها بتصرّف القيّمين على العمل اللاهوتي في لبنان وفي الشرق، علّنا ننهض اللاهوت العربي، لاهوت كل الكنائس العربية الغنية جدّا بتراثاتها، من سباتها العميق والعقيم. علنا نساهم كلّنا، بتنوّعنا وبفراداتنا، بنهضة لاهوتيّة عربيّة تحي الانسان وتمجّد الله.
بقلم الدكتور أنطوان فليفل
جريدة النهار15.02.2009
|
|